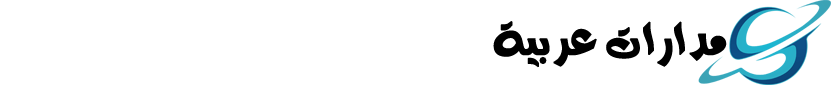آفاق مسرحية الإنتخابات الأمريكية / الطاهر المعز

الطاهر المعز ( تونس ) – الخميس 7/11/2024 م …
مقدّمة
تتميز الانتخابات الأمريكية بالإخراج المسرحي الضّخم – على غرار إنتاج هوليود – وبعدة تجاوزات من بينها الإدعاءات الكاذبة والتّشهيرية، والتلاعب بالرأي، وعرقلة مُشاركة بعض فئات المجتمع في الإنتخابات ( الشباب والسُّود والمساجين السابقين والأمريكيين من أُصُول أجنبية…)، وتتميز أيضا بفساد المرشحين من خلال العلاقات المشبوهة مع المؤسسات الإقتصادية والمالية ومع مجموعات الضّغط (لوبيات)، ومن خلال أموال التّبَرُّعات غير الخاضعة للرقابة، بالإضافة إلى الثّغَرَات القانونية العديدة والمُتَعَمّدَة، ومن بينها ما يَتَعَلَّقُ بالضّوابط القانونية للمساهمات المالية في الحملات الانتخابية، إذْ يُشكّل تمويل الحملات الانتخابية، المحلية أو الوطنية، إحدى النقاط الضبابية العديدة أو التي تمت صياغتها قَصْدًا بشكل غامض، ويتم تنظيم تمويل الحملات الانتخابية على المستوى الاتحادي أو المحلي من خلال آليات تفترض الشفافية فيما يتعلق بمبالغ ومصادر التمويل، ولكن هناك اختلافات من ولاية إلى أخرى حول ما إذا كان ينبغي نشر هذه المعلومات أم لا، ولا ينطبق أي من هذه التدابير على بعض النفقات المخصصة للتواصل والإعلام وللفِرَق التي تُشرف على تنظيم الحملات، وعلى شراء مساحات إعلانية في الإذاعة والتلفزيون، وإعداد إعلانات إشْهارية تدعم المرشحين أو تشوه سُمْعَة منافسيهم، وقد تكون هذه النفقات باهظة وغير متناسبة مع النفقات الأخرى، لكن وجب اللُّجُوء إلى القضاء، بما في ذلك المحكمة العليا للإعتراض أو التّشكيك في صحّة الأرقام والنِّسَب، وتعتبر المَحاكم هذه الإعلانات الإشهارية أشكالاً من حرية التعبير للمُرَشّحين الذين يتحملون مثل هذه النفقات.
لدى جميع الولايات تقريباً، باستثناء أربعة، آليات تحد من التبرعات الشخصية، ونَشَر المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية في الولايات دراسة عن مُتوسّط الإنفاق على الانتخابات المحلية سنة 2012، فكان الحد الأقصى 7500 دولار لمرشح حاكم الولاية، و3300 دولار لمرشح مجلس نواب الولاية، و3700 دولار لمرشح مجلس شيوخ الولاية، أما بالنسبة للانتخابات الوطنية فتم تحديد حد التبرعات الشخصية الفيدرالية سنة 2013 بمبلغ 123000 دولار، لكن المحكمة العليا اعتبرت، سنة 2014، باسم حرية التعبير، أن هذا التقييد مخالف للدستور، كما أبطلت المحكمة العليا سنة 2010 الحَظْر المفروض على تمويل الشركات أو الكيانات المالية أو الاقتصادية أو الدينية التي تدافع عن مصالحها.
أدّت هذه القرارات القضائية – وخاصة قرارات المحكمة العُليا – إلى ارتفاع هائل في نفقات الحملات الإنتخابية بشكل يجعل التّرشّح وإمكانية الفَوز بأي مَقعدٍ مَحَلِّي أو على مستوى الولايات أو اتحادي، محصورًا في فئة قليلة قادرة على جمع المال من الشركات والأثرياء، وهذا أحد الأسباب التي جعلت الإنتخابات محصورة بيْن مُرشَّحَيْن يُمثّل كلٌّ منهما مصالح شرائح من الرّأسمالية ( التي تُمَوِّل الحملة الإنتخابية) وبذلك يتم إقصاء أي مُرشّح مُحتَمل قَدْ يُمثّل مصالح الكادحين والفُقراء الذين يُشكّلون الأغلبية المُطْلَقَة للمواطنين…
نظام الانتخابات الرئاسية
يتنافس حزبان رئيسيّان ( الدّيمقراطي والجمهوري) للفوْز بالبلديات أو الحكومات المحلية ومنصب الوالي، والمقاعد النيابية ( مجلس النواب ومجلس الشيوخ = المؤتمر أو الكونغرس) ولا ينتخب المواطنون الرئيس الإتحادي مباشرةً بل يختارون ممثليهم في الهيئات الإتحادية الذين يختارون بدورهم الرئيس، وعادة ما يعلن هؤلاء “الناخبون الكبار” اختيارهم مسبقًا…
قبل حوالي سنة من تاريخ الإنتخابات الرئاسية، يختار الحزبان الرئيسيان، ضمن انتخابات داخلية (تمهيدية) على مستوى جميع الولايات الأمريكية الخمسين، مُرشَّحًا عن كل حزب، ويُشكّل هذه النّظام الإنتخابي – الذي يتطلب جهازًا انتخابيا فعّالاً وأموالاً طائلة – عقبةً أمام الأحزاب الصّغيرة والمُرشّحين المُسْتقلِّين أو المرشحين الذين يُعارضون قيادات أحزابهم (مثل برني ساندرز، داخل الحزب الدّيمقراطي)، ولا يوجد قانون أو نظام مُوَحّد لهذه الإنتخابات التّمهيدية التي تختلف مجْرَياتها من ولاية إلى أخرى: اختيار المرشحين بواسطة الإقتراع السري أو الإجتماعات المفتوحة والتجمعات الحزبية، ويقتصر بعضها على الأعضاء المسجلين في الحزب في بعض الولايات، بينما يحق لغيْر المُتحزّبين التصويت في ولايات أخرى، ثم يختار مندوبو المؤتمر الإتحادي لكل حزب المُرشّح الرئاسي، ولكل ولاية عدد من “كبار الناخبين” ( من إجمالي) 538 نائبًا ) يتناسب مع نسبة الكثافة السّكّانية، وتدعم هذه الآلية حصة الولايات الصغيرة وقليلة الكثافة السّكّانية، من كبار الناخبين، ويجب أن يحصل الرئيس على نسبة 50% + 1 أي 270 من “كبار الناخبين” الذين لا يُلْزِمهم الدّستور الأمريكي بالتّصويت لصالح المرشّح الذي اختاره حزبهم…
يمكن تلخيص المسألة بإيجاز بأن النّظام الإنتخابي الأمريكي لا يعتمد على التّصْويت المُباشر وإنما على ما يُسمّى “المُجَمّع الإنتخابي”، وهو نظام “الدّيمقراطية بالوكالة” الذي يُمَكّن بعض المُرَشَّحِين من الفَوْز رغم عدم حصولهم على أصوات الأغلبية الشعبية.
البرامج الإقتصادية للمُتنافِسَيْن:
ساعدت مناظرة العاشر من أيلول/سبتمبر 2024 في توضيح برامج دونالد ترامب و كامالا هاريس، إلى حد ما، ولئن كانت الأهداف والأولويات متقاربة نسبياً، في الأمور الاقتصادية ـ وخاصة فيما يتصل بالقوة الشرائية والإسكان ـ فإن الوسائل المُتَوَخَّاة مُختلفة.
رَكّزَت البرامج الاقتصادية للمُرَشَّحين الجمهوريين والدّيمقراطيين – والتي تكملها وعود الحملات الإنتخابية المختلفة – بشكل أساسي على القوة الشرائية التي أهملتها إدارة جوزيف بايدن، مما سَمِح لدونالد ترامب بالإستفادة من استياء المواطنين من غلاء الأسعار، للهجوم على الرئيس وعلى نائبته كامالا هاريس، ولوْمِهِما على ارتفاع نسبة التّضخّم الذي رَفَع الأسعار بمعدل 20% خلال السنوات الأربع الماضية، وارتفاع تكلفة الإئتمان العقاري، مما يُعَسِّرُ الحصول على قرض لشراء مَسْكن، فضلا عن انخفاض عرْض المساكن المُعَدّة للبيع وارتفاع أسعارها، وأَدّى النّمو البطيئ والإرتفاع في معدّلات البطالة الرّسمية – ولو كان ارتفاعًا صغيرًا – وسوء ظروف العمل ( بعقود هَشّة ودوام جُزْئي) إلى زيادة استياء المواطنين الفُقراء ومتوسطي الدّخل، وعمومًا اتّسمت البرامج الإقتصادية للمُرشّحَيْن بالضّبابية والإبتعاد عن الدّقّة، خصوصًا في مصادر التّمويل للتّدابير المُقْتَرَحَة، وفي طريقة تنفيذ اقتراح كل منهما مثل “خفض أسعار المنتجات الاستهلاكية لتحسين ظروف حياة الأسر الأمريكية ” في وُعُود كامالا هاريس التي اقتصرت مُقترحاتها على فَرْض حظر على الأسعار التي لا تتماشى مع تكاليف إنتاج بعض السلع الضرورية كالغذاء مثلاً، وهو ما لا يمكن لأي حكومة أمريكية أن تنفذه لأنه مُنافٍ لقانون السّوق، ولذلك يعتبر دونالد ترامب هذا المقترح “شيوعيًّا” ويقترح إلغاء جميع اللوائح في كافة المجالات وترك الرأسماليين يتصرفون بدون قُيُود أو ضوابط قانونية، وتشجيع صناعة النفط والغاز على زيادة الإنتاج بهدف تخفيض الأسعار، متجاهلا السّوق العالمية التي تحدد سعر المحروقات والمواد الأولية، ولو افترضنا جدلاً تطبيق مقترحات كامالا هاريس و دونالد ترمب، فإنها لا تُؤدِّي إلى خفض الأسعار فعلياً أو تحسين ظروف عَيْش الكادحين والفقراء…
تخلو برامج المُتنافسين من مقترحات جِدِّيّة بشأن السّكن، باستثناء الحوافز الضريبية للمقاوِلين وتيسير استحواذهم على الأراضي العمومية الصّالحة للبناء، وكذلك بشأن الرعاية الصحية، باستثناء ضخّ المزيد من المال العام لفائدة شركات (مُقاولات) الرعاية والتأمين الصحي، حيث تلخّصت المُقترحات والبرامج في التفاوض مع شركات صناعة الأدوية لخفض أسعار الأدوية الأكثر استخدامًا، وعدم إلزامها بتوخّي شفافية الأسعار لأن منطق النظام الرأسمالي يناقض أي شكل من أشكل الرقابة على رأس المال، رغم المصاعب المالية – خصوصًا للمُصابين بأمراض مزمنة – وارتفاع ديون المواطنين بفعل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والدّواء…
تتفق البرامج الإقتصادية للمُرشّحين على استمرار التخفيضات الضريبية والإعفاءات التي أثبتت التجارب إنها لا تفيد إلا الأثرياء، فيما تدعم المساعدات الحكومية للفُقراء ( في مجالات كالغذاء والصّحّة ) الإستهلاك – بتصريف فائض الإنتاج – ولا تستهدف القضاء على الفَقْر، وعمومًا يحاول كل مُرَشَّح إرْضاء داعميه، ويتلخص برنامج كامالا هاريس في دعم الفِئات الوسطى من خلال المساعدات المباشرة وغير المباشرة وبعض قطاعات الرأسمالية، في حين يدعم دونالد ترامب كبار الرأسماليين وأصحاب الشركات من خلال تخفيض الإنفاق الحكومي، وتخفيض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية وزيادة الرسوم الجمركية على السلع والخدمات المُسْتوْرَدَة ( وما الصين سوى واجهة لهذه السياسات الحِمائية)، مما قد ينعكس على الأسعار التي يُسدّدها المواطنون الأمريكيون…
المال قوام الأعمال
تعتمد الحملات الانتخابية على تمويل الشركات والأفراد ومجموعات الضغط وأصحاب المصالح، مما يُؤَدِّي إلى مُراعاة مصالح المُتبرّعين – وهم في الواقع مُستثمرون – وإهمال مصالح المواطنين من الكادحين والفُقراء، وبذلك يكون للمال دور هام في الإنتخابات التي يُفْتَرَضُ إنها ديمقراطية، لاختيار رؤساء الهيئات المحلية (البلديات ) وحُكّام الولايات ونواب المجالس المحلية والإتحادية وغيرها من الهيئات التي يُفْتَرَضُ تمثيلها مصالح كافة المواطنين، كما يعتمد تمويل الحملة الإنتخابية على أموال مُجَمّع الصناعات العسكرية والشركات العابرة للقارات، ذات المَنْشَأ الأمريكي، التي تجني أرباحًا ضخمة من الحُروب ومبيعات الأسلحة ومن الهيمنة الإقتصادية والعسكرية والمالية للإمبريالية الأمريكية، ولذلك يُحاول الأثرياء استخدام ثروتهم للتّأثير في مجرى الإنتخابات الأمريكية يوم الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، كما الإنتاخبات السابقة، فَهُمْ يمتلكون وسائل الإعلام ويُموّلون الحملات الإنتخابية ومجموعات الضّغط التي تُدافع عن مصالحهم، ويملك بعض المليارديرات الأميركيّين إمبراطوريات إعلامية ( مثل شبكة فوكس) واقتصادية عالمية، مثل إيلون ماسك، مالك منصّة “إكس” وشركة “تيسلا” لصناعة السيارات الكهربائية، والحليف الكبير للمرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي خفض الضرائب على الثروة وعائدات المُضَارَبَة عندما كان رئيسًا ويَعِد بمزيد الحوافز لأرباب العمل والأثرياء لو فاز بالرئاسة في انتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وتجدر الإشارة إلى ارتفاع عدد المليارديرات في الولايات المتحدة بنسبة 38% منذ فوز ترامب بانتخابات الرئاسة سنة 2016، وفق موقع صحيفة نيويورك تايمز، كما يمتلك الملياردير جيف بيزوس رئيس شركة “أمازون”، صحيفة “واشنطن بوست” التي أعلنت هيئة تحريرها أنها تستعد للتوصية بدعم مرشحة الحزب الديمقراطي كمالا هاريس، لكن بيزوس ألغى هذه التّوصية…
يستغل كل من الأثرياء والمُرشّحين بعضهم البعض، ضمن عملية تبادل المنافع أو تحالف السلطة السياسية والثروة المادّيّة، أو تَشَابُك المَصالح، ولا يحتكر الحزب الجمهوري دعم الأثرياء، بل يدعم البعض من أثرى أثرياء الولايات المتحدة والعالم مرشحة الحزب الدّيمقراطي، ومن بينهم إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “ألفابت” وداستن موسكوفيتز المؤسس المشارك لشركة منصات “ميتا” وتقدّر ثروتهما معًا بحوالي 55 مليار دولارًا، وكريستي والتون، زوجة ابن مؤسس وول مارت ( أكبر شركة عالمية لتجارة التجزئة) سام والتون، وميليندا فرينش غيتس، الزوجة السابقة لبيل غيتس…
يتلقى كلا الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة مبالغ باهظة من التبرعات من الشركات والأثرياء، مما رَفَعَ من التكلفة الإجمالية للانتخابات الفيدرالية مع كل دورة انتخابية، وبلغ “الإنفاق السياسي” خلال انتخابات 2020 ( الرئاسة والكونغرس) مبلغًا قَدْرُهُ 14,4 مليار دولار أو حوالي ضِعْف الإنفاق الإجمالي على الإنتخابات السابقة سنة 2016، ومن المتوقع أن تُحطّم دورة 2024 كافة الأرقام السابقة، حيث أعلن “إيلون ماسك” تأييده لدونالد ترامب وتبرّعه بمبلغ كبير شهريا لمنظمة مؤيدة لدونالد ترامب تمكنت من جَمْع أكثر من ثماني مليارات دولارا لدعم ترامب، منتصف تموز/يوليو 2024، معظمها من شركات التكنولوجيا وشركات اللوجيستيات والبرمجيات في وادي السيليكون، ضمن عملية انتقال شركات تكنولوجية كبيرة إلى صف الحزب الجمهوري ودونالد ترامب بعدما كانت تتبرع بنسبة 90% لمُرَشَّحِي الحزب الدّيمقراطي الذي لا يزال تأثيره كبيرًا في وادي السيليكون، لكنه في انخفاض، فضلاً عن قطاعات التمويل والتأمين والعقارات والمحروقات والتّعدين والنّقل الجوي (الخاص) والقطاع الصّحّي الخاص، وتُعتَبَرُ هذه القطاعات أكبر مَصْدَر لتمويل الحملات الانتخابية للمرشحين، والتي ارتفعت تبرعاتها لصالح دونالدترامب، كما ارتفعت تبرعات الأفراد المتقاعدين الأثرياء والمنظمات الإيديولوجية الجمهورية المحافظة لصالح دونالد ترامب…
أما معظم التبرعات لمرشحة الحزب الدّيمقراطي فجاءت من مصالح تجارية كبرى ومن الصناعات ومن النقابات العمالية ومن قطاعات الترفيه (هوليود) والإعلام، وبعد تَنَحِّي جوزيف بايدن وتعويضه بنائبته كامالا هاريس، شكل قطاع الاتصالات والإلكترونيات، الذي يشمل شركات التلفزيون والأفلام والموسيقى والاتصالات والإعلام، ثاني أكبر مصدر للتبرعات التجارية، بالإضافة إلى مكاتب المُحاماة والإستشارات القضائية والتعليم والرعاية الصّحّيّة ومجموعات الضغط المُؤيّدة للحزب الدّيمقراطي…
تستهلك الإعلانات والإشهار بوسائل الإعلام القسم الأكبر من الإنفاق على الحملات الإنتخابية، تليها التكاليف الإدارية وتنظيم التجمّعات الشعبية التي تسمح للشركات التي تُخطّط وتشرف على التنظيم المالي للحملات الإنتخابية، بتحقيق أرباح ضخمة من هذا النّشاط “المَوْسِمِي الدّوْرِي”، ويُمكن الإستنتاج – من خلال الإطّلاع على سير الحملة الإنتخابية وتمويلها – إن أبناء الطبقة العاملة وصغار المزارعين والفُقراء وأحفاد العبيد والشعوب الأصلية، محرومون من التمثيل السياسي لمصالحهم الطبقية، سواء فاز الحزب الديمقراطي المتحالف مع قيادات النقابات العمالية أو مُرشح الحزب الجمهوري الذي يُجاهر بعدائه للطبقة العاملة والفُقراء والمواطنين السّود وذوي الأُصُول المهاجرة…
يُجسّد الملياردير إيلون ماسك “عقلانية” الإستثمار الرّأسمالي في الإنتخابات، فهو لم يُسدّد أي ضريبة فيدرالية على الدّخل بين سنتَيْ 2018 و 2021، بينما زادت ثروته بوتيرة عالية، وهو ينشُرُ حاليا– بعد أن دعم جوزيف بايدن سنة 2020 – معلومات مُضلّلة عن الإنتخابات على موقع إكس ( X أو تويتر سابقا ) بوتيرة محمومة لفائدة دونالد ترامب، وفق صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 11 تشرين الأول/اكتوبر 2024، ويَكْمُنُ سبب دعم إيلون ماسك وبعض المليارديرات الآخرين حملة دونالد ترامب في الوعود بخفض الضرائب على الثروة ( وهي حاليا بنسبة 8% على الدّخل الذي يتجاوز 25 مليون دولارا) وأرباح الشركات الكبرى، وإلغاء ضريبة الحدّ الأدنى على مكاسب الثروات الكبيرة، ولذا فإن عائدات إيلون ماسك تفوق استثماراته السياسية بكثير، وسوف ترتفع بشكل كبير إذا ما فاز دونالد ترامب…
أما بيتر ثيل ـ الذي يمول جزءاً كبيراً من الجهاز السياسي والفكري لحملة دونالد ترامب (Make America Great Again – لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) فهو من الإستراتيجيين الأثرياء الذين يدعمون – بل يُرَوّجون – إيديولوجيا المُحافظين الجدد، وعَبَّرَ عن رضاه التّام عن عائداته من الاستثمارات السياسية منذ سنة 2015، وهو من مُكتشفي “المواهب الجديدة” القادرة على ترويج الإيديولوجيات الأشَدّ رجعية، فهو الذي “اكتشف” جي دي فانس (الذي اختاره دونالد ترامب نائبًا له لو فاز بالرئاسة) حيث مَوّل تأليف ونشر ودعاية كتاب جي دي فانس الذي أصبح المؤلف الأكثر مبيعًا، واكتسب شُهرة سريعة مكّنته من جَمْعِ حوالي 15 مليون دولارا من التأليف والمحاضرات، قبل أن يتكفل بيتر ثيل بالدّعاية السياسية لجي دي فانس ومسيرته السياسية التي قادته إلى الفوز بمقعد في مجلس الشيوخ سنة 2022، ثم اختاره دونالد ترامب نائبًا له خلال انتخابات 2024، ويرتكز خطاب فانس (ومن ورائه بيتر ثيل) على الإدّعاء بأن الدّولة الإتحادية بقيادة الحزب الدّيمقراطي تُهْمِل مصالح العُمّال والفُقراء البيض وتخدم مصالح الأقليات والمهاجرين…
هناك شركات ومنظمات أخرى تُوزّع تبرعاتها على الحزْبَيْن الديمقراطي والجمهوري، وهي مبالغ كبيرة تعتبرها الشركات أو أصحاب الثروات استثمارًا تنتظر منه عائدًا، مهما كان الفائز، لأن الرأسمالي عقلاني لا يعرف غير الإستثمار مقابل أرباح مضمونة، فيما لا يزال تمثيل العمال ضعيفًا في الولايات المتحدة وفي غيرها من الدّول الرأسمالية المتطورة…
انعكاسات السياسة الخارجية الأمريكية على واقعنا كعرب
يتّفق الحزبان الرئيسيان في الولايات المتحدة على التّوَجُّهات الإستراتيجية و “خدمة المصالح الأمريكية” وحماية “الأمن القومي الأمريكي” الذي يمتدّ إلى كافة مناطق العالم، وفي مقدّمتها منطقتنا التي تُسميها الإمبريالية “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، حيث تم زرْع ورعاية الكيان الصّهيوني لتقسيم الوطن العربي وللْحُؤُول دون وحْدَتِهِ وتحرير أراضيه المحتلة من الأهواز شرقًا إلى سبْتَة ومليلة والجُزُر الجَعْفَرِيّة غَرْبًا، مرورًا بفلسطين وما حولها، وتتم “حماية الأمن القومي الأمريكي” بواسطة الأساطيل البَحْرِية والقواعد العسكرية، وتنصيب ودعم الأنظمة العميلة، وعرقلة وحصار أي دولة تحاول الخروج عن بوتَقَة ونفوذ الإمبريالية الأمريكية ( كوبا وفنزويلا وإيران وروسيا وكوريا الشمالية والصين…) وتتمثل الوسائل المُسْتَخْدَمَة في التهديد العسكري والقصف والإحتلال من قِبَل القوات الأمريكية مباشرةً أو باسم حلف شمال الأطلسي، وكذلك في استخدام المنظمات الدّولية مثل الأمم المتحدة والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وبواسطة هيمنة الدّولار الذي يُمكن الولايات المتحدة من الإشراف على المبادلات التجارية والتحويلات المالية الدّوْلية…
كما يتفق الحزبان وكافة الرّؤساء ونواب الكونغرس على دعم الكيان الصهيوني وجرائمه، لأن هذا الكيان يُمثل امتدادًا للنفوذ الإمبريالي الأمريكي (والأوروبي )، وهو قاعدة ومَحْمِيّة في نفس الوقت، وتُشارك الولايات المتحدة مباشرة في العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى الشعب اللبناني والسوري والعراقي واليمني وكافة الشعوب العربية والإيرانية، ولذ فإن الكيان الصّهيوني يحْظى بدعم المُرَشَّحَيْن كامالا هاريس و دونالد ترامب…
الدعم غير المشروط والواسع النطاق للهجمات الصهيونية
استثمرت الولايات المتحدة عشرات المليارات من الدولارات في الدعم العسكري للكيان الصهيوني منذ تأسيسه. وهذا الدعم المالي والعسكري ثابت في السياسة الأميركية، مهما كان الرئيس أو لون أغلبية ممثلي «الكونغرس» المنتخبين. وخلال حملة الانتخابات الرِّئاسية لسنة 2024، يتنافس المرشحان على تعزيز هذا الدعم، حيث يقدم دونالد ترامب نفسه على أنه “أفضل حليف لإسرائيل على الإطلاق في البيت الأبيض”، فيما تُصِرّ كامالا هاريس في كل مناسبة على “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.
كانت الولايات المتحدة (قَبْلَ الاتحاد السوفييتي) أول دولة تعترف بالدّولة الجديدة المُقامة على أرض فلسطين والمُسمّاة رسميا “إسرائيل”، بعد ساعات قليلة من إعلانها في أيار/مايو 1948، ولم تعد الدبلوماسية الأميركية والأوروبية تشير أبدًا إلى القرار رقم 194 الذي صدر في كانون الأول/ديسمبر 1948، والذي يسمح “بحق العودة” لنحو 850 ألف فلسطيني تم تهجيرهم بالقوة وفْقَ مُخطّط مُعدّ سلفًا، بالإضافة إلى التعويضات ( وليس العَوْدَة أو التعويضات كما يُرَدّد البعض) وهكذا، تم سنة 1949، إنشاء الأونروا، وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن “مساعدة اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل هذا النزاع”، وبعد عُقُود على إنشائها أصبحت “أنروا” هدفاً للولايات المتحدة وألمانيا وكندا وغيرها، وللإحتلال الصهيوني، لأن الأونروا هي رمز النكبة وشاهد على عواقبها، ولذلك، وبغض النظر عن الفائز في تصويت الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، فإن الولايات المتحدة لن تخفض المساعدة الهائلة التي تمنحها الآن للكيان الصهيوني ( فيما قطعت مساهمتها في تمويل أنروا)، ويعود تكثيف هذه المساعدات إلى حزيران/يونيو 1964، أي قبل ثلاث سنوات من عدوان 1967، حيث تزايدت الإمدادات العسكرية من الولايات المتحدة للجيش الصّهيوني، إلى جانب الأسلحة الفرنسية والبريطانية، بالإضافة إلى الأسلحة الألمانية، فيما بعد، في ظل تسعير العدوان الأمريكي على شعوب فيتنام وكمبوديا ولاوس، وعندما اندلعت حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، سَمح “الجِسْر الجَوِّي” الأمريكي للجيش الصهيوني بتنفيذ هجوم مضاد مكّنه من قَلْب موازين القوى، مما يُثْبِت إن الدّعم الإمبريالي الأمريكي كان حاسما في هذه الحُروب.
منذ سنة 1979، خلال فترة رئاسة جيمي كارتر الذي أشرف على اتفاقيات كَمْبْ ديفيد، تلقى الكيان الصهيوني مساعدات عسكرية بقيمة مليارَيْ دولار كل عام، وارتفع المبلغ، سنة 2016، خلال رئاسة الرئيس الدّيمقراطي الأسْوَد باراك أوباما، إلى 3,8 مليارات دولار سنويا على مدى عشر سنوات… وما انفكّت هذه الالتزامات المالية والعسكرية تتَعَزَّز، وبغض النظر عن إسم الرئيس وحزبه، فإن دعم الولايات المتحدة غير المشروط للدولة الصهيونية مستمر في النمو، خصوصًا مع تصاعد قُوّة وتأثير “الصهاينة المسيحيين”، الذين يشكلون القاعدة الانتخابية لدونالد ترامب ويسيطرون إلى حد كبير على الكونغرس، ويشكلون أفْضَلَ تعبير عن الوجه الحقيقي للإمبريالية الأمريكية، ليس فيما يتعلق بفلسطين فحسب، بل وأيضًا فيما يتعلق بالسكان الأصليين لأمريكا، ولأحفاد العبيد وللشُّعوب المُضْطَهَدَة في جميع أنحاء العالم، وللمهاجرين الذين يُساهمون في ازدهار اقتصاد أمريكا الشمالية، ولا يُشكّل المسؤولون المنتخبون من الحزب الديمقراطي سوى أحد وُجُوه الإمبريالية، المَطْلِي ببعض المساحيق، أو الذي يحمل قناعًا “ديمقراطيًّا”…
نشر مركز أبحاث في جامعة براون في رود آيلاند الأمريكية دراسة عن المساعدات العسكرية الأمريكية للكيان الصهيوني، التي قدّرها بنحو 251 مليار دولار (بالدولار الثابت، بين سَنَتَيْ 1959 و2021 ) ويُقَدِّرُ نفس التقرير أن الولايات المتحدة أنفقت ما لا يقل عن 23 مليار دولار، بين السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 ومنتصف أيلول/سبتمبر 2024، منها 18 مليار دولارا في شكل مساعدات عسكرية مباشرة، ومُساعدات في شكل عمليات أميركية «لضمان أمن إسرائيل»، ولا تشمل هذه الأرقام المُساعدات الأخرى وعمليات الإمداد العسكري التي نفذتها إدارة جوزيف بايدن، عبْرَ تجزئة التحويلات للالتفاف على الالتزام القانوني ( الذي يَفْرِضُ َعْرض مبلغ الدّعم على موافقة الكونغرس إذا ما بَلَغَ قيمةً مُعيّنة) بالإضافة إلى ذلك، اقترح جوزيف بايدن ( آب/أغسطس 2024 ) مبلغًا إضافيًا بقيمة عشرين مليار دولار من الإمدادات العسكرية على مدى السنوات المقبلة، زيادةً عن المساعدات الحالية والمخطط لها مباشرة والمُعَدّة لإبادة الشعب الفلسطيني بالسلاح أو بواسطة الجوع والأمراض…
لهذه الأسباب لا يمكن انتظار أي تغيير في السياسة الأمريكية والإمبريالية عمومًا، ولا يمكن حصول أي تغيير سوى بالمقاومة والإلتفاف الشعبي العربي والأجنبي حول الشعب الفلسطيني واللبناني واليمني وجميع الشُّعُوب المُضْطَهَدَة، ومُقاومة الثّالوث الإمبريالي – الصهيوني – الرجعي العربي…