الجانب الثقافي والإستعمار “اللَّيِّن”، بَوّابة المشاريع الإستعمارية، نموذج فلسطين / الطاهر المعز

مدارات عربية – الجمعة 19/1/2024 م …
مُقدّمة
يندرج الإستعمار الإستيطاني الصّهيوني ضمن السّياق الإستعماري مُتعدّد الأشكال ومُوحّد الأهداف، وتندرج حرب الإبادة والحصار والتّجويع ضمن مُمارسات الإستعمار المُباشر وغير المُباشر، كما تندرج المُقاومة الفلسطينية ضمن سياق مراحل وحركات التّحرّر الوطني، فما من شعب مُسْتَعْمَر إلاّ وثار ضدّ احتلال وطَنِهِ واستعباد وإبادة أفراده…
يُعتَبَرُ الكيان الصّهيوني قلعة مُتقدّمة للإمبريالية في المشرق العربي وبالذّات في ما كان يُسمّى “سوريا الكُبرى”، وَيُشكّل بقاء الكيان الصهيوني وهيمنته على المنطقة أمْرًا حيَوِيًّا ( سياسيا واقتصاديا وجيواستراتيجيا) للإمبريالية الأمريكية وحلفائها، ما جعل القوى الإمبريالية تُجْمِع على دعم حرب الإبادة والتجويع والإذلال بتواطؤ من معظم أحزاب السّلطة والمعارضة وسائل الإعلام ومنظمات حقوق البشر والنقابات والهيئات البرلمانية في كافة البلدان التي اصطُلِحَ على تسميتها ب”الغربية”…
يُعْتَبَرُ الإستعمارُ المُعاصِرُ أو الإمبريالية أو الرأسمالية الإحتكارية واحدة من مراحل تَطَوُّر الرأسمالية بين القرنَيْن الثامن عشر والتاسع عشر في أوربا الغربيّة عموما والولايات المتحدة الأمريكيّة، وترافقت هذه المرحلة مع التّطوّر التكنولوجي الذي استفادت منه الجُيُوش الغازية، وتمثل أساسًا في ابتكار التيار الكهربائي والمُحركات ذات الإحتراق الدّاخلي وتطوّر تقنيات الإتصالات، وساهمت هذه الإبتكارات في تطوير أساليب الإنتاج وما رافقها من تغيرات في مجالات التسويق والبيع والاستهلاك، ما خَلَقَ فائضًا إنتاجيا وجب تسويقه في مناطق بعيدة عن أوروبا (إفريقيا وآسيا) وتحويل نمط إنتاجها “البدائي” بالقُوّة إلى نمط إنتاج استهلاكي للسلع التي تُصنع بأوروبا ما شَوَّهَ طبيعة المُجتمعات التي وضع الإستعمار حدجًّا لتطورها الطبيعي وفَرَضَ عليها بالقُوّة نمطًا مُسْتَوْرَدًا من أوروبا التي لم تكن في نفس مستوى التّطور…
استخدم الإستعمار اختلاف مراحل التّطور الإقتصادي والسياسي لتبرير الإستعمار بصفته “غَزْوًا حَضارِيًّا” ضد التّخلّف وَدَعَّمَهُ الباحثون “المُسْتشرقون” ورجال الدّين (الكنيسة) وعُلماء الآثار واللغة لتبرير السيطرة، وعلى سبيل المثال مثّل الغزو الفرنسي للمشرق العربي، أو ماسُمِّيَ “حملة نابليون بونابرت على مصر وبلاد الشام” (1798- 1801)، تكريسًا لاستخدام الباحثين والعُلماء لتحقيق أهداف استعمارية، فقد رافق الجيش الفرنسي طاقمُ من 167 عالما وباحثًا من عُلَماء الأنثروبولوجيا والآثار والتاريخ والحضارة والعديد من التخصصات، كجزء من نَشْر وترويج المشروع الإستعماري الفرنسي وطمس الإنتاج التاريخي والحضاري العربي، وساهم هؤلاء العلماء في نَهْب التّراث المصري الذي لا يزال منتصبًا بساحات باريس وسَجِينَ مَتَاحِفِهَا، ولا ننسى طَرْح نايلون بونابارت – الذي انهزم جيشه في عَكّا بفلسطين سنة 1799 – “تجميع اليهود وتأسيس دولة لهم في فلسطين”، وأصدَرَ علماء الأنثروبولوجيا والآثار بحوثًا ودراسات ساعدت السُّلُطات الإستعمارية الفرنسية على تقسيم الشعب الجزائري ومساعدة الجيش المُحتل على بَسْط نُفُوذه، ولذلك يُصبح من المنطقي طرح السؤال عن دَوْر الأنثروبولوجيا في السياق الاستعماري وتوظيفها في فلسطين حيث سخّرت الحركة الصهيونية الأبحاث الأنثروبولوجية لخدمة إنتاج المعرفة والإيديولوجيا الإستعمارية في فلسطين، ما يُثير تساؤلات عن العلاقة بين الدراسات الأنثروبولوجية والبرامج السياسية، كما رَوّج العُلَماء والمُثَقَّفُون الإستعمارِيُّون الادّعاء أو الطرح الذي يساوي الإستعمارَ بالحداثة، فيما يَعْتَبِرُ الفلسطينيون والعرب إن الإستعمار هو نظير النّكبة المُستمرة ( في فلسطين كما في القارة الأمريكية أو أستراليا أو نيوزيلندة) باعتبارها أحداثاً أو وقائع وعمليّات متواصلة تتمثل في ممارسة العُنْف السُّلْطَوِي الإستعماري ونهب الأراضي، وتدمير “الآخر” وإزاحته من وطَنِهِ وهي فَرْضٌ مُتواصل لِلُغَةٍ وثقافةٍ غريبة، أي إن احتلال الأرض/الوطن يرتبط بعملية غَزْو ثقافي وتدمير حضاري للبُنى الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والثقافية، لِيَفْرِض الإستعمار مكانها البُنَى التي استَوْرَدَها معه من أوروبا الإستعمارية، وحصل ذلك في بلدان أمريكا الشمالية والجنوبية، كما حَصَل في فلسطين حيث لا تزال ذكرى الغزو حاضرة مع المؤسسات الصهيونية والجيش والمستوطنات والتوسّع الإستيطاني في أنحاء فلسطين التاريخيّة، حيث ربطت مؤسسات الدّولة الصهيونية منذ البداية بين أصلها الصهيوني وخطاب الحداثة، فاليهود الأوروبيون مُتحضِّرُون حَوّلُوا الأرض القاحلة إلى أرض مزدهرة، مع إنكار وجود شعب أصْلِي (الفلسطينيين)
كان العدوان الفرنسي المُسمّى “حَمْلَة نابليون” على مصر بنهاية القرن الثامن عشر، إيذانًا بمرحلة جديدة من الهيمنة الأوروبية، منذ انتهاء حُرُوب الفَرَنْجَة المُسَمّاة “الحروب الصّلِيبية” وساهم الأنثروبولوجِيُّون وعُلماء الآثار في التّمهيد للإستعمار العسكري، وساهموا في تَطَوّر علم الإنسان (الأنثروبولوجيا) وعلم الأحياء (البيولوجيا) وعلم الإجتماع والتاريخ والجغرافيا وعلم اللغة، ودراسات الأثنيات والأعراق والأَدْيان، كما ساهموا في إثْراء وتطوير العلوم السياسية والإقتصادية، كما تضمّنت وُفُود البعثات الأوروبية خلال القرن التاسع عشر ( بعد هزيمة نابليون في عكا سنة 1799) بعثات علمية ودينية تهدف جميعها خِدْمَةَ مصالح القوى العُظْمى في ذلك الوقت: بريطانيا وفرنسا وألمانيا ورُوسيا…
الإبادة والتّدمير ممارسات استعمارية “تقليدية”
وقائع تاريخية
سببت العملية الفدائية ليوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 رُعبًا استثنائيًّا أصاب الكيان الصهيوني ورعاته الذي كانوا يعتقدون إن الحصار المُستمر منذ سنة 2006 والتجويع والقهر كفيل بإرضاخ الشعب الفلسطيني واعتقدوا إنها لن يكون قادرًا على المُقاومة، ولهذا السبب أعلنت الإمبريالية الأمريكية منذ يوم الثامن من تشرين الأول/اكتوبر 2023، نقل حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر فورد” إلى سواحل فلسطين وعلى متنها خمسة آلاف ضابط وجندي أمريكي، لتعزيز سُفُنها التي كانت تُحاصر غزة، منذ سنة 2008 إلى جانب البوارج الحربية الأوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وغيرها) فضلا عن الجنود والأسلحة والعتاد والقوات الأمريكية المتواجدة في قواعد حلف شمال الأطلسي بتركيا وقواعدها في سوريا والعراق ومَشْيَخات الخليج، ومخازن الأسلحة الفتّاكة في فلسطين المحتلة، وأعلنت السّلطات الأمريكية دعما ماليا وعسكريا وسياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا غير محدود للكيان الصهيوني، لأن الممارسات الصهيونية هي استمرار لممارسات القوى الإستعمارية الأخرى، وعلى سبيل المثال كانت بريطانيا تستعمر جنوب إفريقيا، وتَمَرّد ضِدّها مُقاتلو “مملكة الزُّولُو”، خلال القرن التاسع عشر، في بداية سنة 1879، وهزموا جيش بريطانيا “العُظْمَى” الذي انتقم من سُكّان البلاد، بعد حوالي ستة أشهر، فقتل الجنود البريطانيون ما لا يقل عن عشرة آلاف من السكّان الأصليين ونهبوا وخرّبوا ودَمّروا عاصمة الزُّولُو (أولوندي)، وكانت الإبادة والتدمير بمثابة إنذار لسكّان جنوب إفريقيا وغيرهم، لأن جنوب إفريقيا وزمبابوي الحالية وبوستوانا غنية بالمعادن التي تريد الشركات الإحتكارية البريطانية استغلالها، وأدّى استخراج المعادن إلى تدمير حياة المجموعات المَحلّيّة للسّكّان الذين قاوموا هذا الغَزْو (الإقتصادي والعسكري والبيئي) الذي دَمَّر حياتهم، فكانت المعارك عنيفة بين خلال الرّبع الأخير من القرن التّاسع عشر، جابهها الإستعمار البريطاني بتكثيف عمليات القتل والإبادة للسكان ومواشيهم وتدمير المحاصيل والمساكن، وتُعتبر ممارسات الجيش الصهيوني اليوم في فلسطين استمرارًا لممارسات الجيوش والمُستعمرين الأوروبيين في إفريقيا وآسيا وفي أمريكا الجنوبية، منذ نهاية القرن الخامس عشر، واستمرارًا للممارسات الإمبريالية البريطانية والفرنسية ثم الأمريكية في جميع أنحاء العالم، من فيتنام إلى الجزائر، ما يُبَرِّرُ هذا الدّعم المُطْلَق وخلق التبريرات للمجازر وعمليات الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني الذي يُمثّل في نظر السلطات السياسية والإعلامية “الغربية” نُسخة من الشعوب التي قاومت الإمبريالية في فيتنام والجزائر وغينيا بيساو وأنغولا وموزمبيق، ولذا فإن قتل عشرين ألف فلسطيني – حوالي 40% منهم أطفال – خلال عشرة أسابيع وتدمير ثلاثة آلاف مَبْنَى ودَفْن الجرحى أحياء تحت الأنقاض وتدمير المستشفيات والكنائس التاريخية وغيرها، أعمال مُبَرَّرة، خصوصًا وإن مرتكبيها من “شعب الله المختار”.
الإستعمار “النّاعم” باسم البحث والتنقيب
الدّور الأمريكي
نشأت الولايات المتحدة وكندا كمستوطنات أوروبية على أرض الشعوب الأصلية التي تمت تسمية أهلها ب”الهنود”، وتم بناء هذه المُسْتوطنات (كما أستراليا ونيوزيلندا) على جثث الشعوب الأصلية التي تم الإستيلاء على أراضيها (أوطانها)، وكان المشروع الصّهيوني، منذ بداياته، نسخةً لهذا الشكل من الإستعمار الإستيطاني الأوروبي، مع بعض التّغييرات، ومن بينها قَتْل من يمكن قتلهم وترهيب البقية كي يُغادروا وطنهم، وهو ما حصل، ولا يزال يحصل منذ خمس وسبعين سنة…
كانت أمريكا الشمالية والولايات المتحدة بالذّات النموذج والرّاعي والدّاعم الأساسي للكيان الصهيوني، خصوصًا منذ حرب 1973، غير إن تاريخ الدّعم سابق لتأسيس الكيان الصّهيوني.
لعبت أمريكا أيضاً دوراً هاماً في تشجيع الاستيطان الصهيوني في فلسطين. ومن أشهر الصهيونيين الأمريكيين وليام يوجين بلاكستون – 6 تشرين الأول/أكتوبر 1841 – 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1935 – ( William Eugene Blackstone (1841- 1935) الذي كان مبشرًا أمريكيًا ومسيحيًا صهيونيًا، ومؤلف كتاب بلاكستون التذكاري للعام 1891، وهو عريضة دعت أمريكا إلى “إعادة الأرض المقدسة إلى الشعب اليهودي”، ولذلك يعترف له كافة الزعماء الصهاينة بالجميل، وأقاموا له نصبًا تذكاريا وأطْلَقُوا إسمه على إحدى الغابات المُقامة فوق القرى والاحياء الفلسطينية التي تم تدميرها، بهدف طَمْسِ كل أثر لها، واعتَبَرَهُ بنيامين نتنياهو “أحد أبرز نماذج الصهيونية المسيحية التي سَبَقَت الحركة الصهيونية الحديثة بما لا يقل عن نصف قرن، وكانت تدعو إلى عودة اليهود إلى أرض إسرائيل…” وكتب عنه آيس، توماس د.، “وليام بلاكستون والصهيونية المسيحية الأمريكية” – 2009 ( Ice, Thomas D., “William Blackstone and American Christian Zionism” (2009). كانت دعوة بلاكستون وأمثاله من الكنيسة البروتستانتية سابقةً لظهور الحركة الصهيونية المُعاصِرَة، وكان لها دور كبير في تشكيل الحركة الصهيونية في أمريكا، وفي تشجيع وتنشيط استيطان اليهود في فلسطين، وأصدَرَ وليام يوجين بلاكستون كتابًا سنة 1878 بعنوان بعنوان “عيسى قادم” قبل 13 سنة من تقديمه مقترحا للرئيس بنيامين هاريسون في 5 آذار/مارس 1891 يدعو فيه إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وحظِي الإقتراح بتأييد ودَعْم العديد من كبار الشخصيات الأمريكية، ومنهم القاضي لمفيل Lamfiel، ورئيس مجلس النواب فولير Foleir وجون روكفيلر John Rokfelr ووليام روكفلر William Rokfelr وغيرهم، وحَصَلَ ذلك في إطار انتشار الأفكار والمشاريع الاستيطانية التي طرحتها ودعمتها الدول الاستعمارية الغربية، وفي إطار نشاط عدد من المفكرين من رجال الدّين (الحاخامات) اليهود خلال القرنَيْن الثامن عشر والتّاسع عشر الذي ساهموا في تأسيس عدد من الجمعيات اليهودية الناشطة في أمريكا الشمالية وأوروبا والداعية إلى تكثيف الإستيطان من أجل إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، ومن أهمّها :
تأسيس مُستعمرة استيطانية أمريكية في مدينة يافا الفلسطينية سنة 1854، تحت إسم “مُستعمَرة الإرسالية الأمريكية” من قِبَلِ مجموعة من المتعصبين البروتستانت الأمريكيين البيض الذين عرفوا باسم “ديكسون” فقاوم السكان الفلسطينيون هؤلاء المستعمرين الذين يستفزونهم باستمرار وأسفرت الخُصُومة عن مقتل عدد من المُستوطنين فأرسلت الولايات المتحدة فرقاطة بخارية عسكرية إلى شواطئ فلسطين لمطالبة العثمانيين بمحاكمة القتلة، وكذا فعلت ألمانيا بعد عقدين من الزمن دفاعًا عن المستعمرين البروتستانت الألمان المتعصبين، كما أرسلت ألمانيا سفُنها الحربية إلى فلسطين خلال الحرب العثمانية الروسية (1877-1878)، للدفاع عن المستعمرين الدينيين الألمان، المعروفين باسم “فرسان المعبد”، وأجبر القنصل الألماني العثمانيين على الاعتراف بمستعمرات المُتطرفين البروتستانتيين الألمانيين المعروفين باسم “فرسان الهيكل” الذين كانوا يُعْلِنُون تحويل فلسطين إلى دولة مسيحية بروتستانتية تابعة لألمانيا، واستغل الفلسطينيون تَمَرُّدَ حركة “شباب تركيا” سنة 1908 في القسطنطينية، ليهاجموا المستعمرات الألمانية. ن وأرسلت ألمانيا من جديد سفينة حربية إلى حيفا للدفاع عن المستعمرين
الجمعية الأمريكية للتنقيب في فلسطين
ازداد الإهتمام بالأديان والروحانيات وبفلسطين، في أمريكا مع انتهاء الحرب الأهلية، وتضمّن ذلك الإهتمام بخارطة فلسطين، واستكشاف الأرض المقدسة، وأسَّسَت مجموعة من أعْيان مدينة شيكاغو، سنة 1869 الفرع الأمريكي الأول لصندوق استكشاف فلسطين ( (Exploration Society وتضمن برنامجها نداء: «إلى الضمير الديني مسيحيًا كان أم يهوديًا من أجل البرهنة على صحة الكتاب المقدس» وتَمَثّلَ نشاطها في البداية في تقديم الدعم المالي إلى المنظمة الأم وهي بريطانية، قبل أن تُصبح جمعية أمريكية مستقلة لاستكشاف فلسطين في شيكاغو وفي نيويورك ومدن أخرى بهدف ” البرهنة على صحة الكتاب المقدس” وأصدرت نشرة دورية، في تموز/يوليو 1871 وأُرسلت بعثات لمسح الأراضي ووضع خرائط جغرافية وأَثَرِيّة لفلسطين، بالإشتراك مع جمعيات دينية/استعمارية أخرى، غير إن الطذابع الدّيني كان طاغيا على الوثائق التي نُشرت حتى الحرب العالمية الأولى، فاتسمت الخرائط والرُّسُومات والنّصُوص والمنشورات بعدم الدّقة الجغرافية والتاريخية والأنثروبولوجية، لأنها كانت مَبْنِيّة على المعطيات التوراتية، ولا علاقة لها أحيانًا بالشواهد الأثرية في المواقع المَدْرُوسَة.
تأسَّسَت «المدرسة الأمريكية للأبحاث الشرقية» في القُدْس سنة 1900، من قِبَلِ بعض الجامعات ومعاهد اللاهوت الأمريكية، وتَمَثَّلَ نشاطُها الرّئيسي في التنقيب عن الآثار في أرض فلسطين، بدعم من مؤسسات السُّلطة الأمريكية، ومن ضمنهم الرئيس ثيودور روزفلت، وحَظِيت بدعم مالي كبير لممارسة التدمير وتخريب التّراث الفلسطيني لأن البعثة “لم تستطع التخلص من مصطلحات الجدول الزمني التوراتي” وفق تقرير كتبه رئيس البعثة سنة 1907
جمعيات دينية/صهيونية أوروبية:
تأسَّسَ «صندوق استكشاف فلسطين (Palestine Exploration Fund)سنة 1865، «بهدف البحث في الآثار والجغرافيا والجيولوجيا والتاريخ الطبيعي لفلسطين». وشرحت المجلة الدورية للصندوق سنة 1869 أهداف الجمعية كالتّالي: «من أجل البحث الدقيق والمنظم في الآثار والطبوغرافيا والجيولوجيا والجغرافية الطبيعية والتاريخ الطبيعي وعادات وتقاليد الأرض المقدسة لغاية التوضيح التوراتي»، وتأسست جمعية بريطانية توراتية مُتصهْيِنة أخرى سنة 1870 إسمها «جمعية الآثار التوراتية» (Society of Biblical Archaeology)، ووضعت من أهدافها: «البحث في الآثار والتسلسل الزمني والتاريخ القديم والحديث لبلاد آشور والجزيرة العربية ومصر وفلسطين وغيرها من المناطق التوراتية».
كانت أوروبا ومنها فرنسا وألمانيا وبريطانيا سبّاقة في مجال البحث والتنقيب في المشرق العربي، غير إن الجمعيات البريطانية ثم الأمريكية كانت كثيرة وغَنِيّة، ولكنها لا تهتم بالتاريخ والآثار والحضارة واللغة العربية بل بهدف إزاحة البحث العلمي المَنْهَجِي واستبداله بهاجس “إثْبات صحّة النّصّ الدّيني الوارد في التّوْراة، وعلى غرار الجمعيات البريطانية، أَسَّسَ المسيحيون الدّمينيكان سنة 1890 “المدرسة الفرنسية للدراسات التوراتية والأثرية” وأنشأ الألمان جمعيتين: «الجمعية الألمانية للدراسات الشرقية»(Deutsch Orient Gesellschaft) ، سنة 1897، و«الجمعية الألمانية للأبحاث الفلسطينية»، سنة 1877.
حظي صندوق استكشاف فلسطين برعاية الملكة فيكتوريا التي تبرعت ( من المال العام) بمبلغ مالي، وبالدّعم السياسي من قِبَل شخصيات رسمية ودينية وبالدّعم المالي من قِبَلِ البرجوازية المالية والصّناعية، وذلك بغرض توظيف البحث العلمي في خدمة النّصّ الدّيني للتّوراة، دون إهمال الأغراض العسكرية، فقد أشْرَفَ سلاح الهندسة المَلَكِيّة، منذ 1868 على عمليات المَسْح وإصدار أطلس فلسطين الذي يضم تفاصيل عن المواقع والمَوارد والسّكّان والفلاحة، وكان المُشْرِف على إصدار هذا الأطلس العقيد كوندر، وهو مُستشرق مُختصّ في الجغرافيا، وأظهرت كُتُبُه التي نشرها بين 1879 و 1909، إنه من غلاة الصهيونية المسيحية.
جميعة الأليانس (التحالف اليهودي العالمي) Alliance Esraëlite Universelle:
أسس الصهاينة هذه الجمعية الصهيونية سنة 1860 في باريس، لتشجيع ودعم الهجرة اليهودية بغرض الاستيطان في فلسطين، وأسّست الجمعية مدرسة مهنية سنة 1865 لتدريب اليهود على المهن المختلفة، وأسست سنة 1867 مجموعة من المدارس الابتدائية في القدس وحيفا ويافا وصفد وطبريا لتعليم الفرنسية والدين اليهودي، كما أسّست سنة 1870 مدرسة زراعية يهودية قُرْب مدينة يافا، لتعليم أبناء اليهود الزراعة، قبل إنشاء مستوطنات زراعية في فلسطين، ووسعت جمعية “الأليانس” نشاطها إلى أوروبا الشرقية، بداية من 1869، فأسَّسَتْ لجنةً لمساعدة المهاجرين اليهود من شرق أوروبا إلى فلسطين، بالتنسيق مع المنظمات الصهيونية الأخرى مثل جمعية الاستيطان اليهودي Jewish Colonization Association وتعلّلت الأليانس بالنشاط العلمي والثقافي لتخدم الإستعمار الفرنسي والبريطاني، والحركة الصهيونية، فأسست مدارس ( باعتمادات مالية ضخمة) في المغرب والجزائر وتونس وسوريا والعراق وإيران، فضلاً عن فلسطين وغيرها بهدف بث الدّعاية الصهيونية والحث على هجرة اليهود وتسهيلها إلى فلسطين.
أوروبا الشرقية:
جمعية أحياء صهيون Hibbat Zion:
ارتفعت حِدّة التّوتّرات داخل الإمبراطورية الروسية والمجتمع الروسي خلال فترة حكم القياصرة – الذي وضعت الثورة البلشفية سنة 1917 حَدًّا له – وتمظهرت بعض جوانب هذه التّوتّرات في أعمال العنف ومظاهر الإضطهاد ضد اليهود، خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، ولم تقتصر أعمال العنف على روسيا بل عَمّت أوروبا الشرقية وبعض أوروبا الغربية، واستغلّ المُتطرّفون اليهود هذه الأحداث المأساوية لتأسيس مجموعة من الجمعيات اليهودية في أوروبا الشرقية، بداية من سنة 1881، بدعم من جمعيات من أوروبا الغربية شكّلت مَعًا جمعية أحياء صهيون – Hibbat Zion – التي تأثرت بفكر موسى هس ( Moses Hess – 1812- 1875 ) المنشور في كتابه بعنوان “روما والقدس” – Rome and Jerusalem – والذي كان له دور هام في نشأة الفكر الصهيوني والحركات الصهيونية المعاصرة، لأنه طَوَّرَ فكرة “القومية اليهودية” و “إقامة دولة يهودية”، كما أنشأت مجموعة من الطلبة اليهود سنة 1882 جمعية البيلو ( Bilu) التي اختصّت في دعوة اليهود للهجرة إلى فلسطين بعد حملات اضطهاد اليهود في روسيا التي استغلتها مثل هذه الجمعية للتبشير “بالبعث القومي لليهود من خلال الهجرة إلى فلسطين وإقامة مستوطنات زراعية فيها، لأنه لا مكان لليهود في حضارة أوروبا”، وأنْشأت هذه الجمعية مجموعة من المستوطنات الزراعية في فلسطين التي كانت خاضعة للإحتلال العُثماني.
عملت جمعيات أحياء صهيون على دعم الاستيطان الصهيوني في فلسطين، وكان لها الدور الأكبر في إنشاء المستوطنات الزراعية الأولى في فلسطين، وأنشأت تسع مستوطنات في مطلع الثمانينات من القرن التاسع عشر.
قُدِّرَ عدد اليهود في فلسطين “سنة 1837 بنحو 1500 يهودي وارتفع العدد سنة 1840 إلى نحو عشرة آلاف يهودي ونحو 15 ألف يهودي سنة 1860 وحوالي 22 ألف يهودي سنة 1881 وكان معظمهم في منطقة القدس حيث كانت أوّل محاولة استيطانية ناجزة لهم، خارج أسوار القدس، سنة 1859 بإتمام إنشاء حي يهودي ومستشفى ومساكن شعبية خاصة باليهود، بقرار عُثْماني (فرْمَان) صادر سنة 1855 وارتفع عدد المُستوطنين اليهود بين سنتَيْ 1882 و 1903، خلال فترة حكم السلطان عبد الحميد إلى أكثر من ستّين ألف وسمح لهم السّلطان سنة 1878 بإقامة مدينة بيتاح تكفا ثم مدينة ريشيون لتسيون ومستوطنات زخرون يعقوب وروش بينا سنة 1882 وروحوبوت والخضيرة سنة 1890 ليبلغ عدد المهاجرين اليهود 85 ألف مُستوطن في 47 مستوطنة عند انطلاق الحرب العالمية الأولى سنة 1914، وأُقِيمت هذه المستوطنات على أراضي قرى وأحياء ومُدُن فلسطينية، بتواطؤ الإحتلال العثماني، وكانت أولى هذه المستوطنات (تباح تكفا على أراضي قرية ملبس، وريشون لتسيون على أراضي قرية عيون قاره سنة 1882، ثم روش بيناه على أراضي قرية الجاعونة قرب صفد وزخرون ياكوف على أراضي قرية زمارين جنوب حيفا والجديرة على أراضي قرية قطرة)، وكان لإنشاء هذه المُستوطنات باستثمارات ضخمة، دور في تشجيع الموجات الأولى للهجرة الإستيطانية إلى فلسطين، التي امتدت من عام 1882- 1904، وبلغ عدد المُسْتَوْطَنات أربعة وعشرين مستوطنة، وترافقت هذه الموجة مع نشأة الحركة الصهيونية المُعاصرة التي أسّسها المفكر الصهيوني ثيودور هرتزل ودعا إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين ” وطن اليهود التاريخي الذي لا يمكن أن ينسى، ويكفي أن سحر هذا الاسم سيجلب اليهود إليها” بحسب مشروع الإستيطان الذي قَدّمَهُ في مؤتمر مدينة “بازل” السويسرية ( 29 – 31 آب/أغسطس 1897) بهدف دَفْع الأثرياء اليهود في العالم إلى المُساهمة في تمويل الإستعمار الإستيطاني في فلسطين، وإنشاء “صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار” ( Jewish Colonial Trust ) الذي يهدف – من بريطانيا – دعم المستوطنات اليهودية في فلسطين وأنشأ فرعًا له تحت إسم ” المصرف البريطاني الفلسطيني – Anglo-Palestine Bank)، وإنشاء الصندوق القومي اليهودي “الكيرن كايمت” Keren Kayemeth ) منذ سنة 1901، بهدف تجذير الاستيطان الصهيوني في فلسطين من خلال شراء الأراضي…
امتدت هذه الحقبة حتى سنة 1914 (بداية الحرب العالمية الأولى) حيث استغلت الحركة الصهيونية الحرب لزيادة مساحة المستوطنات واستخدام اللغة العبرية وتشغيل اليهود حصْرً (العمل العبري) وإنشاء مؤسسات استيطانية صهيونية كمقدّمة لإقامة دولة “إسرائيل” على أرض فلسطين، وهو ما عمل الإستعمار البريطاني على تحقيقه وغض الطرف عن (وأحيانًا دعم) عمل الاتحاد العام للعمال اليهود في فلسطين “الهستدروت” Ha-Hestadrot الذي تأسس سنة 1920، الذي كان يُعَنّف أصحاب المؤسسات التي تُشغّل غير اليهود، وفَجَّر العديد من المؤسسات التي تُشغل الفلسطينيين، وتحالف “هستدروت” مع الصندوق التأسيسي لفلسطين “الكيرن هايسود” KerenHayesod الذي تأسّس سنة 1921، لدعم الهجرة والإستيطان، بالتعاون مع الوكالة اليهودية The Jewish Agency التي تأسّست سنة 1922 وكذلك التنظيمات الصهيونية المسلحة مثل الهاغاناه وإتسل وليحي التي استخدمت العُنف المُسلّح لتهجير الفلسطينيين من وطنهم حتى سنة 1948، حيث كانت أُسُس الدّولة الصّهيونية جاهزة قبل مُغادرة الجيش البريطاني المُستَعْمِر الذي تواطَأَ مع الحركة الصهيونية التي أطردت الشعب الفلسطيني بالقوة وأنشأت كيانا مَبْنِيًّا على مبدأ فوقية اليهود الصهاينة الأوروبيين (أشكينازيم) وعلى السيادة الحصرية على المكان والسكان.
دَور الإستشراق أو “الإستعمار النّاعم”
طَوَّرَت القوى الإمبريالية الأوروبية الداعمة لتأسيس الكيان الصهيوني على أرض شعب فلسطين المفاهيم الاستشراقية – أو المشروع الثقافي الإستعماري – منذ الغزو الفرنسي أو ما سُمِّيَ “حملة نابليون على مصر والشام ( 1798 – 1801) واستبدلت التاريخ والوثائق ونتائج الحفريات وعلوم الآثار، بأساطير وخرافات ونصوصًا توراتية تم انتقاؤها بهدف اعتمادها كأساس لخلق تاريخ «عبري/إسرائيلي»، بديلاً لتاريخ فلسطين، بالتوازي مع عمل المؤسسات الصهيونية (وهي جزء من الإستعمار) المالية والإشهارية ومليشياتها المُسَلّحة بتواطؤ عثماني ودعم بريطاني…
اعتمد طابور الإستعمار الثقافي في فلسطين على جمعيات ومؤسسات “علمية” وعلى ما دَوّنَهُ الكُتّاب والرّحّالة والحجاج (إلى الأراضي المٌدّسة، أي فلسطين) والمُستشرقين وعُلماء الآثار، خلال القَرْنَيْن الثامن عشر والتاسع عشر، لإنتاج المعارف الإستعمارية التي تميّزت بهيمنة “الدراسات التوراتية” التي تكيّفت تمامًا مع الجوانب السياسية والعسكرية للإيديولوجية الإستعمارية واجتهدت لإنكار تاريخ الفلسطينيين على هذه الرقعة الجغرافية التي تُسمّى فلسطين، وعلى سبيل المثال فقد كتب اللورد ليندسي (Lord Lindsay)، سنة 1838 ” أن عقم واضمحلال أرض فلسطين لم يكن بسبب لعنة أصابت الأرض، ولكن ببساطة بسبب عدم وجود سكانها القدامى ( ومن حسن الحظ) إنهم قليلوا العدد” ( كتاب رسائل عن مصر وإيدوم والأرض المقدسة – 1839 – (Letters on Egypt, Edom and the Holy Land، ووصَفَ اللورد شافتسبري (أنطوني أشلي كوبر)، فلسطين، منذ سنة 1839، أي قبل نشأة الحركة الصهيونية الحديثة بأنها “بلاد بدون أمة لأمة بدون بلاد ” ( مقال بعنوان «الدولة وآفاق المستقبل أمام اليهود» – 1839 )، واستمر نَشْر مثل هذه الدّعوات الصهيونية من قِبَل غير اليهود، وبعد خمسة عقود أكّد القس الأمريكي وليام بلاكستون، سنة 1888 “إن فلسطين هذه تُركت هكذا أرضًا بغير شعب، بدلًا من أن تعطى لشعب بغير أرض»، مِمّا ساهم في تدعيم الصهيونية الحديثة التي أسّسها إسرائيل زانغويل (Israel Zangwill) وحاييم وايزمان وثيودور هرتزل ودايفيد بن غوريون، رغم البحوث الأنثروبولوجية التي تُثبت “إن اليهود المعاصرين ليسوا من أصل فلسطيني بل من أصل خَزَرِي وقوقازي” وفق عالم الآثار “إسرائيل فنكلشتاين” (Israel Finkelstien) الذي دعا إلى “تحرير علم الآثار الصهيوني من سطوة النص التوراتي”، وذَكَر “زئيف هرتسوغ” عالم الآثار الصهيوني، أستاذ قسم الآثار وحضارة الشرق القديم في جامعة تل أبيب البروفيسور، زئيف هرتسوغ: ” «بعد سبعين عامًا من الحفريات المكثفة في أرض فلسطين، توصل علماء الآثار إلى نتيجة مخيفة: لم يكن هناك شيء على الإطلاق، حكايات الآباء مجرد أساطير، لم نهبط مصر، ولم نصعد من هناك، لم نحتل فلسطين، ولا ذكر لإمبراطورية داود وسليمان… لم يُقم اليهود في مصر، ولم يَتيهوا في الصحراء ولم يستوطنوا فلسطين ولم تكن مملكة سليمان سوى مملكة قبلية صغيرة وليست دولة عظمى… “، وفق مقال نشرته الصحيفة الصهيونية هآرتس” بعنوان “التوراة: لا إثباتات على الأرض”، بتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1999
ظهرت في أوروبا الإستعمارية ( خصوصًا بريطانيا وألمانيا وفرنسا ) وفي أمريكا الشمالية، مدارسُ فكريةٌ تفتَرِضُ صحّة ما وَرَدَ في كتاب العهد القديم (التواراة) لتعتمد عليه كمصدر تاريخي تَخَصَّصَتْ في دراسات “آثار العهد القديم”، وتنطلق من الافتراض بصحة العهد القديم، ومن ثم الاعتماد عليه مصدراً لتاريخ “الأرض المقدّسة” أي فلسطين الذيتم تطويعه ليَتوافق مع الأهداف الإستعمارية، ولإقصاء الشعب الفلسطيني من التاريخ (الزمان) ومن جغرافية بلده فلسطين ( المكان ) ولسرقة تراثه الثقافي الكنعاني والعربي، ليصبح التاريخ والأنثرورولوجيا وعلم الآثار، جزءاً من التّبرير الإيديولوجي للمطامح والأهذاف الإمبريالية والصّهيونية
الدّور الأوروبي في تشجيع هجرة واستيطان اليهود في فلسطين
مارست البعثات القنصلية للدول الأوروبية أدوارًا مختلفة تُناسب مصالحها وأطماعها التوسعية، على مدى أكثر من سبعة عقود، حتى الحرب العالمية الأولى ( من 1840 إلى 1914) وفق ما تُبينه الوثائق العثمانية والبريطانية والفرنسة والألمانية بخصوص أدور القناصل والبعثات القنصلية الأوروبية التي تجاوزت الإطار الدبلوماسي لتسلب الشعب الفلسطيني وَطَنَهُ، مستخدمةً الإمتيازات الممنوحة لدولها من قبل الدولة العثمانية، كما استخدمت الإرساليات والبعثات الدينية والتبشيرية لشراء الأراضي باسمها وتسريبها إلى المجموعات اليهودية التي تُخطّط منذ منتصف القرن التاسع عشر لاحتلال فلسطين، وبذلك وفّرت الدّول الأوروبية الشروط الموضوعية لإعلان بلفور الذي جَسّد الرغبة البريطانية الرسمية في إقامة دولة لليهود في فلسطي.
بريطانيا: كانت بريطانيا حريصة على تعزيز دورها في فلسطين واستغلال التنافس بين فرنسا وروسيا، فأسست قنصلية في القدس سنة 1838 ثّم أنشأت فروعًا لها في حيفا ويافا وعكا وصفد وعيّنت وُكَلَاء من السكان المحليين، وكانت البداية بالقدس كمحور النشاط السياسي لأهميتها الدينية والإستراتيجية بالنسبة للولاية العثمانية في المنطقة ولكي تساعد في إنجاز مهام وزارة الخارجية البريطانية، وتّم تكليف بعض العرب ليكونوا نّواب قناصل أو في خطة سكرتير أّول بهدف مراقبة الموانئ البحرية التجارية في كل من حتى تكون بريطانيا على بّينة بما يجري من أحداث في المدن الساحلية من فلسطين (عكا وحيفا ويافا )، وكانت لبريطانيا أبعاد عسكرية من خلال الإشراف على الجانب التجاري وكان وكلاء القناصل، قبل ذلك، يتبعون القنصل العام لبريطانيا في بيروت، وتَبَيّنت أهمية قنصلية القدس من خلال ما ورد في رسالة وزارة الخارجية البريطانية إلى القنصل العام في القدس سنة 1858: “إن حكومة بريطانيا تحاول جاهدة تكريس الوجود البريطاني في القدس وبالتالي في المدن الأخرى لحماية مصالحها الحيوية ورعاياها من الطائفة اليهودية وعليكم القيام بواجبكم لحماية اليهود الوافدين إلى فلسطين في إطار الرحلات المقدسة التي سُمِحَ لهم بها، وأن تَحُولُوا دون قيام الباب العالي بمنعهم من الإقامة وهذا واجب عسكري تُحاسَبُون عنه”، واستطاع القنصل البريطاني الأول في القدس وليم يونغ الذي تولى مهامه من سنة 1839 الى سنة 1845 أن يُؤَمِّنَ لنفسه راتبًا خاصًا إضافيا ويفتح له حسابات مصرفية في عدة مصارف عثمانية وأجنبية لتمويل المهام العديدة المطلوبة منه، وحذا حذوه كثير من القناصل الأوروبيين الآخرين الذين بدأُوا يُشرفون مباشرةً على حماية اليهود، والحيلولة دون التصّدي لهم أو التدخل في شؤونهم، وقد استفاد اليهود كثيرًا من هذه الميزة، إذْ كتب القنصل البريطاني إلى قاضي مدينة القدس يؤكد فيها أّن القنصلية البريطانية هي المسئولة أمْنِيًا وسياسيًا عن حماية رعاياها من اليهود في فلسطين وأّن على القاضي الشرعي أن يُراعي ذلك في معاملاته وتصّرفاته، ومنذ سنة 1845، أصبح القنصل العام البريطاني يتدخّل في شئون السكان الفلسطينيين ولعب القنصل “فن” ( Finn ) بين سنَتَيْ 1845 و 1862 والقنصل تمْبل مُور ( 1863 – 1890 ) دورًا خطيرًا في الدّفاع عن الأطماع الأوروبية وفي هجرة واستيطان اليهود في القدس وفي التّدخُّل والإشراف على عمليات بيع الأراضي لجمعية مرسلي الكنيسة الإنغليزية في فلسطين التي كانت تبيعها فيما بعد لليهود، وكانت معظم البيوعات تتم عن طريق القنصلية البريطانية بيافا، وكان دور القنصلية البريطانية (وقنصليات أوروبية أخرى) كبيرًا في ارتفاع عدد عمليات بيع الأراضي والعقارات لصالح القنصليات الأوروبية التي تبيعها فيما بعدُ لليهود، في مطلع القرن العشرين، سواء في المُدُن أو أو في القرى الفلسطينية، وتحَوّلَ بعض القناصل إلى تجار ومالكي أراض، ومُقْرِضِين للأهالي، ومن بينهم “بِتْرُوشِلِّي”، نائب القنصل البريطاني في حيفا الذي أصبح مالك للأراضي وتاجرًا وأقام عالقات وطيدة مع الفلاّحين من خلال إقراضهم للمال بالتسليف وتحرير المُستندات، وبذلك تمكّن من مُصادرة أراضي الفلاحين الذين لم يتمكّنوا من سداد الدّيون وفوائدها، ومن نَقْلِ مِلْكِيّةِ مساحات كبيرة من الأراضي إلى اليهود والأجانب، وقامت بريطانيا من خلال قنصليتها في القدس وبمساعدة قنصلها “تمبل مور” بتأسيس ومساعدة “جمعية التنقيب عن الآثار في فلسطين” التي كانت جميع مهامّها تتمثّل في تسهيل إقامة اليهود في فلسطين وترسيخ وجودهم فيها ودعم نشاطهم في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وفق الوثائق الصهيونية ووفق سجلاّت المحاكم الشرعية في مدينة القدس التي تعكس بوضوح ما فعله قناصل بريطانيا لخدمة لخدمة مصالح دولتهم ومصالح اليهود الأوروبيين في فلسطين، تجاريًا وفلاحيًا وصناعيًا وعسكريًا، ومنحت القنصلية البريطانية في القدس العديد من يهود أوروبا جوازات سفر بريطانية، وساعدت المئات على المجيء إلى فلسطين بذريعة “زيارة الأراضي المقدسة”، ثم استوطنوا فلسطين كرعايا بريطانيين وتكفلت القنصلية البريطانية بالقدس بحماية الطوائف اليهودية وسّهلت لعناصرها الضمانات والحصانات القانونية، ما جعلهم معْفِيِّين من الضّرائب، وما جعل مُحاكمةَ المُخالفين منهم تتم أمام محكمة قنصلية، وفق الوثائق التاريخية الموجودة لدى محكمة القدس الشرعية ومحكمة نابلس الشرعية، وكرست بريطانيا وجودها في أواخر القرن التاسع عشر من أجل تسهيل موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين بشتى الأساليب والوسائل، ثم لعبت قنصليات فرنسا وألمانيا نفس الدّور، بعد الإمتيازات التي منحت لها من قبل الدولة العثمانية وتحديدًا منذ بدايات القرن التاسع عشر، ومن بينها الحرية الكاملة لكافة الرعايا المسيحيين في الوصول إلى “الأراضي المقدسة ” والحج إلى بيت المقدس.، ثم وَسَّعت القنصلية الفرنسية من نشاطها وأْسَدت خدمات هامّة وقـّيمة لليهود، حيث استغل الدّبلوماسيون الفرنسيون في القدس ودمشق وبيروت الإمتيازات التي وَفَّرَتْها لهم معاهدة سنة 1535، لشراء أراٍض تحت أسمائهم وبحجة أّن عددًا من الرعايا الفرنسيين هم بحاجة لشراء أراض لإقامة مصالح اقتصادية ودينية عليها، قبل تسريبها إلى اليهود، ( حصل ذلك، على سبيل المثال في قرية “الخضيرة” سنة 1879 التي أصبحت مستوطنة صهيونية فيما بعد) واستخدموا بعض الأراضي لبناء المدارس الفرنسية والإرساليات الكاثوليكية، وفق سجلات المحاكم الشرعية في كل من القدس ويافا، وساعدَ القناصلُ الفرنسيُّون هجرة اليهود الأوروبيين إلى فلسطين وعلى شراء الأراضي في مُدُن يافا واللّد والرملة…
أما ألمانيا فقد بدأت بإنشاء مؤسسات دينية، ومنها الأسقفية الإنغليكانية بشراكة مع بريطانيا، ثم أقامت مُستعمرات دينية اقتصادية في مدينة حيفا، ثم تَوَجَّهَ قناصل ألمانيا، بداية من سنة 1868 نحو تشجيع إقامة المستعمرات الألمانية في حيفا ( رغم معارضة السلطات العثمانية في البداية) شملت مجموعة من البيوت على سفح جبل الكرمل وكذلك مدرسة ومكان للعبادة، وأشرف على بنائها المهندس الدنماركي لويفيد Loyved.Mr)) وزينت المستعمرة في مدخلها بعبارة يهودية كتبت بالغة الألمانية : “تنساني عيني إن نسيتك يا قدس” ونَمت هذه المُستعمرة بسرعة وتلتها مستعمرات أخرى، في حيفا ويافا وتوطّدت علاقات ألمانيا بالحركة الصّهيونية ولعبت قنصلياتها دورًا خطيرًا ( إلى جانب القنصليات الأوروبية الأخرى) في تسريب الأراضي إلى الجمعيات اليهودية، وفي تكثيف حركة الهجرة اليهودية، وفي إحباط أإضعاف جذوة المقاومة العربية لاستيطان اليهود الذين حافظ جميعهم على جنسياتهم الأصلية، فضلا عن تسهيل قنصليات أوروبا منح جنسيات بلدانها إلى اليهود القادمين من أوروبا الشرقية، وكانت روسيا قد طلبت منع هجرة اليهود الروس إلى فلسطين خشية “الإخلال بالوضع الديني القائم في القدس والأراضي المقدسة” غير إن قناصل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلدان أوروبا الشمالية استغلُّوا فساد موظفي الدّولة العثمانية الذين حصلوا على رشاوى وتجاوزوا القرارات والفرمانات العثمانية الرافضة لإقامة اليهود ولشرائهم الأراضي، كما تدخّلت القنصليات الأوروبية مباشرة في اعتقال ومعاقبة المقاومين وإخلاء سبيل اليهود الذين سرقوا الأراضي والمباني، بعد تزييف الوثائق، مقابل رشوة الموظفين، وأصبحت القنصليات تُشجّع اليهود الأوروبيين على مخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها، من خلال حمايتها لهم، ويمكن التأكيد إن الدولة العثمانية مُشاركة في التّآمر على الشعب الفلسطيني تحت عنوان حمايته.
المشروع الصهيوني = مشروع استعماري مُستمر
اعتاد زعماء ومناضلو أحزاب الدّين السياسي (الإخوان المسلمون) على ترديد كذبة مفادها إن بريطانيا تآمرت على العثمانيين من أجل تسهيل الإستيطان في فلسطين وبأن العثمانيين منعوا بيع الأراضي لليهود ومنعوا اليهود من الإقامة في فلسطين، لكن الوقائع والأرقام تثبت ارتفاعا كبيرا بعدد المهاجرين اليهود بهدف الإستيطان في عهد السلطان عبد الحميد بالذّات (يَدّعُون إنه رفض هجرة الصهاينة بغرض الإستيطان) الذي عَزَل متصرف القدس لأنه كان يُعَطِّلُ بيع الأراضي لليهود، واستبدله بغيره مِمّن ساعد في تسريع عملية بيع الأراضي…
ارتبطت هجرة القرن العشرين بشعار العمل العبري، وبنشأة المستعمرات الجماعية (الكيبوتس) والتعاونية (الموشافاه)، ليس من باب تطبيق الإشتراكية، كما يدّعي بعض اليسار الأوروبي، بل من أجل إحكام قبضة الزعماء الصهاينة على المستوطنات والمستوطنين من خلال تطبيق الإشراف المركزي الصارم على حركة الاستيطان وعلى حركة المستوطنين وإبقائهم تحت إشراف إدارة المُستوطنات بهدف ردعهم عن مغادرة فلسطين والعودة الى بلادهم الأصلية، ونجحت الحركة الصهيونية – بتواطؤ من الإحتلال العثماني – في إقامة بُذُور مجتمع استيطاني يهودي صهيوني منفصل عن أهل البلاد، قبل الدعم المباشر للإستعمار البريطاني وأقاموا مختلف المُؤسسات التي تُشكّل نواة الدّولة التي أسّسوها سنة 1948، وكانت المؤسسات الصهيونية جاهزة لإدارة الإحتلال العسكري وتهجير الشعب الفلسطيني في عملية استبدال شعب بمجموعات بَشَرِيّة قادمة من مناطق أخرى من العالم، واستغلال الأرض والموارد وإقصاء السّكّان الأصليين من الحياة السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية، غير إن هذا الإقصاء لم يكن ناجحًا بنسبة 100%، بفعل وجود مقاومة فلسطينية بأشكال مختلفة، سِلْمِيّة وعنيفة، فرديّة وجماعية رغم حَشْر الفلسطينيين وتطويقهم في معازل مُحاطة بالمُستَعْمرات وبحواجز جيش الإحتلال ومُصادرة أراضيهم لضَمِّ أكبر قَدْر منها من دون سكان، وتُمثّل هذه السياسات بعض ركائز منظومة الحكم الاستعماري للسيطرة على كل فلسطين ومنع المجتمعات المُجاورة من التّطوّر…
لم تُغيّر مفاهمات أوسلو من طبيعة الإحتلال، ولا من أُسُسِ العلاقة بين المُسْتَعْمِر الصهيوني والمُسْتَعْمَر الفلسطيني، ولا يزال الكيان الصهيوني يُسيطر على البنية الاقتصادية الفلسطينية بسبب هيمنته على الأرض والموارد والمياه، وبسبب مَنْع الفلسطينيين من الإنتاج بهدف تحويل فلسطين إلى سوق مُوَحّدة لسلع الإحتلال، وأدّى التوسّع الإستيطاني إلى إزاحة الفلسطينيين عن أراضيهم من قِبَل الجيش والمستوطنين المُسَلّحين بإشراف جيش الإحتلال الذين يُدمّرون المبني ويتلفوم المحاصيل ويقتلون المواشي ويجرفون الأراضي الزراعية تحت حماية جيشهم، بتآمر من سلطة الحكم الذاتي الإداري التي لها جهاز أمْنِي مُتضخِّم يُؤمِّن حراسة المُستوطنات والمُستوطنين ويعتقل المُقاومين، وتمكّنت أجهزة أمن سلطة أوسلو (التي دربتها وسلّحتها الإستخبارات الأمريكية لقمع الفلسطينيين) من عرقلة العمل الوطني والمقاومة الشعبية، وبلورة برنامج تحرر وطني، يمزج بين مختلف أشكال النضال لخلق ميزان قوى جديد…
مُخطّطات عديدة والهدف واحد
ما كان تأسيس الكيان الصهيوني ممكنًا لولا الدّعم الإمبريالي والتواطؤ العثماني والإقطاعي ثم الكُمْبْرادوري العربي مع الإمبريالية والصهيونية، ليضُمَّ العدُوُّ ثالوثًا وجبت مقاومته حتى تحرير فلسطين وكافة الأراضي العربية المحتلة…
شكّلت النّدوة التي جمعت المنظمات الصهيونية بنيويورك بفندق “بِلْتْمُور” من السادس إلى الحادي عشر من أيار سنة 1942، Biltmore Hotel – May 6 – 11 / 1942 ) ) تحوّلاً في النظام الرأسمالي العالمي وانتقالاً لمركز القرار والسيادة والسيطرة العسكرية والسياسية والاقتصادية من أوروبا (بريطانيا وفرنسا) إلى الولايات المتحدة الامريكية، ويُعدّ المؤتمر الصهيوني مُنْعَرَجًا وانعطافا في الحركة الصهيونية التي أدْرَكت تحول ميزان القوى، وأصبحت تعتمد على الدّعم الإقتصادي والعسكري والسياسي الأمريكي لتحقيق أهدافها في السيطرة على الوطن العربي، وخصوصا على مَشْرِقِهِ الذي يَضُمُّ مصادر النفط والممرات التجارية بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، وازدادت أهمية التحالف الإمبريالي الأمريكي- الصهيوني منذ انهيار الإتحاد السوفييتي وفَرْض سياسة القُطْب الواحد التي تجسّدت في العدوان على العراق وحصاره، سنة 1991، وتفتيت يوغسلافيا، بداية من 1999 واحتلال الصومال وأفغانستان والعراق، ضمن مُخطّط “الشرق الأوسط الكبير” الذي يتّسع من آسيا (حدود الصين وآسيا الوُسطى والجنوبية) إلى سواحل المحيط الأطلسي (المغرب)، ويمزج بين مُخطّطات الزعيم الصهيوني شمعون بيريز للسيطرة على الوطن العربي ومحيطه والمُستشرق والمؤرخ البريطاني برناند لويس ودراسة صادرة عن معهد الدراسات الاستراتيجية القومية التابع لوزارة الحرب الامريكية، وليس من باب الصّدفة أن تُنْشَرَ هذه الدّراسات والبحوث، بين سنتَيْ 1991 و 1995، مباشرةً بعد انهيار الإتحاد السوفييتي، ليكون العالم، ومن ضمنه الوطن العربي، تحت الهيمنة الكاملة الأمريكية وحليفها الكيان الصهيوني وأعضاء حلف شمال الأطلسي الذي توسّع (بدل حَلِّهِ بعد حل حلف وارسو الذي تأسس بعد خمس سنوات من حلف شمال الأطلسي) ليشمل كل دول أوروبا، غير إن هذه القوة العسكرية الضّخمة لم تتمكن من كسْر شوكة المقاومة في أمريكا الجنوبية وفي الجزائر وفيتنام وأفغانستان واليمن وكذلك في فلسطين رغم ارتفاع عدد الضّحايا والتّخريب والحصار الإمبريالي الصهيوني والعربي الرّسمي، والمهم هو استمرار المقاومة بكافة أشكالها
إن مقاومة الشعب الفلسطيني للاستعمار الاستيطاني الصهيوني استمرار لنضالات الشّعوب، ومنها شعب الجزائر وشعب فيتنام، ضد الإستعمار المدعوم ماليا وعسكريا وسياسيا وإعلاميا من القوى الإمبريالية التي ترى في الإستعمار الصهيوني صُورَتها المُتَفَوّقَة وترى في الشعب الفلسطيني صورة السّكّان الأصليين “المُتخلّفين” لأمريكا أو أستراليا
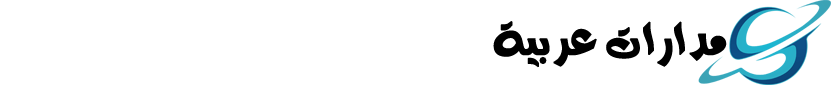

التعليقات مغلقة.