مقال تحليلي عميق … العلاقات السورية السعودية.. مطالب أمنية وانعكاسات سياسية / شاهر الشاهر
في السياسة، ليست هناك صداقات دائمة ولا خلافات مستمرة، وذلك أمر مشروع في التعاطي السياسي الرسمي بين الدول وحكوماتها، لكن المشكلة تكمن في نقل تلك الخلافات من المستوى الرسمي إلى المستوى الشعبي، إذ بدأنا نرى انقسامات بين الشعوب العربية وحملات تخوين أدت إلى تفكك في الواقع العربي، إلى درجة أننا وصلنا إلى الحديث عن الحاجة إلى “تطبيع” بين شعوب بعض تلك الدول، ولم تشذّ العلاقات السورية السعودية عن هذا الإطار.
شهدت العلاقات بين البلدين انفراجات كبيرة بدأت مع وصول الأمير محمد بن سلمان إلى ولاية العهد، إذ حرص على النأي بنفسه عن المواقف التي اتخذتها المملكة ضد سوريا منذ العام 2011. وكانت السعودية قد اتخذت مواقف متشددة وصلت إلى حد العداء لسوريا، وقادت الدعوة إلى تعليق عضويتها في الجامعة العربية، وشجّعت الدول العربية على سحب سفرائها من دمشق.
وكانت العلاقات بين البلدين قد مرَّت بمراحل امتازت بالتعاون والتنسيق، إذ استطاع الرئيس حافظ الأسد خلق حالة من التوازن في التعاطي السوري مع المملكة، من دون أن يشكل ذلك مساساً بالعلاقات السورية الإيرانية.
وبلغ التنسيق السوري السعودي ذروته عند إتمام اتفاق الطائف عام 1989، الذي شكل مخرجاً وحلاً سياسياً للحرب في لبنان، ثم جاء الموقف السوري الداعم للمملكة في حربها ضد العراق بعد اجتياحه الكويت وتهديده باحتلال السعودية.
لقد أدى موقف سوريا من المحور الأميركي في حرب الخليج الثانية وقبولها الذهاب إلى مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 إلى تعزيز العلاقات السورية السعودية التي تطورت إلى علاقات ثلاثية (سوريا سعودية مصرية) متميزة، تمثلت بعدة قمم عُقدت بين زعماء الدول الثلاث.
ومع وصول الرئيس بشار الأسد إلى السلطة، كانت المملكة داعمة ومؤيدة له، وشهدت العلاقة بين البلدين تطوراً وتنسيقاً، لكنه لم يستمر طويلاً، فقد أدى الموقف السوري الرافض للاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 إلى فتور في العلاقات بينهما، إذ كانت المملكة داعمة وبقوة للتخلّص من نظام الرئيس العراقي صدام حسين.
أمّا المقاربة السورية، فقد كانت مختلفة، إذ أشارت دمشق إلى أنّ ذلك احتلال لبلد عربي وإهانة لزعيم عربي، ورأت أنه قد يفتح الباب لاحقاً لتكرارها، ثم بدأت مرحلة الضغوطات الأميركية على سوريا، والتوتر في العلاقة بينها وبين الرئيس رفيق الحريري، وقناعة المملكة بتورط سوريا في اغتياله في شباط/فبراير 2005، وهو ما زاد الفجوة في العلاقات بين البلدين.
وعندما وقعت حرب تموز/يوليو 2006، كان هناك تناقض في الموقفين السوري والسعودي من الحرب، ما جعل كلام الرئيس بشار الأسد في مؤتمر الاتحاد العام للصحافيين (حول أنصاف الرجال) في شهر آب/أغسطس من العام نفسه يفسر بأنه موجه إلى قادة المملكة وبعض الدول الخليجية.
بعد ذلك، حاولت دمشق العمل على ردم الهوة في العلاقة بين البلدين، وزار الرئيس الأسد الرياض 3 مرات في العام 2010، لكن تلك الزيارات فشلت في إعادة المياه إلى مجاريها بين البلدين، وهو ما جعل المملكة تتخذ مواقف متشددة إزاء سوريا منذ اليوم الأول لاندلاع الأحداث فيها، إذ تم الإعلان عن مواقف متشددة تجاه سوريا، تمثلت بدعوة المملكة إلى “طرد” سوريا من جامعة الدول العربية، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، إضافة إلى استضافة عدد كبير من “المعارضين السورية”، وشن حرب إعلامية كبيرة ضد سوريا، ورصد أموال كبيرة هدفها تدميرها وإسقاط النظام فيها.
واليوم، وبعد مرور أكثر من 10 سنوات على تلك الأحداث، لم يعد أحد قادراً على إنكار الدور السعودي في ما حدث في سوريا، إذ شكلت المملكة، وبالتعاون والتنسيق مع قطر، رأس الحربة ضدها.
ولم يكن لعاقل أن يتخيّل أو يصدق حجم الأموال التي رصدت لتدمير سوريا، لولا حديث حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق عنها لاحقاً، حين تحدث عن قيادة المملكة مشروع إسقاط نظام الحكم فيها، إذ أوكلت المهمة حينها للأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز.
وكان للتنسيق السعودي القطري دور كبير في المواقف المتشددة التي اتخذتها المملكة، والتي استمرت حتى إقالة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني في العام 2013 واستلام ابنه الأمير تميم الحكم.
كانت إقالة الأمير حمد بن خليفة حلاً ومخرجاً لتلافي التدهور في العلاقات القطرية مع المملكة العربية السعودية وباقي الدول الخليجية التي اتخذت مواقف حاسمة تمثلت بمقاطعة قطر ووضع شروط قاسية طُلب إليها الانصياع لها كشرط لعودة العلاقات الخليجية معها.
كذلك، فقد راهنت المملكة طويلاً على الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، لكن ما حدث هو عكس ذلك تماماً، وهو ما يدعو المملكة إلى إعادة النظر في سياساتها وتوجهاتها، كما أنَّ “ثورات الربيع العربي” لم تنتج شيئاً، بل إنَّ خطر التقسيم أصبح يهدد العديد من دول المنطقة، ومنها السعودية.
تراجع الحماسة السعودية لعملية إسقاط النظام في سوريا
لم تعد عملية إسقاط النظام في سوريا على رأس أولويات المملكة بعد عام 2015، وذلك لعدة أسباب:
– الخلاف السعودي مع قطر، وشعور المملكة بأنَّ قطر لديها “عقدة الصغير”. لذلك، فهي تسعى لتقسيم جميع الدول العربية، كي لا تبقى وحدها صغيرة.
– الحماسة القطرية للاستمرار في الحرب على سوريا بالتنسيق مع تركيا في هذا المجال، ما جعل المملكة تعيد حساباتها.
– العلاقة الجيدة التي تربط قطر بإيران، وهو ما لا ترغبه المملكة، التي ترى في طهران عدوها الأول. وقد ازدادت حدة هذا العداء بعد حرب اليمن.
– وصول قيادات جديدة شابة إلى الحكم في المملكة، على رأسها الأمير محمد بن سلمان، الذي أصبح ولياً لولي العهد في العام 2015، ثم أصبح ولياً للعهد في أيلول/سبتمبر 2017، ونأي بنفسه عن المواقف السابقة للمملكة إزاء سوريا.
– وكان الأمير محمد بن سلمان قد أرسل رسائل إيجابية خلال قمة “كامب ديفيد” التي عقدت في أيار/مايو 2015 مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، بأن المملكة ليست لديها مشكلة مع سوريا، بل مشكلتها مع طهران.
– صمود سوريا، وعدم القدرة على إسقاط النظام فيها، وتبدد الأمل في تحقيق ذلك، وخصوصاً بعد التدخل العسكري الإيراني والروسي في سوريا.
– طرح ولي العهد السعودي مشروع المملكة 2030، وهي أكبر خطة تنموية في تاريخها، وتنفيذها يتطلب استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
أثر العلاقة مع الولايات المتحدة في الموقف السعودي من سوريا
أدت السياسة الأميركية تجاه المملكة في عهد الرئيس بايدن دوراً في حدوث تحولات في السياسة الخارجية السعودية، إذ كان بايدن، وخلال حملته الانتخابية، قد تحدث عن عدم إمكانية اللقاء مع محمد بن سلمان، بل ذهب إلى أكثر من ذلك، مهدداً بمحاسبته على خلفية قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. لذا، وجد محمد بن سلمان نفسه في الصف الأقرب إلى حلفاء سوريا، وأقصد هنا روسيا والصين، وهما الدولتان الداعمتان لسوريا في مجلس الأمن وبقوة.
وفي عام 2015، زار محمد بن سلمان روسيا، واجتمع مع الرئيس بوتين في سان بطرسبورغ، مبدياً قلقه من ازدياد النفوذ الإيراني في سوريا، ومشجعاً موسكو على التدخل فيها، كما قيل حينها.
وبعدما أصبح الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد عام 2017، قاد حملة ضد قطر انتهت بالمقاطعة الخليجية للدوحة بسبب “دعمها الإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية”، وهو ما عزز الشعور بعدم صواب وقوف المملكة مع قطر في توجهاتها ضد سوريا.
وانطلاقاً من الهدف الأول للأمير محمد بن سلمان، المتمثل بالوصول إلى عرش المملكة بسلاسة وهدوء، وفي ظل توتر العلاقة مع الولايات المتحدة، عملت المملكة على السعي لتصفير مشاكلها مع دول الجوار، وخصوصاً قطر والإمارات، وصولاً إلى سوريا، ومن ثم إيران.
لقد تشكلت قناعة لدى المملكة بأهمية الحوار مع إيران، وذلك لعدة أسباب:
– النفوذ الإيراني المتعاظم في المنطقة، وخصوصاً في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
– عدم الثقة بالولايات المتحدة التي دخلت في مفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي، وتوجت بتوقيع اتفاق معها في عهد بارك أوباما (الديمقراطي)، من دون أن يكون هناك أي دور للملكة أو رأي.
– القناعة بأن لا حل للخلافات العالقة في المنطقة إلا بالدبلوماسية والحوار، ولا مجال لاستبعاد إيران عن أي ترتيبات أمنية في المنطقة.
– رغبة المملكة في وضع نهاية لحرب اليمن، والاستفادة من الطفرة النفطية وحاجة العالم إليها، وخصوصاً بعد الحرب الأوكرانية، وهو ما يتطلب ضمان الأمن والاستقرار في منطقة بحر قزوين.
لذا، دخلت المملكة في حوار مع طهران بوساطة عراقية. وقد حقق هذا الحوار تقدماً كما يبدو. ولعل الملف السوري من أهم الملفات الخلافية بين البلدين. لذا، يجب العمل على حله.
من هنا، فإن التقارب السوري السعودي ليس موجهاً ضد إيران، ولن يؤثر في علاقة دمشق الإستراتيجية بطهران، كما يشاع، بل إنه، فيما لو أنجز، سينعكس إيجاباً على العلاقات السعودية الإيرانية، وسيسهم في حلحلة العديد من الملفات العالقة في المنطقة، ومنها حل مشكلة الفراغ الرئاسي في لبنان، التي من المرجح أن تكون أولى ثمرات هذا التقارب، والعودة إلى معادلة “السين – سين” الشهيرة، التي كرست التوافق السوري السعودي شرطاً للاستقرار السياسي اللبناني. ومن المرجح أن يكون هناك اتفاق لبناني في الأيام المقبلة على اختيار رئيس جديد للبلاد، ولعل سليمان فرنجية أوفرهم حظاً.
أما بالنسبة إلى سوريا، فسياستها الخارجية تتلخص بالانفتاح على بعدها العربي ونسيان الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات بينها وبين باقي الدول العربية، شرط احترام تلك الدول وحدتها وسلامة أراضيها، واحترام خيارات الشعب السوري في تقرير مصيره، وهذا نابع من توجه مبدئي سوري تجاه العرب جميعاً، وناتج من قراءة واقعية لما تعانيه اليوم سوريا من أوضاع اقتصادية صعبة، ناجمة عن سرقة خيرات البلاد ومواردها النفطية من قبل الاحتلال الأميركي وأدواته في المنطقة.
لذا، شهدت العلاقات السورية السعودية تطوراً إيجابياً على الصعيد الأمني والعسكري، بدأ في أيار/مايو 2021، حين تحدثت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن لقاء عقد في دمشق بين رئيس مكتب الأمن القومي اللواء علي مملوك، ورئيس الاستخبارات السعودية اللواء خالد الحميدان، إذ بحث الطرفان القضايا العالقة وسبل التوصل إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، جرى في القاهرة لقاء جمع بين مدير إدارة الاستخبارات العامة السورية اللواء حسام لوقا ورئيس الاستخبارات السعودية خالد الحميدان خلال المنتدى العربي الاستخباراتي الذي عقد في القاهرة.
وفي آذار/مارس 2021، أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الروسي سيرغي لافروف، عن دعم الرياض لعودة سوريا إلى محيطها العربي، مؤكداً أن الحل في سوريا لن يكون إلا سياسياً.
وفي أيار/مايو 2021، شارك وزير السياحة السوري في اجتماع لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط في العاصمة السعودية، وحضر افتتاح المكتب الإقليمي للشرق الأوسط ومؤتمر إنعاش السياحة في الرياض، بدعوة من وزارة السياحة السعودية ومنظمة السياحة العالمية.
ومنذ أسابيع، جرى الحديث عن زيارة قام بها اللواء حسام لوقا إلى المملكة، وقيل إنها توجت بالنجاح، فاسحة المجال للبدء بالعلاقات السياسية بين البلدين. وكانت العلاقات السورية قد شهدت تحسناً مع بعض الدول العربية، وفي مقدمتها الامارات العربية المتحدة، إذ أجرى ولي عهد أبو ظبي في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2021 اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، بحثا خلاله “علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، لما فيه مصالحهما المتبادلة”.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، زار وفد إماراتي برئاسة وزير الخارجية عبد الله بن زايد سوريا، والتقى الرئيس الأسد، في أول زيارة على هذا المستوى منذ 10 سنوات. وفي شهر آذار/مارس 2022، زار الرئيس الأسد الإمارات، وأجرى لقاء مع كبار المسؤولين فيها. كذلك، شهدت العلاقات السورية مع مملكة البحرين تطوراً كبيراً، إذ تم رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء.
وقد أدى البيان الصادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي السعودية المصرية التي عُقدت في الرياض في 12 كانون الثاني/يناير الحالي، والذي جاء رداً على التهديدات التركية باجتياح الأراضي السورية، دوراً إيجابياً في إعادة الثقة بين البلدين، إذ أعلنا موقفاً واضحاً يؤكّد وحدة الأراضي السورية وسلامتها.
إن تحسن العلاقات السياسية سيسمح بعودة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما سيخفف من انعكاسات “قانون الكبتاغون” الذي فُرض على سوريا مستهدفاً اقتصادها وصادراتها، ومن المنتظر عودة الصادرات السورية إلى المملكة عبر الأردن، وصولاً إلى باقي الدول الخليجية، وهو ما سيدحض الادعاءات الأميركية من مخاوف دول الجوار من الصادرات السورية.
وختاماً، إنَّ التحدي القادم أمام الحكومة السورية هو تعزيز الأمن والأمان، وتحسين الواقع الاقتصادي، والعمل على إدارة الوجود الأجنبي على الأراضي السورية، وصولاً إلى خروج جميع القوات الأجنبية منها، للبدء بعملية إعادة الإعمار التي تحتاج إلى مساعدات كبيرة من الدول الشقيقة والصديقة، ومن المأمول أن تؤدي السعودية دوراً في ذلك.
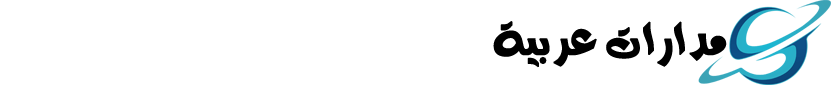

 شاهر الشاهر
شاهر الشاهر
التعليقات مغلقة.