انتهازيّة المثقّف وضرورة المُفكّر المُمَارس / د. هشام البستاني

لطالما أرّقتني انحيازات كثرة من المثقّفين في التحوّلات الصاخبة التي مرّت بها المنطقة العربيّة منذ مطلع القرن العشرين، حيث نهايات الدولة العثمانيّة، وحتى اليوم، إذ ما تزال الانتفاضات الشعبيّة قائمة وفاعلة، ضمن جولةٍ ثانية، في عدّة مواقع داخل الكيانات الوظيفيّة العربيّة التي خَلَّفها الاستعمار.
في خضمّ كلّ تلك التحوّلات، تميّز أغلب مثقّفي الحقب الانهياريّة العربيّة المُتتابعة بأمورٍ ثلاثة: الأوّل ابتعادهم عن نقد السّلطة والاشتباك الفكريّ معها، مع أنّها كانت –على الدّوام، وحتى الآن- العامل الأكثر تأثيرًا في الواقع المُعاش وصياغةً لتحوّلاته؛ والثاني (وهو ذو علاقة وثيقة بالأوّل) عدم انخراطهم في الصّراعات والانتفاضات الشعبيّة التي خاضتها قطاعات مختلفة من شعوبهم، وبقائهم إمّا مُعلِّقين على هامش الأحداث في أحسن الأحوال، أو صامتين، أو منحازين للسُّلطة في أسوئها؛ والثالث (الذي ربّما يُفسّر الأمرين السّابقين) رهانهم المستمرّ والعنيد على السّلطة القائمة في إحداث «التّغيير»؛ وهي كلّها خصائص أساسيّة سأعرّف من خلالها معنى «المثّقف» في السياق العربيّ، واضعًا إيّاه مقابل ما سأسمّيه: المفكّر الممارس، الذي يندر وجوده في ذات السّياق.
من المثير للاستغراب عدم وجود نظراء في المنطقة العربيّة لفرانز فانون، أو كارل ماركس، أو روزا لوكسمبورج، أو فلاديمير إيليتش لينين، أو أنطونيو جرامشي، أو برتراند رَسّل، أو إدواردو جاليانو، أو لكمّ كبير ممن سأسمّيهم: المُفكّرين المُمارسين: أشخاصٌ ساهموا بفعاليّة في الاشتباك -نظريًّا وعمليًّا- مع قضايا عصرهم، ومع أشكال القوّة والسّلطة التي تُمثّلها، مُحاولين تغييرها بالفكر والفعل معًا.
صحيح أن ثمّة استثناءات، لكنّها الاستثناءات التي تؤكّد القاعدة من جهة؛ أو الاستثناءات المُقصاة من حيّز «المثقّف» تمامًا من جهة أخرى: تلك المتعلّقة بفكرٍ يستلهم الماضي الإسلاميّ المُتخيّل، ويشتقّ نفسه المُعاصِرة منه. هنا: تصبح الاستثناءات أكثر بكثير، بل تصير أقرب إلى القاعدة منها إلى الاستثناء، وتتموضع في مواجهة السلطة، وتشتبك فعليًّا معها، لكنها تقع في سياق مبحثٍ آخر كما سنرى.
الرّجوع إلى عدّة مجلّات فكريّة كانت أساسيّة في ثمانينيّات وتسعينيّات القرن الماضي وبداية الألفيّة الجديدة، مثل الطريق، النّهج، القاهرة، أدب ونقد والآداب،[1] وبعض الكتب الرئيسيّة في تلك الحقبة، مثل كتاب برهان غليون اغتيال العقل، الذي يخلص إلى «إن تغيير العلاقة يعني قلب المناخ الثقافيّ السائد، والتخلّص من الأوهام، وتغيير إطار الرؤية والممارسة، وفتح فضاء جديد لازدهار الفكر والشعور معًا»،[2] أو كتاب عزيز العظمة العلمانيّة من منظور مختلف، الذي يخلص إلى نتيجة شبيهة: «لا استعادة لأسس الديمقراطيّة إلا بانفكاك الفكر والحياة عن الارتهان بالمطلق»،[3] يوضّح لنا هذه الخصائص ويؤكّدها، فهي تتحدّث عن محن وأزمات تتعلّق بالعقل العربيّ نفسه، الرجعيّ في ذاته وفي مرجعيّاته (أهم من مثّل هذه المقاربة هو محمّد عابد الجابري في كتبه الأربعة التي تشكّل سلسلة نقد العقل العربيّ)،[4] لا بالظّروف والشّروط التي تنتجه وتوجّهه وتؤثّر فيه وتتسلّط عليه، وتتبنّى مقاربات ثقافويّة، تعتبر أن الخلل فكريّ متعلّق بالقناعات الذاتيّة، لا بُنيويٌّ متعلّق بالواقع الموضوعيّ المتمثّل باحتكار السّلطة، القمع، الفساد، الفقر، التبعيّة، الرأسماليّة، ووظيفيّة الكيانات العربيّة ما بعد الاستعمار ووظيفيّة مجموعاتها الحاكمة، في سياقها.
إنّه «الظلام الذي يحلّق بأجنحته السوداء، والذي سوف يظلّ يلد نفسه لو لم يعمّ الضياء»[5] هذا هو لبّ تعليق محرّرة أدب ونقد، فريدة النقّاش، على قرار قضائيّ (أقدمت عليه ونفّذته السّلطة في مصر)، بالتفريق بين الأستاذين الجامعيّين نصر حامد أبو زيد وزوجته ابتهال يونس، بعد تكفير الأوّل لبحوثه المتعلّقة بالنصّ القرآني، دون أن تتناول بجديّة دور السّلطة لا من قريب ولا من بعيد.
وبينما شنّ المثقّفون حملة فكريّة شرسة على «الدولة الدينيّة» (المفترضة، الآتية في مصر والمشرق العربيّ، التي لم تكن موجودة حينها، ولم توجد بشكلٍ فعليّ حتى الآن)، باعتبارها الخطر الأوّل على الحريّة والناس والديمقراطيّة المأمولة، لم ينبس هؤلاء ببنت شفة عن المجموعات الحاكمة (الموجودة حقًّا على أرض الواقع، لا افتراضًا) التي كانت تقمع وتضطهد الناس فعليًّا، بأشرس ما يكون القمع والاضطهاد.
كل هذا جعل من المثقّف حالة دعائيّة، يقدّم خطابًا يناسب المجموعات الحاكمة، يزيح المسؤوليّة عنها ويضعها على الناس، وعلى «التيّارات الدينيّة»، ويجعل من السّلطة -بالتالي- ضرورةً لإحداث التغيير، فالتّغيير لن يأتي -والحال هكذا- من هؤلاء المسلوبة والمُكبّلة عقولهم، مستخدمين مقاربات استعماريّة -استشراقيّة- سلطويّة تعتبر أن الناس غير جاهزين لأن يحكموا أنفسهم، غير ناضجين ديمقراطيًّا، أو غير ديمقراطيّين بنيويًّا، أو مرضى عقليّون يحتاجون للمعالجة.
احتقار المحليّة المُتخلّفة وتمجيد التقدّم «الغربيّ»: ما هو «المثقّف» في الاصطلاح العربيّ؟
المثقّفون الذين سأتناولهم هنا، والمعروفون اصطلاحيًّا، أو يُعرّفون أنفسهم، بهذه الكلمة، يشتقّون أنفسهم، والتّغيير الذي يُفترض أّنهم يمثّلونه، من الحداثة الأوروبيّة وتمظهراتها المختلفة، ويعرّفون أنفسهم عمومًا بالتّحصيل المعرفيّ الأوروبيّ الحداثيّ، وباستلهام متعدّد الأوجه لمفاهيم وأشكال ومؤسّسات الدول الأوروبيّة، والنقاشات الفكريّة التي تمّت وتتمّ فيها أو في محيطها، باعتبارها «تقدّمًا»، منذ الانبهار الأوّل -مطلع القرن العشرين- لروّاد «النّهضة» بما شاهدوه في دول الاستعمار من «حضارة» وعلومٍ وإدارة،[6] مرورًا بمثقّفي مرحلة التحرّر من الاستعمار الذين حافظوا على كلّ هياكل وأدوات الاستعمار (مؤسّسات «الدّولة»، الإدارة، الجيش، القوانين، التعليم والجامعات، المُتخيّل الموطنيّ/القوميّ) قائمةً وفعّالةً دون نقدها واستبدالها،[7] وصولًا إلى مثقّفي «مواجهة الإرهاب الإسلاميّ» بشعارات (لا بمحتوى) العلمانيّة والدّولة المدنيّة، وبالشّراكة مع السّلطة، اليوم.[8]
يُرفّع المثقّفون أنفسهم عن «محليّة مُتخلّفة» يغتربون عنها، ويستنكرونها بالمُجمل، ويصبّون جام غضبهم على التّعبير الثقافيّ الشعبيّ المحليّ الأبرز: «الدِّين»، و«الإسلام».
يُرفّع المثقّفون أنفسهم -بهذا التّحصيل- عن «محليّة مُتخلّفة» يغتربون عنها، ويستنكرونها بالمُجمل، ويصبّون جام غضبهم على التّعبير الثقافيّ الشعبيّ المحليّ الأبرز: «الدِّين»، و«الإسلام»، بعد تبسيطه ونزعه من سياقاته التاريخيّة والسياسيّة، واختزاله في نوعٍ واحد أو نوعين؛ مُتجنّبين بذلك السّلطة، ومبتعدين بهذا عن السّياسة (باعتبارها ممارسة ماديّة، تاريخيّة، مشتبكة مع الواقع وفيه، وتتجلّى بالاشتباك المباشر مع الفاعل السياسيّ الأوّل: السّلطة نفسها)، باتّجاه ما هو ثقافيّ، أو بشكل أدقّ: ثقافويّ، يجعل من التّغييرات الثقافيّة (الذهنيّة، المثاليّة) أساسًا لتغيير الواقع، بدلًا من تغيير علاقات القوّة، وتغيير الشكل الاقتصاديّ السياسيّ الاستغلاليّ الوظيفيّ التسلّطيّ التابع القائم، باعتبارها مدخلًا ماديًّا يُنتج (ضمن أشياء أخرى كثيرة) تغييرات ثقافيّة جذريّة.
إذًا، تضمّ شريحة «المثقّفين» -في الاصطلاح العربيّ-، حصرًا، من ينطبق عليهم هذا الوصف، وتتضمّن انتماءاتهم أو مرجعيّاتهم الفكريّة أو الأيديولوجيّة أو السياسيّة طيفًا واسعًا، تبدأ من الليبراليّة وصولًا إلى الماركسيّة مرورًا بالقوميّة، أمّا أصحاب المرجعيّات الفكريّة الإسلاميّة فهم مُستثنون من دخول الحلقة الحصريّة هذه، إلا إن قدّموا مراجعات «حداثيّة» أو «انفتاحيّة» أو «عصريّة» للدِّين، تؤهّلهم الدّخول إليها (مثلًا، لا يُعتبر أيّ من: أبي الأعلى المودودي، سيّد قطب، تقيّ الدين النّبهاني أو أبي محمّد المقدسي، «مُثقّفًا»؛ أمّا: علي عبد الرازق، محمد عبده، عبد الله العلايلي وخليل عبد الكريم، فمثقّفون مُكرّسون).
حيّز المثقّفين الإقصائيّ: نقد الدّين بديلًا عن نقد السّلطة
هنا، تمارس شريحة المثقّفين -معنويًّا- سلطةً سلبيّة، إقصائيّة، هي سلطة الاعتراف والتّكريس عبر بوابة الحداثة الأوروبيّة ومقولاتها، فتتشابه بذلك -إلى حدّ كبير- مع السّلطة السياسيّة التي تستند هي أيضًا إلى الإقصائيّة في المجال العامّ، وتمتلك المفاتيح الماديّة للاعتراف والتّكريس والتّوظيف (مثل وسائل الإعلام، وزارات الثقافة، التحكّم الأمنيّ في البعثات الدراسيّة وعضويّة الهيئات التدريسيّة في الجامعات، برامج النشر ودعم النشر والإنتاج، وإلحاق المؤسسات الثفافيّة «المستقلّة» -مثل روابط واتّحادات الكتّاب والفنّانين- عبر قوننتها وتمويلها أو التأثير الأمنيّ المباشر عليها، إلخ). لا يمكن، والحال هكذا، فهم الحيّز الثقافيّ العربيّ المُعاصر، حيّز المثقّفين، إلا باعتباره مساحةً إقصائيّة معنويّة تملكها شريحة المثقّفين، تميّز نفسها عن الحيّز العام، الشعبيّ، المُتخلّف، وتقع داخل الدّائرة الماديّة الأوسع للسّلطة ونشاطها التسلّطيّ و/أو الرّامي إلى السّيطرة السياسيّة والاجتماعيّة، والتي تميّز نفسها بدورها أيضًا عن الحيّز العامّ، الشعبيّ، موضوع تسلّطها.
لا يمكن اعتبار المثقّف في العالم العربيّ -إذ يُكِنّ احتقارًا لمجتمعه، وينظر إليه بدونيّة- مثقّفًا جماعيًّا، أو مجتمعيًّا، وفي ذات الوقت: لا يمكن للمثقّف أن يُشكّل علاقة عضويّة مع أيّ طبقة بعينها (إذ لم تتبلور تشكّلات طبقيّة -بالمعنى الماركسيّ- في المنطقة العربيّة، باستثناء السّلطة التي يحتاجها ولا تحتاجه -كما سنرى لاحقًا-، ويظلّ على هامشها متوسّلًا أو متسوّلًا)؛ لذا: نخلص إلى أنّ المثقّف ظاهرةٌ فرديّة، يشتقّ وجوده من نفسه، يعبّر عن منظوراتٍ ذاتيّة وخارجيّة (من خارج المجتمع، من خارج الاشتباك فيه ومعه)، ولن تجد أفكاره إمكانيّة للتحقّق على أرض الواقع إلا من خلال وسيط قادر؛ وفي غيابٍ واضحٍ للمجتمع والطبقة عن لعب دور هذا «الوسيط التاريخيّ»، واستنكافٍ للمثقّف عن توسيخ يديه في عمليّة تحوّل المجتمع (أو طبقة منه) إلى فاعل سياسيّ تاريخيّ، لا يبقى أمام المثقّف من أبوابٍ يطرقها ليشتقّ لنفسه ولأفكاره أهميّة ما، سوى باب السّلطة، فيُلحق نفسه بها، لعلّها -بذلك- تفتح له الباب.
بهذه المقاربات، يمكن فهم ظاهرة «المثقّفين» في سياق الثقافة العربيّة المُعاصرة بشكلٍ أعمق، ويمكن فهم استنكافهم -إجمالًا- عن نقد السّلطة، وتركّز جهودهم -في أغلبها- على نقد الدّين، مرتكزين -عمومًا- على فهم ثقافويّ جوهرانيّ استشراقيّ لاسياسيّ للظاهرة الدينيّة، مُشتقّين من ذلك حلولًا ومقاربات تحمل نفس الطابع: ثقافويّة، جوهرانيّة، دينيّة (كمفاهيم «التّنوير» و«العلمانيّة»)،[9] والأهمّ: أنّها محايدة تجاه السّلطة، بل تحتاجها (أو تتوسّلها) لتحقيق هذه المقاربات المُغترِبة (كما هو المثقّف مُغترب) عن المجتمع الذي تريد أن تُطَبَّق وتُفرَض عليه (بدلًا من أن تنبثق عنه). أما أدوات تنفيذ هذه المقاربات فتكون عادةً: القانون والتّعليم، وكلاهما يقعان في مجال السّيطرة الكاملة للسُّلطة، مما يجعلان من مشاريع المثقّف أسيرة أدوات السّلطة، ورضاها عنه وعنها.
اشتقاق المنزلة من الدِّين والاستعمار: المثقّف باعتباره مُخلّصًا حداثيًّا
تتطابق الفرديّة التي بُنيت عليها فكرة المثقّف مع الآمال الكبيرة التي حُمِّلت عليه (أو ألحقها بنفسه)، ومع هالة القداسة الحداثيّة الخلاصيّة التي بُنيت حوله (أو بناها حول نفسه)، والتي تبدو في حقيقتها امتدادًا لفكرة دينيّة: فكرة المُخلِّص الغائب، المهدي الذي يجب أن يعود ليدلّ الجموع التّائهة، الجاهلة، البلهاء، المُنتظِرة دومًا وأبدًا، إلى الطريق الصّحيح المؤديّ لفردوس «الحداثة» ونعيم «التقدّم»، وهي فكرة شبه دينيّة أخرى تفيد الديمومة والأبديّة، دفعت بفرانسيس فوكوياما إلى إعلان «نهاية التاريخ»[10] بتحقّق الاستقرار النهائيّ (بصيغة الرأسماليّة المُعولمة) إثر انهيار الاتحاد السوفييتيّ. وهي امتدادٌ أيضًا لمقام «الشّيخ»، مرجع المريدين، والمجتمع الأوسع، في جميع الشؤون، إذ يختزل في شخصه، ويُسبغ على نفسه، المعرفة الكليّة، هذا المقام الذي بحثه فيصل درّاج بتوسّع وعمق،[11] ووضعه في موقع التّعارض مع مقام «المثقّف الحديث»، وإن كنت أرى أن الصّفات التي يُسبغها الشيخ على نفسه (باعتباره «سلطة» و«مرجعيّة» شاملة)، تشبه -إلى حدّ بعيد- السّلطة والمرجعيّة التي يدّعيها المثقّف لنفسه، بعد أن يحلّ «التخصّص» مكان «الشّموليّة»، ويوتوبيا الغرب/المستقبل مكان يوتوبيا الإسلام/الماضي.
فهذا المُخلّص الحداثيّ المُختزَل في فكرة «المُثقّف»، يتضمّن داخله صفات العارف، المُتمكّن، القادر، العالم، الذي يملك «الهدف» ويعرف إلى أين يسير، وتختلط فيه سمات النبوّة بصفات الألوهة، وهو أمرٌ يستدعي فكرة أخرى شبيهة: «المثقّف» في السياق العربيّ هو أيضًا اشتقاقٌ من المستعمِر المتحضّر الفرد في مقابل الجموع المستعمَرة المتوحّشة، وامتدادٌ لمهمّة نبيلة مُتخيّلة قدّمها المستعمِر عن نفسه،[12] وصدّقتها نخبة المُستعمَرين مع تعديل بسيط: أزاحت المستعمِر الأبيض من عليائه، ووضعت نفسها مكانه، مع الانتباه إلى أن جلّ هذه النّخبة المثقّفة كانت قد تلقّت تعليمها في جامعات ومعاهد مدن المستعمِر ذاته، وتنظر إلى المستعمِر وإنجازاته السياسية والاقتصاديّة والعلميّة كنماذج ينبغي للمستعمَرين أن يسيروا على خُطاها.
يُعقّد كلّ هذا أنّ المثقّف-المخلّص هو فكرة خاصّة إلى حدّ كبير بالمستعمَرات السّابقة، لا نجد صنوًا لها في «الغرب»، لأنّ موضوع المثقّف-المخلّص هو الالتحاق الفوريّ بالحداثة، والحداثة في شمال العالم تمّت ابتداءً، ومن خلال صيرورة تاريخيّة، لا قفزة نوعيّة-خلاصيّة، لذا يأخذ المثقّف هناك شكلًا اصطلاحيًّا آخر: Intellectual، المشتغل بالتّفكير الذهنيّ، أو المُفكّر، وهي كلمة لها علاقة بالصيرورة والتحوّل والتغيّر، في النظر والتأمّل والبحث، داخل صيرورة تاريخيّة هي التي أنتجت التّغيير، بعكس كلمة «المثّقف» المتعلّقة أكثر بالتّحصيل، أو إيداع المعلومات والأفكار، والقادمة من «الثّقافة» باعتبارها مساحة عامّة شموليّة ترتبط بالوضع السّائد، والهويّة القائمة، والعناصر المحدّدة الثابتة المستقرّة التي تشكّل النسق الثقافيّ (كأن نقول: الثقافة العربيّة، الثقافة الإسلاميّة، الثقافة العربيّة الإسلاميّة، الثقاقة المصريّة، إلخ)؛ مساحة تخترعها السّلطة في أحيان كثيرة، وتخترع لها أنساقًا تاريخيّة تثبت بها أحقيّتها المُعاصرة.
لا يوجد مثقّف-مُخلّص في شمال العالم. بل يأخذ الـIntellectual في التصوّر الذاتيّ أو التصوّر العامّ هناك أشكالًا أخرى، فهو إمّا الدّارس المختصّ غير المعني كثيرًا بالتحوّلات الاجتماعيّة (وغالبًا ما يكون هذا أكاديميًّا معروفًا، ويطلق عليه إدوارد سعيد وصف «المثقّف المحترف»،[13] أي الذي يعتاش من إنتاجه الذهنيّ)، أو المتعالي النخبويّ المنظور إليه عمومًا بسلبيّة (بحسب رايموند ويليامز)،[14] أو المشارك في النّقاش العامّ والمُساهم في إثارة الجدل والنّقاش والمُعلّق على الأحداث السياسيّة (Public intellectual)، أو الممارس المُنخرط لأفكاره ضمن المجموع الأوسع في حزب أو نقابة أو حركة، أو المعبّر عن طبقة ما ومصالحها (المثقّف العضوي بحسب جرامشي).
من اقتراح التّغيير إلى الالتحاق بالسّلطة: إشكاليّات التصوّر الذاتيّ، الفرديّ، الخلاصيّ، للمثقّف
يولّد هذا التصوّر الذاتيّ، الفرديّ، الخلاصيّ، للـ«مثقّف» عدّة إشكاليّات أساسيّة:
أوّلها أنه يجعل من المثقّفين شريحة متوهّمة و«مستقلّة» بذاتها في «عالم الأفكار»، تُعرّف نفسها ذاتيًّا من خلال دور تدّعيه لنفسها يضعها فوق المجتمع، وبالتّالي فوق التّاريخ، مُلغيًا التّعارضات البينيّة التي تنشأ بين المصالح التي يمثّلها كلّ مثقّف، ويسلخها ماديًّا عن أيّة إمكانيّات حقيقيّة للتّغيير إذ يُصبح التّغيير مُتخيّلًا، مُتمنّيًا، مُقترحًا من خلال الأفكار الذاتيّة، دون الأخذ بعين الاعتبار القوى الاجتماعيّة التي يُفترض فيها تحقيق التصوّرات المطروحة، أو السّلطة التي تُعيقها أو تمنعها.
ثانيها أن المثقّفين، بتشكيلهم الشرائحيّ المُتوهَّم، وأفكارهم المثاليّة اللاتاريخيّة الواجبة التّطبيق، يشكّلون بديلًا عن الطبقات الفعليّة، المُضطهَدة، المُفقرة؛ وتتحوّل صراعاتهم الفكريّة، النظريّة، التي يخوضونها عادةً ضد تجريدات ذهنيّة (مثل «التخلّف»، أو «الدِّين»، أو «الإرهاب»)، إلى بديلٍ كاملٍ عن الصّراع الطبقيّ، فالخلاص الذهنيّ نظريّ، ويستكمل نفسه في عالم الأفكار، ولا يتشكّل في خضمّ الصّراع الماديّ، الفعليّ، داخل التّاريخ.
ثالثها أنّ هذه الشريحة المتوهّمة، بتصوّراتها الذاتيّة التي طرحناها سابقًا، تكرّس من نفسها «سلطة» معنويّة، فكريّة، استعلائيّة، مُغتربة، لكن دون أن يتمكّن أفرادها من التشكّل الماديّ إلا إن اعترفت بهم السّلطة الفعليّة: المجموعات الحاكمة وكياناتها الوظيفيّة. لذلك فهم يقضون جلّ وقتهم متمسّحين بالسّلطة، دائرين حولها، عارضين أفكارهم عليها، مخترعين لأنفسهم وظيفة ما داخلها، آملين أن تتبنّى السّلطة بعض صياغاتهم النظريّة الخلاصيّة لتطبيقها بقوّة الإكراه (من أعلى) لإحداث التّغيير المنشود.
لا يمكن فهم الحيّز الثقافيّ العربيّ المُعاصر، حيّز المثقّفين، إلا باعتباره مساحةً إقصائيّة معنويّة تملكها شريحة المثقّفين، تميّز نفسها عن الحيّز العام.
في سبيل هذا التّغيير، يتجاهل هؤلاء أربعة أمور؛ أن السّلطة غير معنيّة بالتّغيير، بل بالثّبات وإعادة إنتاج نفسها ووظيفيّتها داخليًّا وخارجيًّا، وهي تنتقي ممّا يعرضه المثقّف ما يناسب ذلك؛ أن السّلطة قويّة، تمتلك إمكانيّات السّيطرة وأُطرها، وبالتالي فهي القادرة على توظيف المثقّفين واشتقاق الشرعيّة لنفسها من خلالهم لا العكس؛ أن التّغيير المُتخيّل، الذهنيّ، غير المشتقّ من الواقع الماديّ وتناقضاته، لن يؤدّي إلّا إلى المزيد من التشوّهات المجتمعيّة، وحرف اتّجاه النّظر عن مكامن الخلل الفعليّة وآليّات التّغيير الفعّالة، فتستفيد بذلك السّلطة وحدها؛ وأخيرًا: أنّ المثقّف فرد، ضعيف، هشّ، ومتى ما وضع نفسه تحت تصرّف السّلطة (لأنّها الجهة الوحيدة القادرة على «تطبيق الأفكار») فسيسهل ابتزازه، وإن أراد المكانة (القادرة هي وحدها على إسباغها عليه) فسيضطر إلى إعادة إنتاج خطابه ليصير متوائمًا معها، فتنغلق الدّائرة التي بدأت باقتراح التّغيير النظريّ على السّلطة، إلى نقطة البداية الصّفريّة التي لم يحدث فيها أيّ تغيير، مُضافًا إليها طبقة تضليليّة جديدة، هي الشرعيّة التي أسبغها المثقّف على السلطة، بعد أن تخلّى بدوره عن أفكاره الأوليّة، بعد ثبوت عبثيّتها أو عبثيّة الطريق المُتخيّل للوصول إليها، وصار جزءًا من آليات السيطرة الاجتماعيّة للسلطة.
ولا تنجو أفضل وظائف مثل هذا النوع من المثقّف، من الوقوع في فخ الفردانيّة، والمثاليّة، والتوجّه للسّلطة، باعتبارها الإطار الوحيد القادر على التّغيير؛ فلندقّق فيما يقوله إدوارد سعيد كنموذج على هذا النوع من السّقوط في الفخّ: «وفي رأيي، إذن، أن الواجب الفكريّ الأساسيّ هو البحث عن تحرّر نسبيّ من هذه الضغوط [ضغوط المجتمع، والمؤسسات بمختلف أنواعها، والدولة]. ومن هنا كان تصويري للمثقّف كمنفيّ، وهامشيّ، وهاوٍ، وخالق لغة تحاول قول الحقّ للسّلطة.»[15] المثقّف هنا يريد أن يتحرّر من، لا أن يشتبك مع، المجتمع والمؤسسّات والسّلطة؛ أن ينفي نفسه خارج حركة التاريخ؛ ومن ذلك الموقع الخارجيّ، يخاطب السّلطة بالحقّ لعلّها تسمع كلامه.
هكذا، ستقود النّماذج الخلاصيّة المثاليّة صاحبها إلى الانتهازيّة: التقرّب من السّلطة بانتظار فرصة سانحة لتتبّناه وتتبنّى أفكاره (كما يظنّ) تكون نتيجتها الفعليّة (بسبب أنّ القوّة الفعليّة بيد السّلطة، لا بيده) هي الاحتواء والتّوظيف.
مثاليّة المثقّف وماديّة الدّاعية: في الفرق بين الرّهان على السّلطة والرّهان على الجُموع
ربّما كان الجيل الأوّل من «التنويريّين» في ما يُسمّى بـ«عصر النّهضة» خير دليل على ذلك التوجّه، فكثير منهم (كطه حسين، العلامة الأبرز والأهمّ لذلك الجيل، و«أكثر العقول جذريّة» بينهم، بحسب فيصل درّاج)[16] وضع رهانه على تغيير تقوده السُّلطة (سواء بالتّعليم، أو التّصنيع، أو التّحديث)، وكانوا جزءًا منها عبر تولّيهم مواقع قياديّة أو وزاريّة فيها، (تولّى طه حسين وزارة المعارف على سبيل المثال)،[17] وكانت بعضٌ من نتاجاتهم الفكريّة تتوجّه للسّلطة على شكل نصائح، أو إرشادات، أو تمنّيات، أو كتبًا تقدّم نفسها باعتبارها دليل استرشاد للوصول إلى نتيجة مرجوّة (كتاب طه حسين: مستقبل الثقافة في مصر)؛[18] أمّا نتيجة ذلك فواضحة فيما نحن فيه اليوم.
يحيلنا هذا الرّهان إلى الفرق (والشّبه) بين المثقّف والدّاعية: فبينما يشتقّ المثقّف نفسه ودوره من الحداثة (التي لم تتحقّق)، والمستعمِر (الذي ظلّ، حتى بعد التحرّر الشكليّ منه، متفوّقًا، ونموذجًا مكرّسًا للّحاق به وبركب حضارته)، والذاتيّ، ومستقبلٍ مُتخيَّل، يشتقّ الداعيّة نفسه من الرّاسخ الثقافيّ، والمحليّ، والموضوعيّ، وواقعٍ فعليّ؛ وبينما يتوجّه المثقّف أساسًا إلى السّلطة ويتوسّلها، دافعًا نفسه إلى دورٍ وظيفيّ، يتوجّه الدّاعية إلى الناس، دافعًا نفسه إلى دور شعبيّ، عُضويّ؛ وبينما يتوجّه المثقّف عادةً إلى السّلطة بغرض توظيفه إذ يحتاجها هو، تتحرّك السّلطة عادةً باتّجاه الدّاعية لنفس الغرض إذ تحتاجه هي، فيملك بذلك قوّة أكبر في مفاوضتها وتوسيع مساحة حركته باستقلاليّة عنها.
نقطة الشّبه الوحيدة أنّ كليهما يُحيلان «التّغيير» إلى تجريدٍ ذهنيّ فردوسيّ مستقبليّ، يفترقان فيه وفي آليّات تحقيقه مرّة أخرى: فالمثقّف نبيّ، فرد، وحيد، ينتظر جماعة مؤمنين تلتحق به وتناضل من أجل أفكاره، أو سلطة تُنفِّذ له رؤاه، أما الدّاعية فجزء من بُنية حركيّة مُتحرّكة مُتفاعلة وفاعلة، هي الجماعة، أو الحزب، تتفاعل مع المجتمع عن طريق التماسّ المباشر بمبادرةٍ منه، ويدفع معها لتحقيق رؤاه التي هي رؤى المجموعة التي ينتمي إليها.
كلّ هذا يجعل من مفهوم «المثقّف»، والجدل الكبير الذي دار ويدور حوله في السياق العربيّ، عقيمًا، وبلا معنى، طالما ظلّ عالم أفكاره ذاتيًّا، ومساحة فعله الذّهن المنفصل عن الاشتباك بالواقع، مُنتجًا في خضمّ ذلك عوالم بدائليّة (إحلال واقعٍ بديل مُتخيّل بدلًا من الواقع الحاليّ، على شكل انقلابٍ حُلُميّ ننام فيه على حال، ونستيقظ على حالٍ آخر) بدلًا من العمل على الاشتغالات الجدليّة (تغيير الواقع الحاليّ من خلال الاشتباك معه موضوعيًّا وبأدوات مُشتقّة منه)، وطالما ظلّت مساحة تحقّق أفكاره المَأمولة (المتوهّمة) قائمةٌ على السّلطة باستبدالٍ تحتيّ (من أعلى، يُطيح بأسفل «متخلّف» أو «رجعيّ») بدلًا من تغيير فوقيّ (من أسفل، يُطيح بأعلى فاسد وقمعي وإقصائيّ ووظيفيّ وتابع).
المُثقّف المتسوّل من السُّلطة، والمُفكّر المُمارس السّاعي إلى تقويضها
كلّ هذا يجعلنى أرى تعارضًا بين الدلالات التي تحتويها كلمة «المثقّف»، وبين ما سأسميّه: المُفكّر المُمارس، على ذات النّسق الذي قدّمته الماركسيّة لإزالة الاغتراب والذاتيّة عن عالم الأفكار، عبر دفعها للاقتران بالممارسة، في اشتباك لا غنى لأحدهما عن الآخر.
فالأفكار دون الممارسة تتكلّس عبر تحوّلها إلى مقولات لذاتها، تجترّ ذاتها لتثبت نفسها بنفسها، أو تتضخّم لتبني أوهامًا نظريّة إضافيّة فوق مقولاتها الذاتيّة المثاليّة (اللّاماديّة)، أو تختزل نفسها في شعارات للاستهلاك العامّ السّريع. أمّا الممارسة دون الأفكار فتصبح مُتاحةً للحَرف والاستغلال والتّوظيف، تصبح غير منتجةٍ لنفسها وممكنة الإنتاج لغيرها (أو حتّى لنقائضها)، والمثال الأوضح على ذلك هو الجولة الأولى من الانتفاضات العربيّة (2010- 2013) ومآلاتها.
بحسب هنري لوفيڤر، لا يمكن الفصل بين التفكير الثوريّ والممارسة الثوريّة، فهما ينبثقان عن بعضهما في «جدليّة المُعاش والمُدرَك». صحيحٌ «أن التفكير والفعل ليسا مُتماثلين»، يقول لوفيڤر، «إلا أن عليهما دومًا العودة لبعضهما لتجديد نفسيهما». هذا فضلًا عن أن «نظريّة أيّ حركة، يجب أن تنبثق عن الحركة نفسها، لأن الحركة هي التي كشفت، وأطلقت، وحرّرت، الإمكانيّات النظريّة».[19] علاقة المفكّر المُمارس مع العالم، إذًا، هي علاقة نقد واستنطاق وتحليل، لا تكتمل إلّا من خلال اشتباكه المباشر، الفعليّ، العمليّ، الماديّ، مع الموضوع المُفكَّر فيه، ليتم اختبار هذه الأفكار وتطويرها (وتغييرها) في خضمّ هذا الاشتباك.
والمفكّر الممارس هو شخصٌ يتعلّم ويستمرّ في التعلّم بشكل دائم، لا يُقدّم المقولات بل المقترحات المعرفيّة، متفاعلًا مع محيطه ومجتمعه، ومُستفيدًا من التطوّرات المُتسارعة في حقول العلوم في قراءة هذا المُحيط، وهو نقديّ في مواجهة السّلطة وبُناها وأُطرها المختلفة، فالسّلطة جمود والتّفكير حركة، السّلطة قمع والتفكير حريّة، السّلطة تكبيل والتّفكير إطلاق، السّلطة رتابة والتّفكير تخييل، وهو معادٍ للدوغمائيّة والأفكار الرّاسخة كمقولات جامعة مانعة لاتاريخيّة، فهو نقديّ أيضًا فيما يخصّ التواضعات الاجتماعيّة والسياسيّة والبديهيّات، وهو مشتبكٌ مع اليوميّ وفيه، متّسق مع ذاته دون انفصام بين عالم الأفكار وعالم تطبيقاتها. لا يبحث المفكّر الممارس عن مريدين، بل يبحث عن مُتفاعلين، مُناقشين، وهو لا «يقود الجموع» بل يُساهم في تمليك الفئات المضطهَدة الوعي بذاتها، واقتراح الأدوات عليها، من واقع حركتها، لتقود هي التّغيير بنفسها، فهي صاحبة المصلحة الأولى بالتّغيير، لا هو.
ثمّة لمحاتٌ عن مثل هذه المقاربة قد تتوفّر في مهدي عامل، غالب هلسا، غسان كنفاني ومنيف الرزاز، لكنّها لا تشكّل كلًّا شموليًّا في أحدهم.
في أركان المفكّر المُمارس: الصّدق، اتّساق الذات مع المقولات، التضادّ مع السُّلطة
حتى يمكن للمفكّر المُمارس أن يتخذ شكل الوجود الموضوعيّ، ثمّة أركان أساسيّة عليها أن تتحقّق فيه ليكون جزءًا من حركة التاريخ (السّعي الفعّال من أجل التحرّر والتّغيير) لا عبئًا عليه. أوّل هذه الأركان هي الصّدق، والصّدق (بحسب جرامشي): «هو فعل ثوريّ»،[20] فلا يناور المفكّر الممارس حول مقولاته، ولا يقدّمها بصياغات «مخفّفة» تستبطن منزلة عليا يُسبغها على نفسه مقابل «غباء» أو عدم جهوزيّة أو «بدائيّة» العامّة، فالعكس هو الصحيح كما هو ثابت في الانتفاضات العربيّة المتتالية التي تفوّقت حركيًّا وفكريّا على المثقّف نفسه بنقدها الشّديد للسّلطة، وتعلّمها من عثراتها وأخطائها، ومناوأتها لأشكال التّفتيت والتوظيف الطائفيّة والدينيّة، وإصرارها على «تغيير النظّام» ورحيل ومحاسبة «الجميع» من شركاء المجموعات الحاكمة. صحيح أن بعض المجموعات الحاكمة أو بعض عناصرها (بدعم من رعاتها، أو تدخّل من مناوئيها، الإقليميين والخارجيّين) قد نجحت بالتأثير في مسار الأحداث وقلبه رأسًا على عقب (كما حصل في سوريّة وليبيا واليمن مثلًا)، لكن خط الوعي العامّ التصاعديّ في كل الانتفاضات كان واحدًا: الحديث -بشكل أو بآخر- عن تصفية المجموعات الحاكمة تمامًا ومحاسبتها (السّودان، الجزائر، لبنان، العراق)، وطلب الانتقال من حالة كيان وظيفيّ تتسلّط عليه مجموعة حاكمة فاسدة وتابعة، إلى حالة «دولة حقيقيّة» تتشكل من مواطنين يتشاركون في الحكم، عبر مؤسسات مدنيّة مستقلّة وذات سيادة، تُحقق شكلًا من العدالة الاجتماعيّة.
تظلّ هذه المطالب الجماهيريّة حالمةً وطوباويّةً في ظلّ إغفالٍ الدّور الفاعل الذي يلعبه النّظام الاقتصادي الرأسماليّ العالميّ، وإغفال دور القوى الدوليّة والإقليميّة والمحليّة التي تتدخّل في الانتفاضات الشعبيّة بشتى الوسائل، وانعدامٍ لوجود تنظيمات متماسكة تنقل -بآليات فعليّة- مقولاتها من حيّز المطالبة إلى حيّز التحقّق السياسي، لكن هذه المطالب، ونطاق التحرّكات التي تعبّر عنها، تجاوزت جذريًّا، وبمراحل عديدة، نطاق مطالب المثقّف وحركته؛ وفي حين عبّر الشّارع المُنتفض عن موقف حاسم وحازم من السّلطة، يبغي إسقاطها برمّتها، بما في ذلك شركاءها والمتعاونين معها، وجد المثقّف -الذي راهن طويلًا على السّلطة باعتبارها رافعة التّغيير الأساسيّة، ومنفّذة مشاريعه المقترحة التي يتسلّق من خلالها هو إلى موقع ما فيها- نفسه مُهدَّدًا، لا بفقدان المكانة المتخيّلة التي عمل طويلًا على توسّلها من السّلطة فحسب، بل وجد نفسه مُتّهمًا (بحقّ) في إدامة عمر السّلطة وعسفها، وجزءًا من الكلّ الذي ينبغي الإطاحة به ليحدث التّغيير.
أنطونيو جرامشي وأدوار «المثقّف» المتعدّدة
لهذا يبدو -ظاهريًّا على الأقل-، أن عمل المثقّفين في سياق التاريخ العربيّ المعاصر، وبالنّظر إلى مآلات الانتفاضات العربيّة وتحوّلاتها، كانت نتيجته الفعلية ترسيخ السّلطة وتقوية موقفها، من خلال عدم مساهمتهم في بناء البدائل الفكريّة الماديّة، وعدم مشاركتهم في خلق التنظيمات والفعل التنظيميّ وبناء الائتلافات الاجتماعيّة، وعدم انخراطهم في التّغيير والاشتباك مع السّلطة على الأرض بما يؤدّي إلى إنتاج وإنضاج البدائل والتّنظيمات والائتلافات من خلال الممارسة نفسها، وعدم عملهم على رفع المستوى الفكريّ والنقديّ لأكبر شريحة من الناس، واقتصار نشاطهم على الحدود النخبويّة التي تسمح بها وترعاها السّلطة، وإبقاء النقاش الفكريّ والنظريّ خارج متناول العامّة، وخارج الممارسة.
هذه المهمّات المركزّيّة لنجاح التّغيير، يضعها أنطونيو جرامشي، الذي كتب كثيرًا عن المثقّفين، في صلب المهمّات المنوطة بهم، فمن حيث بناء التنظيمات السياسيّة التّي تقدر على العبور من حالة اللّاتحديد العامّة، الحالة الهُلاميّة، للجُموع، إلى الحالة المُشخّصة، الشخصيّة، السياسيّة لها، يقول جرامشي:
«إن كتلةً بشريّة ما لا تُميّز نفسها، ولا تصبح مُستقلّة، ’بنفسها‘؛ [كما أنّها لا تصبح مستقلّة] دون أن تُنظِّم نفسها (بالمفهوم الواسع للكلمة)؛ ولا يوجد فعل تنظيميّ دون مُثقّفين، أي: دون مُنظِّمين وقادة، ودون الجانب النظريّ من ثنائيّة نظريّة – ممارسة».[21]
أمّا من حيث التّركيز على أهميّة كسر احتكار المعرفة النقديّة، واقتصارها فقط على مجموعة المثقّفين، وتمكين أكبر عدد ممكن من النّاس منها، فيؤكّد جرامشي أنّ «على كل حركة تريد أن تُغيّر المفاهيم المستقرّة عن العالم (…) أن تعمل بشكل متواصل لرفع المستوى الفكريّ لشريحة لا تني تتوسّع، أي: إعطاء وجود شخصيّ (personality) لتلك الكتلة التي بلا شكل، والتي هي جموع النّاس».[22] هذا التحوّل في نظر العامّة إلى الفلسفة من «اعتبارها إيمانًا»[23] إلى كونها «التاريخ مُمَارسًا (history in action)؛ إلى الحياة بذاتها»[24] سيؤدّي –بنظر جرامشي- إلى أن يتغيّر «فعليًّا المشهد الأيديولوجيّ للعصر».[25]
أمّا من حيث التحضير النظريّ المُسبق، فيمكن استنتاجه من جرامشي وإرثه في سياق آخر شبيه: «الدرس من السّنتين الحمراوين [في إيطاليا، 1919 و1920 اللّتان حصلت فيهما التحرّكات الثوريّة للعمّال في تورين، وفشلت] هو أنّه كان على القوّة الثوريّة أن تكون موجودة قبل تلك اللحظة».[26] لكن هذا التحضير النظريّ لا يكمن في اجترار مقولات قاطعة أو خلاصيّة، بل هو تحضير في التاريخ، يشتبك مع السلطة وتجلّياتها، ويتشكّل ويطوّر نفسه من خلال هذه الاشتباك الذي يمكّنه من «اختبار تصوّراته»[27] من خلال الفعل نفسه.
يطرح جرامشي مفهوم «المثقّف العضوي»، أي المثقّف الذي يُعبّر عن مصالح طبقةٍ بعينها، ويصوغ لها مفاهيمها التي تُعطيها «شخصيّتها» التاريخيّة، أي معالم وجودها الفاعل في التاريخ، ويُساهم في تحوّلها إلى «كتلة». في سياق التحوّلات السياسيّة والاجتماعيّة العربيّة، لن نجد مثل هذا المثقّف العضويّ لسبب أساسيّ: انعدام وجود طبقات سياسيّة-اجتماعيّة بالمعنى الذي وجدت عليه في البلدان الصّناعيّة في أوروبّا مطلع القرن العشرين. وإذ ينبثق مثقّفو العالم العربيّ من طبقة وسطى هلاميّة ومتغيّرة وغير محدّدة المعالم، فهم يحملون معهم، ويستبطنون فيهم، مصالحها، ومحدّداتها، ومخاوفها، وانتهازيّتها، وميلها إلى «الاستقرار» والحفاظ على الوضع القائم كما هو، وارتباطها بالسّلطة، ورُعبها من التّغيير؛ أمّا القلّة من المثقّفين الصّاعدين من الطبقات المسحوقة والهوامش، فجلّ اهتمامهم ينصبّ على قبولهم في «مجموعة المثقّفين» الحصريّة، لهذا فعليهم أوّلًا أن يستنكروا «تخلّف» الطبقات التي قَدِموا منها، ويتبنّوا خطاب ونسق ومظاهر الطبقة الوسطى التي يريدون الانخراط فيها، ويرغبون بأن تقبلهم في مصافّها. ويعقّد انسلاخهم الطبقيّ، ويسهّله في آن، تكريس المقولة الليبراليّة/الرأسماليّة التي تنظر بوضاعة إلى العمل اليدويّ، وتضعه في منزلة دنيا في مقابل المنزلة الرّفيعة التي يحوزها العمل الذهنيّ، فيرفّع مُثقّف الطبقات المسحوقة نفسه من هذا الباب، لينسلخ طبقيًّا بالاتّجاه المُعاكس، ويفاقم من تفريغ طبقته من إمكانيّاتها الثوريّة.
سينطبق على المثقّفين العرب، إذًا، دور آخر يصفه جرامشي بكونه «ضباط شرطة الطّبقة الحاكمة»، الموكولة إليهم تنفيذ مهمّات الهيمنة الاجتماعيّة، والمتعلّقة باختلاق بداهةٍ تتعلّق بـ«الموافقة التلقائيّة لجموع الناس على التوجّه الذي تطبعه الطبقة الحاكمة على الحياة الاجتماعيّة»، وترويج «أدوات الإكراه التي تستخدمها الدّولة، والتي تضمن –’قانونيًّا‘- تأديب المجموعات التي لا ’توافق‘».[28]
إن استبدلنا بـ«الهيمنة» مفهوم «السيطرة»، ستنسجم الوظيفة أكثر مع الاستعارة التي استخدمها جرامشي، فمثّقفو العالم العربي لا ينتجون أيديولوجيا لـ«الدولة» وطبقتها الحاكمة، لتمكينها من بسط هيمنتها على النّاس والمجتمع المدنيّ (بالمفهوم الجرامشيّ)، إذ لا «دولة» ولا «طبقة حاكمة» ولا «نظام» في العالم العربيّ منذ ما بعد الاستعمار، ما يوجد هو كيانات وظيفيّة تتسلّط عليها مجموعات حاكمة تتقلّب وتتغيّر مصالحها باستمرار مع تغيّر التوازنات المحليّة والإقليمية والدوليّة، لذا، يشكّل المثقّفون أبواق الدّعاية والتّبرير للبهلوانيّات السياسيّة التي تؤدّيها المجموعات الحاكمة على حبال تلك التوازنات، أو للقرارات النزقيّة التي تتخذها على الصعيد الداخليّ (في ظلّ انعدام وجود مؤسّسات حكم فعليّة).
وفوق هذا، يلعبُ المثقّفون دور الكابح، واللّاجم، في مواجهة المفكّرين الممارسين وأفكارهم النقديّة، التي يُسحب عنها الغطاء أمام الإجماع البديهيّ الذي يُسبَغ على السّلطة ومقولاتها، لتتحوّل إلى مجرّد أفكارٍ «إشكاليّة» و«جدليّة» يتم تجاهلها والتّعتيم عليها في أحسن الأحوال، و«تخريبيّة» تستدعي العقاب في أسوئها، ويمارس المثقّفون حريّة انتقائيّة على مقاس السّلطة، فيُدان بشدّة القمع الذي تمارسه الأفكار الدينيّة أو تنظيماتها دون أن يُدان القمع الذي تمارسه السُّلطة؛ أو -من جهة أخرى، نقيضة- يُدان ما قد يعتبر «تحرّرًا زائدًا» يُحرج السّلطة أمام مجتمع ما يزال محافظًا في أغلبه.[29]
لا وجود لـ«غير المثقّفين»، والثورة يمكن أن تنطلق من أيّ نقطة
«كلّ الناسِ ’مثقّفون‘» يقول جرامشي، «لكنّهم لا يؤدّون وظيفة طبقة المثقّفين (…) وبنفس المعنى، لا يمكن الحديث عن طبقة مثقّفين مقابل ’غير المثقّفين‘، فلا وجود لهذه المجموعة الاخيرة».[30] يلتقي جرامشي هنا مع ماركس المتأخّر، المتأثّر بكُمْيُونَة باريس، إذ تلاحظ رايا دونايفسكايا على إنتاجه الفكريّ ما يلي: «لم يعد يخوض نقاشاته مع ريكاردو أو سمِث، مع المنظّرين، سواءً أكانوا برجوازيّين أم اشتراكيّين؛ تحوّله من تاريخ النظريّات إلى تاريخ الصّراع الطبقيّ في نقاط الإنتاج صار هو النظريّة، وبهذا فهو يبتعد عن مفهومٍ يعتبر النظريّة نقاشًا بين المنظّرين، ويبتعد عن فكرة أن ذلك التاريخ [تاريخ الأفكار] هو المهمّ، ويسير باتجاه مفهومٍ يقدّم النظريّة باعتبارها تاريخًا لعلاقات الإنتاج»،[31] أي، بعبارة أخرى، باعتبارها تاريخًا للفعل، أو: أن الفعل هو التاريخ.
كما يلتقي جرامشي مع المفكّرين المُمارسين لكُمْيُونَة باريس، والذين مارسوا المعرفة باعتبارها اشتباكًا مع، وانبثاقًا عن، العمل في الواقع. تقول كرِسْتِن روسّ:
«أوضحت كُمْيُونَة باريس (…) أن الصراع السياسيّ نفسه يخلق شروطًا جديدة، يعدّل العلاقات الاجتماعيّة، يغيّر المشاركين في الحدث والطريقة التي يفكّرون ويتحدّثون بها، الصراع نفسه يخلق أشكالًا سياسيّة جديدة، طرق وجود جديدة، ومفاهيم نظريّة جديدة لهذه الطرق والأشكال. جدليّة المُعاش والمُدرَك -ما سمّاه عدد من الكُمْيُونِيّون المستقبليّون في نصّ لهم كتب عام 1871: الاختراق التبادليّ للفعل والفكرة- هو جدلٌ [دياليكتيك] حقيقيّ، بحيث لايمكن التفكير في شيءٍ حقًّا قبل أن يخرج شيءٌ آخر إلى الوجود».[32]
في موقفهم من الفعل والفكرة، استلهم الكُمْيُونِيّون عبارة جوزيف جاكوتو: «كلّ شيء موجود في كلّ شيء».[33] كلّ المعارف محتواةٌ في كل شيء، عبر ترابطات كلّ شيء مع كلّ شيء آخر، وبالتالي لا تهمّ نقطة الانطلاق، إذ «يمكنك أن تبدأ من أيّ مكان» بحسب جاكوتو،[34] لأنّ أي نقطة انطلاق ستقود إلى كلّ شيء، وهذا هو بالضبط حال العالم المعاصر الذي تتشابك فيه كلّ القضايا، ولا يمكن التعامل مع واحدةٍ منها دون التعامل معها جميعًا، ومع جذرها المولّد للأزمات وانعدام العدالة: الرأسماليّة.
كان هذا هو الردّ الواضح من «العامّة» الذين أثبتوا أنّهم يعرفون أكثر بكثير من المثقّفين، حين نزلوا إلى الشوارع بالفعل، مطالبين بـ«إسقاط النظام»، محاولين اشتقاق «نظام جديد»، خالقين –في خضمّ ذلك- «أزمة النّفوذ» (crisis of authority) التي عرّفها جرامشي هكذا: «القديم يحتضر، والجديد لا يمكن له أن يولد؛ في فترة الخلوّ هذه، تظهر أشكال هائلة من الأعراض المرضيّة الفظيعة»،[35] كاشفين بذلك عورة المثقّفين الذين طفقوا يتجادلون عن «كارثة» فشلهم في التنبّؤ بالتحرّكات الشعبيّة العربيّة الأخيرة، قبل أن ينحاز أغلبهم بعدها للسّلطة في مواجهة «الفوضى» و«الغوغاء». تلك هي النتيجة المنطقيّة الوحيدة لصيروة المثقّف الذي مازال –حتّى اليوم- يبحث عن «التقدّم» في حداثة تجاوزها أصحابها إلى ما بعدها، وعن الاعتراف عند قدمي سلطة زاد تسلّطها وقمعها ولا تكترث به إلا بمقدار ما توظّفه من أجل بقائها وسيطرتها.
المفكّر الممارس كنقيض للمثّقف: في مواجهة الحداثة وجذرها الأعمق، الرأسماليّ
إن كان ثمّة دورٌ للمثقّف «الثوريّ» في بدايات صعود الرأسماليّة المعاصرة، باعتباره نبيًّا ناطقًا باسم الحداثة، يفكّ للعامّة (الأميّين في مجملهم) مغاليق النصّ المكتوب، ويوعّي الجماهير «الجاهلة» ويدفعها (عن قصد أو دون قصد) للانخراط في التبعيّة للنظام الاقتصاديّ العالميّ الجديد حينها، فإن انتشار الراديو، ومن ثمّ التّعليم، ليليه التّلفاز، وبعدها الإنترنت والهاتف الذكيّ ووسائل «التواصل الاجتماعي» (وهي تقع بمجملها تحت سيطرة السّلطة والنظام الرأسمالي، وتشكّل بمجموعها أدواته الأساسيّة للسيطرة والهيمنة والتطويع وتشكيل الأنماط السلوكيّة ومعرفة وتوجيه الجمهور)، قد قلّلت كثيرًا من أهميّة هذا الدّور وذاك الامتياز، فسقطت عن المثقّف هالة التميّز التي أحاطت به في مرحلةٍ سابقة، وصار –عمومًا- محلًّا للتندّر والتهكّم والاستهزاء.
هذه التغيّرات تجعل للمفكّر الممارس اليوم دورًا لا علاقة له بالتّوعية (التي تُحيل مباشرة إلى المنزلة والسّلطة والاغتراب الذاتي عن عامّة النّاس)، بل بالمواجهة والنقد والإبداع: مواجهة السّلطة وإفرازاتها وآليّات عملها، وبالتالي مواجهة الجمهور، أو –لنكون أكثر دقة- مواجهة كسل الجمهور وارتخائه واستسلامه لمخدّرات التّسلية والاستهلاك، أفيون الشّعوب المعاصرة؛ ونقد الحداثة التي صُوّرت لأكثر من قرن من الزّمن على أنها طريق الخلاص، لنكتشف متأخّرين أنها طريق الانخراط في التبعيّة للاقتصاد الرأسمالي العالميّ والفخّ الذي دُمّرت فيه اقتصادات الاكتفاء الذاتي لصالح أشكال «النموّ» التي تعتمد على تقسيم العمل العالميّ وإغراق المستعمرات السابقة (بعد أن نهبها المُستعمِرون وأفقروها وتركوها في ذمة مجموعات حاكمة تابعة وفاسدة) بالدَّيْن لصالح المُستعمِرين ذاتهم؛ وإبداع أشكال جديدة للوجود البشريّ القائم على العدالة والمساواة واحترام الطبيعة، من داخل الاشتباك اليوميّ مع الوضع القائم.
المفكّر المُمارس هو مغادرة كاملة ونهائيّة وحاسمة لمفهوم «المثقّف»، هو التحوّل من النبيّ المُبشّر بخلاص الإنسانيّة عبر الحداثة وتطويع الطبيعة، إلى مواجهة هذه «الحداثة» وجذرها الأعمق، الرأسماليّ، وآثارهما الكارثيّة المتمثّلة في ابتلاع الثّقافة وتحويلها (ضمن أشياء كثيرة أخرى)، عبر خطوط الإنتاج والتّسليع، إلى تسلية مخدّرة، وآلية لترويج وتعميق نفاذ أشكال الاستهلاك وتشكيل البشر وغسل عقولهم لصالح مزيد ومزيد من الشّراء الذي يزيد أرباح الرأسماليين، ويسحب ما دفعوه من أجور بائسة لمأجوريهم، لتعود الأموال إلى جيوبهم ثانية، فيُعاد إنتاج دورة الاستغلال من جديد.
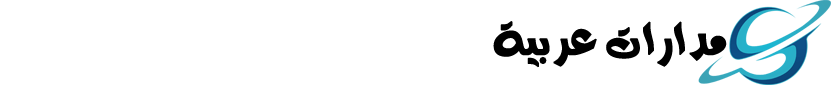


التعليقات مغلقة.