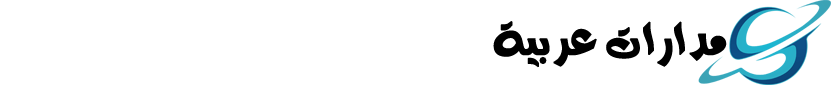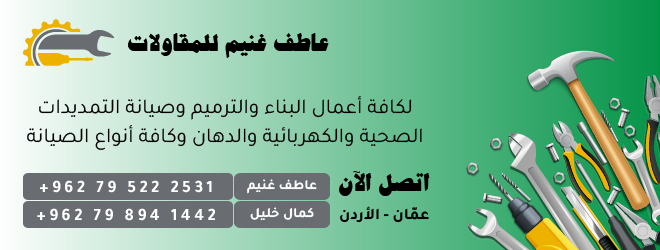مُوجَز نظرية القيمة في كتاب رأس المال – كارل ماركس/ الطاهر المعز

نُشِرَ كتاب “رأس المال” لكارل ماركس ( 1818 – 1883) قبل أكثر من قرْن ونصف، ومع ذلك لا يزال التحليل الاقتصادي العميق والدقيق للرأسمالية الذي صَقَلَهُ من أهمّ مراجع الإقتصاد السياسي سواء للّيبراليين أو للإشتراكيّين، ومن الكُتُب والأفكار التي تُثِير نقاشًا واسعًا، إلى جانب أُطْرُوحات أقطاب الإقتصاد الرأسمالي آدم سميث ( بريطانيا 1723 – 1790 ) أو دفيد ريكاردو ( بريطانيا 1772 – 1823) أو جون مينارد كينز ( 1883 – 1946 )…
يتميّز كتاب رأس المال والتّحليل الإقتصادي الماركسي بدراسة الرأسمالية كشكل من تنظيم الإنتاج، في سياقها التاريخي، ويعتبر الرأسمالية ثورية مُقارنة بالإقطاع، فقد مكّن تنظيم عملية الإنتاج الرأسمالي من زيادة إنتاجية العمل، لكن هذه الزيادة كانت بفضل تنظيم وترشيد الإستغلال، ولم تُؤَدّ إلى تحسين وضع الطّبقة العاملة بل إلى زيادة أرباح الرأسماليين وتكديس الثروات ولم تهدف أبدًا إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية، ويؤدّي هذا التناقض بين الإنتاج الإجتماعي ( لقوة العمل) واحتكار الأرباح ( من قبل الرأسماليين) والنّزعة إلى توليد المزيد من المال وتحويل قوة العمل إلى سلعة، إلى أزمات دَوْرِيّة، أو هيكلية…
نقد كارل ماركس نظرية اليد الخفية للسوق لدى آدم سميث و نظرية القيمة لدى دفيد ريكاردو كما نقَد تحويل قوة العمل إلى سلعة وتوليد المزيد من المال من خلال استثمار المال، وهو ما سمّاه “القيمة تُولّد قيمةً أخرى” وهو جوهر منطق رأس المال الذي يعتمد على عُنْصُرَيْن: رأس المال و العَمل…
من جهة أخرى يتسم الإقتصاد الرأسمالي بحدّة المنافسة وباعتماد الرأسماليين على المصارف التي تُقرضهم ( ظاهرة الإئتمان) أموالا للإستثمار…
*****
كانت السوق تُمثل تبادل السّلع بين المنتجين، حيث يُبادِلُ المنتجون إنتاجهم بسلع أخرى يحتاجونها، وهي من إنتاج غيرهم، شرط تقارب قيمة السّلع المُتبادَلَة، وتعتمد هذه القيمة على مقدار العمل المبذول في إنتاج السلع، وتتمثل إضافة كارل ماركس في إدراج “مفهوم العمل الضروري اجتماعيًا”، ومراعاة تكنولوجيا الإنتاج و كمية العمل اللازمة للإنتاج، وهذا مرتبط بالسياق الإجتماعي والتكنولوجيا المتاحة وكثافة العمل، وخصّص كارل ماركس جزء هامّا من المجلّد الثالث لكتاب رأس المال لنشوء وأهمية فائض القيمة في عملية تراكم رأس المال، ضمن سياق تاريخي ( المادّية التّاريخيّة، أو المفهوم المادي للتّاريخ ) حيث نَشأت الرأسمالية ونَمت كنظام اجتماعي يسمح باستيلاء طبقة على جهد عمل طبقة أخرى، أي أن الإستغلال يُشكّل ركيزة أساسية للنظام الرّأسمالي، وإن كان الإستغلال في حدّ ذاته أَقْدَم من الرأسمالية، غير إن الرأسمالية غَلّفت الإستغلال ب”حُرّيّة التّعاقد” أي إن العامل ليس مُجْبَرًا ( من الناحية النّظرية البَحْتَة) على العمل لدى الرأسمالي، فهو “حُرّ قُبول أو رفض الأجْر وشروط العمل”، وفي الواقع فإن الطبقة العاملة مُضطرّة لبَيْع قُوّة عَمَلِها للرأسماليّين مقابل أجر، ويستخدم الرأسمالي جُهْد العامل لإنتاج سلعة يبيعها الرأسمالي في السوق بقيمة تفوق بكثير تكلفة إنتاجها ( المواد الأولية وأجْر العامل وتآكل الآلة…) وهو بذلك يستحوذ على القيمة الزائدة أو التي أضافها العامل للمواد الخام لتصبح سلعة قابلة للإستهلاك والتّسويق، ويُسمِّي ماركس ذلك “فائض القيمة” الذي يُميّز نظام التبادل القائم على السوق، حيث تستولي طبقة الرأسماليين على فائض القيمة الناتج عن استغلال الطبقة العاملة، ويتمثل الإستغلال في اانتزاع الرأسمالية جزءًا من القيمة التي خلقتها الطبقة العاملة، دون مقابل، ويُؤكّد ماركس إن الرأسمالية قائمة على توليد فائض القيمة وتحقيق الأرباح، ومصدر الربح هو فائض القيمة، وترتبط أزمات النظام الرأسمالي بتوليد فائض القيمة أو بتحقيقه من خلال بَيْع الإنتاج ( السّلع)
التّراكُم:
يُوَفِّرُ الرأسمالي مبلغًا ماليا يستثمره في شراء قوة العمل وجميع المدخلات الأخرى المستخدمة في الإنتاج كَعُنْصُرَيْن أساسيّيْن في عملية إنتاج السّلع التي تُصبح ملكًا للرأسمالي الذي يتحوّل إلى بائع للسلع الجاهزة، بهدف الحصول على مال يفوق بكثير المبلغ الذي استثمره، بفضل جُهْد العامل الذي أضاف قيمة للمواد الخام، ويُسمّى “فائض القيمة” لأنه يُمثّل جزءًا من وقت العمل غير مدفوع الأجر للعمال الذين ينتجون السلع، ويُعاد استثمار معظم فائض القيمة المُحقق في عملية الإنتاج لتوليد المزيد منه، وهي العملية التي يُسمّيها كارل ماركس “تراكم رأس المال”، ولكي لا تُؤَدِّي هذه العملية إلى زيادة الطّلب على القوى العاملة وارتفاع الأُجُور – مما قد يُقلّص هامش الرّبح – ابتكرت الرأسمالية آلية “جيش العمالة الاحتياطي” أو “الفائض النسبي للسكان”، ويُعرف ماركسي جيش العمالة الاحتياطي “هو شريحة من الطبقة العاملة غير موظفة في الشركات الرأسمالية، ولكنها متاحة للتوظيف عند الحاجة… هناك جزء من هذا الجيش الإحتياطي لم يتم استغلاله بَعْدُ من قِبَل الرأسمالية (الواقفدون الجدد على سوق العمل) وجزء آخر من الطبقة العاملة يتنقل بين العمل والبطالة، وجزء ثالث يُمثل العمال الذين فقدوا مهاراتهم أو توقفوا عن البحث عن عمل، لأسباب مختلفة، وتُشكل هذه الشرائح الثلاث “جيش العمالة الاحتياطي” الذي يُمكّن الرأسمالية من السيطرة على القيمة الحقيقية للأُجُور، وتضمن عدم ارتفاعها، أي إن البطالة ظاهرة مُستمرة وجزء من آليات النظام الرأسمالي، وليست ظاهرة عَرَضِيّة…
من جهة أخرى، يستخدم العُمال أُجُورَهم في شراء السّلع التي تُلبِّي احتياجاتهم الاستهلاكية، أي إن جزءًا هامًّا من الأجور تعود إلى الرأسماليين في شكل إيجارات المسكن أو استهلاك السّلع، وبذلك يُساهم العُمّل في توليد فائض القيمة وتحقيقه مرة أولى عند استغلالهم في عملية الإنتاج ومرة ثانية عند شراء ما أنتجته الطبقة العاملة من سِلَع، مع الإشارة إلى إن النظام الرأسمالي يُخطّط لتحديد حجم السلع المُنتَجة ( وكمية العمل الضرورية للإنتاج) و ضمان شرائها بالأسعار اللازمة لتحقيق كامل قيمتها لتوليد فائض القيمة وتحقيقه، ولكي يُعيد النظام الرأسمالي إنتاج نفسه، دون مواجهة مشكلة زيادة الطلب أو نقصه، يجب عليه التخطيط لتَناسُبِ إنتاج السلع الإستهلاكية والسلع الإنتاجية ( الآلات والتجهيزات الثقيلة الضرورية للإنتاج) لكي يتحقَّقَ النُّمُوّ – عبر عملية إعادة الإستثمار واستخراج فائض القيمة وتحقيقه بسرعة – بفعل ازدياد القيمة، بمرور الوقت
تحدث الأزمات عند تَوَقُّف إنتاج فائض القيمة وتداوله وتحقيقه أي عند إنتاج قدر كبير من القيمة الفائضة وعدم بيع الإنتاج بَعْدَ إضافة قيمة له من قِبَل الطبقة العاملة، مما يؤدّي إلى انخفاض الإستثمار الرّأسمالي وفقدان الوظائف وتراجع الطلب على السلع والخدمات المُنتجة، كما يمكن أن تحدث الأزمات عندما لا يكون النظام الرأسمالي قادرًا على توليد ما يكفي من القيمة الفائضة، أو ما يُعبّر عنه بانخفاض في معدل الربح الذي يتحقق من الاستثمار…
يُقسّم ماركس الرأسماليين إلى “عاملين يشاركون مباشرةً في إنتاج السلع” أو رأس المال الصناعي الذي ينظم عمليات إنتاج السلع، ورأسماليين يضمنون بَيْع الإنتاج، أو رأس المال التجاري الذي يتسلّم السلع من رأس المال الصناعي لبيعها للمستهلكين، ويُصِرّ كارل ماركس على التّأكيد ” إن فائض القيمة لا يتولد إلا في الإنتاج، لكنه يُصبح مصدر دخل لشرائح مختلفة من الطبقة غير العاملة” أي للرأسماليين، من خلال توزيع فاض القيمة بين رأس المال الصناعي ورأس المال التجاري ورأس المال المالي أو النَّقْدِي ( المصارف) لأن الشركات لا تملك كل الأموال اللازمة لتوسيع إنتاجها، أو إدخال آلة جديدة، أو توسيع شبكة متاجرها، ولذلك تحتاج إلى اقتراض المال لتمويل استثماراتها، بفائدة يتم تحقيقها من خلال القيمة الزائدة التي يخلقها العاملون، ضمن العمل غير مدفوع الأجر، ويلخص ماركس ( رأس المال – المُجلّد الثالث ) عملية توزيع الفائض كالتالي: يحصل الرأسمالي الصناعي على النصيب الأول من الربح، والرأسمالي التجاري على النصيب الثاني في شكل ربح، والرأسمالي النقدي على النصيب الثالث في شكل فائدة على القروض، ويحصل مالكو الموارد الطبيعية على النصيب الثالث قي شكل ريع، وتعتمد جميع الفئات (العمال في سوق العمل و الرأسماليين الذين يجمعون الأرباح ) على الأسواق من أجل البقاء في ظل الرأسمالية، غير إن العلاقة متناقضة بين رأس المال والعمل، وكذلك بين الرأسماليين ضمن عملية تنافس داخل نفس الطّبقية من أجل خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي تحقيق فائض قيمة أكبر وأرباح أكبر من المنافسين وإعادة استثمار فائض القيمة أو الربح في عملية الإنتاج، لزيادة حجم رأس المال وتحسين تقنيات الإنتاج المُوَفِّرَة للعمالة، بهدف التقليل من كمية العمل المستخدمة وزيادة المُدخلات غير العمالية بدلاً منه…
تعتمد نظرية القيمة لماركس على تحليل وقراءة نقدية لآدم سميث فقد اعتبر ماركس تأثير علاقات الإنتاج الاجتماعية على النتائج الاجتماعية مسألة محورية، كما يعتبر إن عقد العمل المأجور هو مبادلة قوّة العمل بأجر نقدي أي شراء الرأسمالي لقدرة العمال على إضافة قيمة إلى وسائل الإنتاج من خلال إنتاج سلع وخدمات مفيدة، ويستحوذ الرأسماليون على “جهد العمل غير مدفوع الأجر”، وهذا جزء من عملية الانتقال من قانون السلعة إلى قانون التبادل الرأسمالي وتقسيم العمل ( لإنتاج السّلع) ضمن العلاقات الإجتماعية للإنتاج
من إضافات الباحثين الإقتصاديين المهتمين بدراسة “رأس المال” لكارل ماركس:
صاغ عدد من الباحثين من البلدان الإمبريالية وكذلك من بلدان “الأطراف” بعض الإستنتاجات خلال عقدَيْ سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، ومن أهمها:
إن استغلال العمل الإنتاجي هو مصدر فائض القيمة النقدية في اقتصاد رأسمالي منتج للسلع
إن القيمة النقدية للناتج الصافي (المكافئة للقيمة المضافة) هي بمثابة المكافئ النقدي لإجمالي جهد العمل الإنتاجي، وفاتورة الأجور هي المكافئ النقدي الذي يتلقاه العمال مقابل الجزء المدفوع من جهد عملهم، والفرق بين القيمة النقدية للناتج الصافي وفاتورة الأجور هو فائض القيمة النقدية الذي يتحقق في المنافسة بين الرأسماليين وغيرهم من المطالبين، مثل ملاك الأراضي وأصحاب الملكية الفكرية بأشكال مختلفة مثل الربح والفائدة والإيجار والإتاوات وما شابه ذلك.
إن قانون التبادل الرأسمالي يحتفظ ببعض السمات الرئيسية لنسخة قانون تبادل السلع، ويتم الترابط بينهما كالتالي: يستمر التعبير النقدي عن وقت العمل في الانتقال بين جهد العمل والقيمة النقدية لصافي الناتج على مستوى النظام ككل، وفائض القيمة الإجمالي هو المعادل النقدي لجهد العمل الإنتاجي غير المدفوع، وإن الجزء من المجمع الكلي لقيمة الفائض الذي تستولي عليه شركة رأسمالية معينة كربح لا يتناسب بالضرورة مع جهد العمل غير مدفوع الأجر المستخرج في سياق عمل تلك الشركة.
إن المنافسة هي الآلية التي تُفرض من خلالها ضرورات النظام الرأسمالي على الرأسماليين الأفراد، ومن المصلحة التنافسية لكل شركة رأسمالية استغلال عملها قدر الإمكان عن طريق زيادة كثافة جهد العمل وخفض تعويضات الأجور النقدية، وخفض إيجارات الأراضي ودخل الملكية الفكرية، مما يُخفّض تكاليف وسعر السلعة المُنتَجة.
يرى ماركس أن معادلة معدل الاستغلال تُعد نزعةً أساسيةً في النظام الرأسمالي المُنتج للسلع، حتى وإن كانت تُعيقها عقبات قانونية وعملية تُعيق حرية تنقل العمالة الكاملة، مثل عرقلة حركة الهجرة خلال القرنَيْن العشرين والواحد والعشرين، والاختلافات في معدلات الإستغلال بين الإقتصادات الإقليمية والأسواق الموازية للاتجار بالبشر الخ
تعريف الاستغلال
عملية استيلاء غير متكافئ وغير عادل على شيء يملكه شخص ما لشخص آخر، حيث يستغل الرأسماليون، كطبقة، العمال بهذا المعنى من خلال الاستيلاء على وقت عمل غير مدفوع الأجر على شكل فائض قيمة نقدية، بما في ذلك الربح والإيجارات والفوائد، كما تستغل الرأسمالية الموارد الطبيعية بشكل يُعرّض الإنسان والطبيعة ( المُحيط) للضّرَر، وفي كل الحالات يُؤدّي الإستغلال إلى تدهور ظروف الحياة ويتفاقم هذا التّدهور عندما لا توتفع الأُجُور بنفس مُعدّل ارتفاع إنتاجية العمل، وهو ما يحصل منذ ثمانينيات القرن العشرين أو “الفترة النيوليبرالية”
*****
كان كارل ماركس مُفكِّرًا ومناضلا، فقد كان يعتقد إن مشاكل المجتمع الطبقي لا يمكن حلها إلا بتغيير شامل على مستوى النظام، و كان يدعو إلى تغيير شامل لعلاقات الإنتاج الاجتماعية من خلال العمل الثوري الذي تقوده الأحزاب البروليتارية، وساهم في تأسيس الجمعية الدّولية للعمال ( الأُمَمِية الإشتراكية) التي طرحت مسألة الثورة وبدائل الرأسمالية.