فرنسا، ثقافة استعمارية مُتَجَذِّرَة وتوتّر قبل الإنتخابات العامة 2022 / الطاهر المعز

الطاهر المعز ( تونس ) – الجمعة 22/10/2021 م …
الجزء الأول
في ذكرى مجزرة 1961
يُحْيي الجزائريون بالجزائر وبفرنسا، يوم الأحد 17 تشرين الأول/اكتوبر 2021، الذكرى السّتّين لمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس، التي ارتكبتها قوات الشرطة الفرنسية، ضد حوالي خمسين ألف جزائري، تَظاهَرُوا سلمِيًّا تلبية لنداء جبهة التحرير الوطني الجزائرية، ضد حظر التجول الذي فرضه عليهم موريس بابون مدير أمن العاصمة، وهو موظف دولة فرنسي تعاون علنًا مع النّازية، ومَتّعه الرئيس شارل ديغول بالعفو (كما مئات الإرهابيين الآخرين) ومكّنه من الإرتقاء في السُّلَّم الوظيفي الحكومي، وكانت فرنسا الإستعمارية تعتبر الجزائر “أرضًا فرنسية”، لكن سُكّانها “فرنسيون مُسلمون”، لهم وَضْعٌ خاص، أقل مرتبة من المواطنين العاديين، فكان حظْر التّجوّل ساريا ضد “الفرنسيين المُسلمين” (أي الجزائريين) منذ يوم الخامس من تشرين الأول/اكتوبر 1961، من الساعة السادسة مساء، إلى السادسة صباحًا، ومُنِعَ الجزائريون من الذهاب إلى أو العودة من عملهم في مصانع السيارات أو المصانع المفتوحة بدون انقطاع…
أسفر القمع الدّموي ذلك المساء عن اعتقال أكثر من 12 ألف جزائري، وعن أكثر من مائتَيْ قتيل من النساء والرجال والأطفال، وحوالي أَلْفَيْ مفقود، وألقت الشرطة بالعشرات منهم في نهر السين، ليموتوا غرقًا، وجُرِح ما لا يقل عن ألفَيْن..، فضلاً عن ترحيل الآلاف إلى الجزائر.
إنها جريمة دولة، وجريمة ضد الإنسانية، بقيت بدون تتبُّع أو عقاب، بل لا يزال الرؤساء والمسؤولون الحكوميون والحزبيون الفرنسيون يمعنون في استفزاز وإهانة الجزائر، واستهداف الدولة والوطن والشعب، وآخرها الإستفزاز الذي تعمّد إطلاقه الرئيس الفرنسي الحالي (إيمانويل ماكرون) لأغراض داخلية وانتخابية…
حدثت تلك الجريمة، بعد بضعة أشهر من اتفاق مدينة “إيفيان” (18 آذار/مارس 1961) الذي ينص على استقلال الجزائر، وحدثت تلك المجزرة مع اقتراب “حرب الجزائر” من نهايتها، قمعت قوات الأمن الفرنسية بعنف تلك المظاهرة، وتَواصَل القمع طوال تلك الليلة والأيام اللاحقة، حيث أعْدَمت الشرطة الفرنسية العديد من الجزائريين وألْقَتْ جثثهم في نهر “السين”.
تجاهلت الدّولة والأحزاب، بما في ذلك الحزب “الشيوعي” الفرنسي والإعلام (الذي كان يخضع لرقابة صارمة ) والمؤرّخون تلك المجزرة الإستعمارية، إلى أن بدأ أحفاد الجزائريين الذين بقوا في فرنسا وشهدوا المجزرة يتكلمون، بمناسبة الذكرى العشرين لهذه المجزرة (سنة 1981)، بمناسبة التحضيرات ل “المسيرة من أجل المساواة” التي تندد بالعنصرية المؤسسية (عنصرية الدولة) في فرنسا، وبعد عشر سنوات (سنة 1991)، نشر المؤرخ جان لوك إينودي كتابًا بعنوان “معركة باريس، 17 اكتوبر 1961″، حيث شكَّكَ المؤلف في الرواية الرسمية للدولة التي نَفَتْ وجود القَمْع وقلّلت من حجم الخسائر البشرية وأعلنت عن “ثلاثة قتلى في اشتباك بين الجزائريين”، وأشار المؤرخ، بعد بحث دقيق إلى أن عدد القتلى يزيد عن المائتَيْن، مِمّنْ عُرِفت أسماؤهم وهوياتهم الكاملة وظروف قَتْلِهم. أما على الصعيد الرّسمي، فلا يوجد أي سِجِلّ لعدد الضحايا والمعتقَلين والمُصابين…
أطلق المؤرخان البريطانيان جيم هاوس ونيل ماكماستر على هذا القمع في العام 2006 صفة “أعنف قمع دولة تسبب فيه احتجاج في شوارع أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر” ( كتاب: “باريس 1961 الجزائريون، إرهاب الدولة والذاكرة” – تأليف جيم هاوس ونيل ماكماستر، مطبعة جامعة أكسفورد ، 376 ص.)
استمرار المنطق الإستعماري:
قَبْلَ أُسْبُوعَيْن من إحياء ذكرى 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، تَعَمّدَ الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” استفزاز الدّولة والشّعب الجزائريَّيْن، لأسباب انتخابية، بالتّقليل من أهمّية الإستعمار ونتائجه، وبإنكار وجود “أُمّة جزائرية” أو بلد وشعب جزائري، في ترديد لمقولات الإستعماريين واليمين المتطرف، من قَبيل “إن المُستعمَرات كانت تسكُنها قبائل مُتخلّفة، وإن للإستعمار مُهمّة تاريخية تتمثل في تَمْدِين وتحضِير هذه المناطق”، وبذلك أراد “إيمانويل ماكرون” تملق جمهور اليمين الفرنسي المُتطرّف، قُبيل الإنتخابات العامة سنة 2022 ، ما أدّى إلى أزمة دبلوماسية بين الدّولَتَيْن، وجاء أيضًا في التصريحات الإستفزازية لإيمانويل ماكرون (موظف مصرف روتشيلد سابقًا)، يوم الثرثين من أيلول/سبتمبر 2021: “إن النظام السياسي العسكري المُنْهَك بالجزائر قائم على كراهية فرنسا، ويحافظ على ذاكرة ريعية مُتخَيَّلَة، مجانبة للحقائق التاريخية، بل لا أساس لها…”، وأثارت هذه التصريحات استياءً في الجزائر، كما في فرنسا.
تندرج هذه التصريحات الإستفزازية في سياق الخلافات بين الدولتين حول عدة قضايا، منها قضايا التأشيرات والهجرة أو الجزائريين المقيمين في فرنسا، والعقود الاقتصادية والتجارية التي لم تحصل عليها شركات فرنسية، وتاتي كذلك في سياق الخلافات بشأن سَيْر الحروب التي يشارك بها أو يقودُها الجيش الفرنسي، على حدود الجزائر، في ليبيا وفي مالي، وتسببت … هذه التصريحات الاستفزازية في حادث دبلوماسي جِدِّي، ورَدّ الرئيس الجزائري بأن “ملف ذاكرة التاريخ الدّامي للإستعمار الفرنسي لا يُطْرَحُ في مزاد السياسة، وهو ليس محل مساومات ومناورات سياسوية لأن التاريخ لا يسير بالأهواء ولا بالظروف، ولا يمكن تزييفه، ولا يُمكن محو جرائم الإستعمار الفرنسي بالجزائر ببعض الكلمات الطّيِّبَة”…
سبق أن اعترف “إيمانويل ماكرون”، عندما كان في وضع المترشح للرئاسيات الفرنسية سنة 2017، في زيارة إلى الجزائر، بارتكاب الإستعمار الفرنسي بالجزائر “جرائم ضد الإنسانية”، وبعد أربع سنوات من فوزه بالإنتخابات الرئاسية، وخُلُوِّ فترة رئاسته من إنجازات تُخَوِّلُهُ الفوز مرة أخرى، بدأ يبحث عن الحُلُول السّهْلَة، فبدأ بالتّقرّب من اليمين العنصري المتطرف، وصرّح “إن التاريخ الرسمي للجزائر مُزَيَّف، وأُعيدت كتابته بشكل كامل، فأصبح لا يعتمد على الحقائق التاريخية الثابتة”، وكان سَلَفُهُ الرئيس “الإشتراكي” (فرنسوا هولند) قد صرّح (ربما سنة 2015): “لم ترتكب فرنسا حرب إبادة في الجزائر، فقد كانت حربا وكفى”، وتحاول هذه التصريحات، من اليمين ومن اليسار (اليسار الإستعماري الفرنسي) إنكار مسؤولية الدّولة الفرنسية عن الجرائم الاستعمارية، رغم الوعْي المُتنامي بحقيقة هذه الجرائم، واعتبارها “جريمة دولة”، و”جريمة ضد الإنسانية”، في بعض (وليس كل) الأوساط النقابية والحقوقية والسياسية، ومُشاركتها في التجمّعات التي تُقام سنويا بذكرى مجازر 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، ولا يزال التاريخ الإستعماري لفرنسا، أو الجرائم العديدة في إفريقيا وآسيا، مُهْمَلاً، بل مَخْفِيًّا ولم ترفع الدّولة الفرنسية السّرّية عن الوثائق (منها التي سُرِقَتْ من الجزائر) لكي لا يتمكّن الجمهور والطلبة والباحثون والمُؤرّخون من الإطّلاع عليها…
وقائع مجزرة 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961 بباريس:
دعا فرع جبهة التحرير الوطني الجزائرية بفرنسا، في إطار مُقاومة الإستعمار، العمال الجزائريين إلى الخروج في مسيرات سلمية بباريس احتجاجا على حظر التجول، المفروض عليهم تحديدا ( كانوا يُسمّونهم “الفرنسيون المسلمون”) بداية من يوم الخامس من تشرين الأول/اكتوبر 1961، إلى أجل غير مُحَدّد، من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، من قبل مدير الشرطة وقتها، “موريس بابون”، الذي اشتهر بعمالته للإحتلال النّازي، خلال الحرب العالمية الثانية، كما كان مُحافظًا لولاية قسنطينة أثناء فترة الإستعمار الفرنسي للجزائر، وكانت المحادثات بين قيادة جبهة التحرير الوطني والسلطات الإستعمارية الفرنسية قد أفضت في أيار/مايو 1961، إلى اتفاقيات “إيفيان”، التي أقرّت مبدئيا الإستقلال، وتتواصل المفاوضات إلى آذار/مارس 1962، على أن تستقل البلاد فعلِيًّا في تموز/يوليو 1962… جمعت المُظاهرة السّلمية، التي منعتها السلطات الفرنسية، حوالي خمسين ألف من المتظاهرين الجزائريين، الذين جاؤوا من أحياء الصفيح، بباريس وضواحيها، بينهم نساء وأطفال، وبدأت الشرطة مراقبة المتظاهرين، قبل الوصول إلى المكان المُحدّد، وبدأت الإعتقلات وإطلاق الرصاص الحي، وأظهرت بعض الشهادات أن تعليمات السلطات الفرنسية لقوات الشرطة كانت “قَمع المتظاهرين، والإعتقالات المسبقة “الوقائية”، خلال اليوم السابق للمظاهرة، ثم قبل الوصول للشوارع الكبرى، ومنع التّظاهر بأي شكل، واستخدام كافة الوسائل التي بحوزة عناصر الشرطة”، ونقل المُؤرّخون روايات الشهود والمشاركين في المظاهرات، وقدّروا عدد المُعتقلين بنحو 12 ألف جزائري تم احتجازهم في مُحتشدات أُنْشِئت خصّيصًا للجزائريين، وتم تحويل قصر الرياضات وقصر المعارض بباريس إلى محتشدات ضخمة، ومارست الشرطة التعذيب والقَتْل، بترخيص من الحكومة، ودون رقيب، كما رحلت السلطات الفرنسية آلاف العمال الجزائريين من باريس وضواحيها إلى الجزائر، بسبب مشاركتهم في المظاهرات، ويقدر المسؤولون الجزائريون ضحايا قمع مظاهرات 17 أكتوبر / تشرين الأول 1961 من 300 إلى 400 قتيل، ألقي بجثث العشرات منهم في نهر السين، فضلا عن المفقودين والمجروحين، فيما قدّر المؤرخون عدد من ثبت قتلهم بمائتين، فضلاً عن المفقودين، أما تقارير السلطات الفرنسية فتدّعي أن ثلاثة قتلى كانوا ضحية شجار بين الجزائريين، وتوفي أحدهم بسكتة قلبية، وفرضت الحكومة الفرنسية الرقابة المُشدّدة على وسائل الإعلام، وفرضت حكومة “ميشيل دوبريه” والرئيس الجنرال “شارل ديغول” ووزير الدّاخلية “روجيه فراي”، وكذلك “موريس بابون” محافظ باريس وقائد شرطتها، (فرضوا) الصمت والتّغْييب، ومُنِعَ الصحافيون من الإقتراب من المُحتشدات، ومن الإتصال بالجزائريين لجمع الشهادات، وصوّر فريق من التلفزيون البلجيكي، كان متواجدًا لتسجيل حفل “جاك بريل” بقاعة الأولمبيا، بعض القمع الذي جرى (صُدءفَةً) أمام أعينهم، دون أن يفهم المُصورون ما يحصل، وحاولت السلطات الفرنسية استرداد التسجيل لكن رفضت إدارة التلفزيون البلجيكي هذا الطلب، رغم الضّغوط الحكومية…
وَصَفَ المؤرخ الفرنسي “جيل مونسورون” هذا التّعتيم السياسي والإعلامي “إنه تضليل تاريخي متعمد من أجل طمس ذاكرة أحداث 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، ومحاولة ترسيخ أحداث أخرى في الذاكرة الجماعية وحتى لدى العائلات الجزائرية”، حيث رسخت في ذاكرة اليسار الفرنسي، أحداث 8 شباط/فبراير 1962 بحي “شارون” (باريس)، اوتتمثل في قمع الشرطة لمسيرة من أجل “السلم في الجزائر” وضد “المنظمة السرية” التي أسّسها ويقودها غلاة المستعمرين المستوطنين بالجزائر، ونفذت عددًا من التفجيرات والإغتيالات، وقامت بمحاولة انقلابية عسكرية، ولم تكن تلك المظاهرة تنادي باستقلال الجزائر، وقُتل خلالها فرنسيون، لكن الحدث احتل في الذاكرة الجمعية الفرنسية المكانة التي كان يجب أن تكون لمجازر 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961،التي كان ضحاياها من الجزائريين، منهم فتيان وصبايا لم تتجاوز أعمارهم 15 سنة، ولم تعترف الدولة الفرنسية بمسؤوليتها عن المجزرة، لكن ، ومنذ 2001، بدأ بعض السياسيين (من غير أعضاء الحكومة)، يتحدّثون عن “ضحايا 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961)، وتبعهم الرئيس “فرنسوا هولند”، سنة 2011، بوضع الرئيس الفرنسي إكليل من الزهور في جسر “كليشي”، على نهر السين أيضا، استخدمته الشرطة لإلقاء الجزائريين، أحياء وأمواتًا في النّهر، ولكن لم تعترف الحكومة ولا البرلمان بمسؤوليتها، وبقيت تُسمِّي حرب الإستقلال بالجزائر (1954 – 1962) وكافة المجازر التي ارتكبتها جيشها وشرطتها “عمليات فرض الأمن”، ولئن تمت محاكمة “موريس بابون”، سنة 1997، بعدما فاق عمرة تسعين سنة، لتواطؤه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية بفرنسا، ولم تتم محاكمته بسبب المجزرة ضد الجزائريين، بباريس، في 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، ولم يُحاكم أحد غيره، ولم يقع الإفراج عن الوثائق المتعلقة بالمجزرة، رغم مرور ستة عُقُود، لكن لا تزال مشاهد القتل والإعدامات الصورية ورمي الجثث في نهر السين راسخة في ذاكرة الشعب الجزائري، من أبناء وأحفاد الضحايا، وهي في الواقع جزء من تاريخ فرنسا، ومن واقع الميز والفصل العنصري بفرنسا،ة فعندما سقط ثمانية قتلى (فرنسيين) في حي “شارون” يوم 8 شباط/فبراير 1962، تظاهر حوالي مليون شخص في باريس، لكن لم يخرج أحدٌ للإحتجاج ضد جريمة 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، لأن الضحايا جزائريون.
استنتاجات ومطالب مشروعة:
رغم حجب المعلومات من قِبَل الحكومة، وتصنيف الوثائق الخاصة بالإستعمار وجرائم الجيش والشرطة، كأسرار دولة، تمكّن بعض الباحثين من الكشف عن جانب هام من هذه الجرائم، ومنها جريمة 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، وتسلسل أحداثها ، والوسائل المستخدمة، ولا يزال الاعتراف بجريمة الدولة معلقا، فيما يرفض اليسار “الاشتراكي” تسمية المسؤولين، وسبق أن نشر المستشار القانوني بمجلس الدولة، في كانون الثاني/يناير 1998، تقريرًا يُشير بوضوح إلى اعتقال حوالي 14 ألف جزائري، خلال يومَيْ 17 و 18 تشرين الأول/اكتوبر 2021، إثر انخراط قوات الشرطة، بإشراف المحافظ “موريس بابون”، في عمليات مطاردة ومُداهمات ونصب الحواجز في الطرقات والسّاحات ومحطات قطار الأنفاق، وتعرض المعتقلون (في قصر الرياضة ومتنزه المعارض وملعب بيير دي كوبرتان، والمحلات التي تحولت إلى أماكن احتجاز ) للضرب والتعذيب لعدّة أيام، مع تركهم بدون غذاء ولا ماء، وتم إعدام العديد منهم في فناء مُديرية الشرطة بباريس، ثم دَفْنُ جثثهم في مقابر جماعية، أو رمي الجثث في نهر “السين”، ووصف المستشار هذه الأعمال التي استهدفت الآلاف من “مُسلمي فرنسا” (الجزائريين) بأنها الأشنَع منذ الحرب العالمية الثانية.
على أي حال، تُدين المعلومات المتوفرة الدّولة، ورئيسها “شارل ديغول”، ورئيس وزرائها “ميشيل دوبريه”، ووزير الداخلية ومدير الأمن ومُحافظ مدينة باريس، وضُبّاط الشرطة، فالدّولة مسؤولة عن هذه الجريمة، إذ ثَبَتَ أن ممثلها (محافظ شرطة باريس، موريس بابون) كتب في مذكرة وجهها في الخامس من أيلول/سبتمبر 1961 إلى مدير جهاز تنسيق الشؤون الجزائرية وإلى مدير الشرطة: “إذا تم القبض على أعضاء مجموعات [جبهة التحرير الوطني] يتعين قتلهم على الفور من قبل الشرطة. لا نريد سجناء “، ولذا يتوجّب على الدّولة جبر الضرر لعائلات الشهداء والمُصابين ومجهولي المصير وأحفادهم، والدّولة مُلْزَمَة برفع السّرّيّة عن الوثائق الخاصة بالإستعمار وبالإنتهاكات التي ارتكبتها أجهزتها، من إدارة وقضاء وجيش وشرطة وغيرهم ممن نفذوا إرهاب الدولة، عبر التعذيب والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والإعدام خارج إطار القضاء، فالشهادات عديدة ودقيقة ومفصلة، وجمعت “بوليت بيجو” في كتابيها المنشوران سنة 1961، بدار النشر “فرنسوا ماسبيرو ( Les Harkis in Paris و Ratonnades in Paris)، فالجزائري، سواء كان يقيم بفرنسا أو بالجزائر، كان ضحية لعنصرية الدّولة وللأحكام العُرفية، الإستثنائية، لأن الدولة الفرنسية تعتبرة يُشكّل “تهديدًا للوحدة الترابية”، واعتبرت المحامية “نيكول دريفوس” أن جرائم الدولة التي ارتكبها مختلف مسؤولي مؤسساتها، هي جرائم ضد الإنسانية، تمّ تنفيذها ضمن خطّة مُنَسّقة، بموافقة الحكومة.
يَعْتَبِرُ بعض المؤرخين التّقدّميين أن الدّولة الفرنسية فرضت على المجتمع وعلى الإعلام “قانون الصّمت”، بخصوص تلك “الأحداث” التي اعتبرها بعضهم “وحشية مفرطة”، و”مطاردة بشرية” و”مجزرة استعمارية”، ارتكبتها أجهزة ورجال الدّولة الفرنسية عَمْدًا، وبتخطيط مُسبق، ولا يزال المؤرخون والباحثون يخوضون معركة في فرنسا لفتح الأرشيف، للإطلاع على الوثائق التي تُؤَكّدُ وقائع أصبحت معروفة، بفضل روايات شاهدي العيان والمُشاركين النّاجين من القتل، ومن مجزرة 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، التي نَظّمت الدولة عملية إنْكارها وإخفائها، طيلة أربعة عُقُود، وأشرف على هذه المجزرة بباريس أحد المتعاونين مع الاحتلال النازي (موريس بابون) الذي استفاد من دعم الدولة ورئيسها شارل ديغول، وأصدرت الحكومة (وزارة الدّاخلية) بيانًا كاذبا بشأن الطابع السّلمي للمظاهرة، وبشأن عدد القتلى والجرحى والمفقودين، وعن ظُروف القتل، فادّعى البيان أن معارك نشبت بين الجزائريين أدّت إلى سقوط ثلاث ضحايا، إلى أن نَشَرَ إثنان من المؤرخين البريطانيين، “نيل ماكماستر” (جامعة إيست أنجليا) و”جيم هاوس” (جامعة ليدز)، كتابًا موثقًا جيدًا بعنوان (باريس 1961- الجزائريون، إرهاب الدولة والذاكرة)، حيث اعلن المُؤَلِّفَان أن عدد الضحايا والجثث التي ألقيت في نهر السين “لن تعرف أبدًا” بدقة، بسبب إستراتيجية الدولة الفرنسية التي تدعي أن شُرطتها تعمل على “إرهاب الإرهابيين” (وهي عبارة كان يستخدمها الإحتلال النّازي لفرنسا) عبر إنشاء فرق أمنية رسمية تُمارس الإرهاب ضد العرب بإشراف ضباط شرطة فاشيين، يتمتعون بحصانة كاملة، بل بقي الأشخاص الذين كانوا مسؤولين عما مجازر 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، في مناصبهم لفترة طويلة جدا، أصبح موريس بابون (محافظ شرطة باريس، سنة 1961) وزيرا للخزانة في عهد فاليري جيسكار ديستان (1974 – 1981)، وأضحى روجيه فريه (وزير الداخلية سنة 1961) رئيسا للمجلس الدستوري.
تُلخّص مجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 التاريخ الاستعماري لفرنسا وكذلك تاريخ الهجرة الجزائرية إلى فرنسا، كنتيجة مباشرة للاستعمار، كما وجبت الإشارة إلى أن اليسار الفرنسي يتبرّأ من مطلب الإستقلال، ولم يُشارك بهذه المظاهرة، أما بالنسبة للطرف الجزائري، فإن الأخطاء التكتيكية لجبهة التحرير الوطني، التي دعتْ الأُسَر الجزائرية المُقيمة بباريس وضواحيها (مُدُن وأحياء الصّفيح) إلى التظاهر، كانت فادحة، لأنها قامت بتفتيش المتظاهرين، للتّأكُّد من عدم حملهم أي نوع من الأسلحة، وبثّت الأوهام وجعلت النّساء والأطفال في المُقدّمة، وكأن الشعب الجزائري لم يُجَرّب شراسة وعُنف الإستعمار الفرنسي ضد المتظاهرين سِلْمِيًّا في الثامن من أيار/مايو 1945 (سكيكدة وقالمة وخَرّاطة…)، فهل كان لدى قادة جبهة التحرير بفرنسا بعض الأوهام، فاعتقدوا أن الدّولة الفرنسية وأجهزتها تحترم حقوق الإنسان ولا تُطلق الرصاص الحي على النساء والأطفال؟
لقد جنّدت فرنسا الإستعمارية ربع مليون شاب من المغرب العربي، للدّفاع عن أراضيها خلال الحرب العالمية الأولى، وفعلت نفس الشيء خلال الحرب العالمية الثانية، واستورَدَتْ أبناء وأحفاد هؤلاء المُجَنّدين قَسْرًا، بأعداد كبيرة، منذ منتصف القرن العشرين للعمل بالمصانع من أجل إعادة إعمار فرنسا، ومن أجل ازدهار الاقتصاد الفرنسي، وأصبح العُمّال المُهاجرون جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الطبقة العاملة وتاريخ فرنسا، وبالتّالي فإن مجزرة 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، لا تَخُصُّ الجزائريين وحدهم، بل هي جزء من التاريخ الإستعماري والرأسمالي لفرنسا، فهي مجزرة نفذتها أجهزة الدولة الفرنسية وأعوانها المسلحون، وزَوَّرَت الدولة الفرنسية التاريخ وحاولت محو هذه الجريمة (وغيرها) من الذاكرة الجماعية الفرنسية والجزائرية. إن إحياء هذه الذّكرى الأليمة من قِبَل أحفاد الضحايا، بداية من عقد الثمانينيات من القرن العشرين، تُظْهِرُ أن النِّسْيان لم يُصِبْ ذاكرتهم، ويجب أن لا ينسوا ذلك، وأن لا ننسى أي عمل إجرامي استعماري، كما لا ننسى أن الإستغلال (استغلال الطبقة العاملة والكادحين) والإضطهاد (اضطهاد الشُّعوب والفئات الفقيرة) وجْهان لعُمْلَةٍ واحدة، وفَصْلان من فُصُول تاريخ الرأسمالية والإمبريالية، وتاريخ الشُّعُوب.
إن مجزرة 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، جزءٌ من تاريخ الإستعمار الفرنسي، وجزء من تاريخ نضال الشعب الجزائري، ولا جدال في مسؤولية الدولة الفرنسية عن القمع الدموي الذي حدث، ولا يكفي الاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية، بل يجب أيضًا دفع الثمن السياسي والمالي.
أصبح بعض السياسيين والصحافيين الفرنسيين يذكرون مجزرة 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، ويُحمّلون “موريس بابون” مسؤوليتها، كفرد، وكأنه لا يمثل الحكومة، والدّولة التي كان يرأسها الجنرال “شارل ديغول”، الذي أصدر عفوًا على المجرمين من قَتَلَة الشعب الجزائري، وعلى عُملاء ألمانيا النّازية التي كانت تحتل فرنسا…
إن هذه المجزرة وغيرها من المجازر التي ارتكبها الإستعمار الفرنسي ضد الشعب الجزائري، والعديد من الشعوب الأخرى (مدغشقر، الكامرون…) أحداث تاريخية لا يُمْكن مَحْوُها من ذاكرة الشُّعُوب، والمَطلوب الإعتراف بها علنًا، كجريمة دَوْلَة، نفذتها أجهزة الدّولة الإستعمارية الفرنسية، ما يستوجب مُحاسبة المسؤولين عنها، كمسؤولين في أجهزة الدّولة، وليس كأفراد، لأنهم توفوا، دون عقاب، وما يستوجب التعويض المعنوي والمادي لأبناء وأحفاد الضحايا وللشعوب التي وقع استعمارها واستعبادها ونهب ثرواتها وإبادتها…
إنها جريمة دولة، وجريمة ضدّ الإنسانية، لا تسقط بالتقادم ولا يمكن العفو عن مرتكبيها، ويجب أن تبقى القَضِيّة مرفوعة باستمرار جنائيا وسياسيا ضد الدولة الفرنسية التي لازالت تنكر جرائمها، ولا تزال تعتبر الإستعمار أمرًا إيجابيا (قانون شباط/فبراير ر2005) أو في أحسن الأحوال من الماضي الذي لا يجب استحضاره، بل يجب نسيانه وطَيُّ صفحته، لكن الأمر لا يتعلق بالماضي، بل بالحاضر أيضًا، فلا يزال قمع الشرطة مُتواصِلاً ضد أحفاد أبناء المُسْتَعْمَرات، ولا يزال جهاز وأفراد الشرطة يتمتعون بالدّعم الإداري والسياسي والقضائي، ما يعسِّر متابعتهم قضائيا، بينما تمت مُقاضاة الكاتب “جان لوك إينودي” بالمحاكم الفرنسية، سنة 1999، لأنه نَشَرَ حقائق، لا تُنْكِرُها الدّولة ولكنها رفضت الكشف عنها، واضطر “إينودي” إلى جمع شهادات ضباط الشرطة والصحفيين والضحايا، وذهب إلى الجزائر خلال إحدى الإجازات، للإطلاع على ما أمكن من الوثائق، ولمقابلة النّلاجين من المذبحة والأشخاص الذين نَفَتْهُم الدولة الفرنسية بإبعادهم إلى الجزائر (حوالي ستة آلاف مُرَحَّل)، وبالتّوازي مع مُحاكمة “إينودي”، عزلت الدّولة الفرنسية مُوظَّفِيْن اطّلعا على بعض الوثائق المُتعلّقة بهذه المجزرة، والتي كانت تُعتَبَر سرّيّة. شارك اليسار الفرنسي في التستّر والتّعتيم على تلك المجازر التي راح ضحيّتها جزائريون، مُقابل توثيق القمع السّافر الذي أدّى إلى مقتل ثمانية ضحايا فرنسيين أوروبيين بيض، في شباط 1962، كانوا يُطالبون بالسلْم بالجزائر، وليس بالإستقلال، بدعوة من الحزب “الشيوعي” الفرنسي الذي لم يدعم مطلب استقلال الجزائر، سوى بعد توقيع اتفاقيات “إيفيان”، وقبل أشهر قليلة من إعلان الإستقلال… تميّز اليسار الفرنسي بالإنقسام حول مسألة استقلال الجزائر، فكان التّعتيم التّام، إلى أن أحيا أبناء المهاجرين النقاش حول هذه المذبحة، التي كانت مجهولة لدى المناضلين القاعديين بالنقابات وأحزاب اليسار، ثم نَسَفَتْ بعض المنشورات، والصّور، رواية الدّولة الرّسمية، من أساسِها، بداية من سنة 1986، وحاولت الدولة الفرنسية شراء جميع الصور، بغرض حجْبِها، لكن بقيت بعض التسجيلات السمعية البصرية بالتلفزيون البلجيكي، وبقيت بعض الصّور الفوتوغرافية التي لم تتمكن أجهزة الشرطة والقضاء من الإستحواذ عليها.
اختار الرئيس الفرنسي توقيت تصريحاته الإستفزازية المتتالية، لحسابات انتخابية، لها علاقة مباشرة بالتّصعيد اليميني المتطرف، قبل كل حملة انتخابية، وهي عادة غير حميدة، أصبحت مألوفة منذ أكثر من عشرين سنة بفرنسا، حيث تتعدّد المُزايدات وتمجيد الإستعمار وإلقاء مسؤولية تدهور وضع العاملين والفُقراء، على كاهل المُهاجرين وأبنائهم، بهدف تقسيم الطبقة العاملة والكادحين والفُقراء، وصَرْف الأنظار عن بعض الفئات الرأسمالية التي راكمت الثروة وقت الأزمات، وزمن انتشار وباء “كوفيد-19″، وتتناول فقرات الجزء الثاني من هذه المقالة، بعض ظروف الفُقراء التي يتجنب المُترشّحون مناقشتها والبحث عن حلول لها، خلال الحملة الإنتخابية.
*****
فرنسا، ثقافة استعمارية مُتَجَذِّرَة وتوتّر قبل الإنتخابات العامة 2022
الجزء الثاني- من يهتم بمشاغل الفقراء؟
الطاهر المعز
بدأ التّنافس بين الطّامحين لِتَبَوُّإ منصب نائب بالبرلمان أو رئيس للجمهورية، داخل نفس الإتجاهات والتيارات، أو فيما بينها، قبل أكثر من ستة أشهر من البداية الرّسمية للحملات الإنتخابية، ومن المُقَرَّر أن تجري الدّوْرَة الأولى في نيسان/ابريل 2022، وتُشير مُجمل التقارير الرسمية وغير الرسمية، الفرنسية والأجنبية، إلى تدهور الوضع الإقتصادي والإجتماعي، خاصة منذ انتشار وباء “كوفيد 19″، وتسريح الآلاف من العاملين، رغم توزيع المال العام بسخاء على الأثرياء وأرباب العمل والشّركات، وبدل التنافس بين المُترشِّحين المُحتَمَلِين بشأن الحُلُول التي يقترحونها لحل مشاكل الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار (خاصة أسعار الطاقة والأغذية والتجهيزات وقطع الغيار…) انطلقت المُزايدات بشأن المُهاجرين واللاجئين، وبشأن المغرب العربي (خاصة الجزائر) والعرب عمومًا وإفريقيا، الواقعة تحت الصحراء، وتتنزل التّصريحات والإجراءات المُستفزة للجزائر (دولة وشعبًا ووَطَنًا) ولمواطني المغرب العربي، بشأن التّأشيرات، ثم بشأن نفي وجود كيان إسمه الجزائر قبل احتلال البلاد من قِبَل فرنسا (1830) وغير ذلك من التّصريحات، في إطار هذه المُزايدات بين الأفراد والتيارات اليمينية، التي ينحو معظمها بثبات نحو الفاشية، وتحميل الأطراف الخارجية وِزْرَ الأزمة التي لا يمكن إخفاؤها، وتدهور مكانة دولة فرنسا التي أصبحت قُوّة مُتوسِّطَة (وليست قوة عُظْمى) داخل المنظومة الإمبريالية والأطلسية، ونظرًا لعجز المنظومة الحاكمة على الوقوف بندّية في وَجْهِ الإمبريالية الأمريكية وحلفائها (بريطانيا وكندا وأستراليا، وحتى الكيان الصهيوني الذي يتجسّس على الرئيس الفرنسي)، ونظرًا للطبيعة الرأسمالية للنظام الحاكم، أهملت معظم الأحزاب والتّيّارات ورموزها التي دخلت الحملة الإنتخابية مُبكِّرًا، حصل اتفاق ضِمْنِي لاستبعاد مشاغل الكادحين والفُقراء، وتوجيه الخطاب السياسي روالإعلامي نحو قضايا أخرى، معظمها مُفتعلة، ومن بينها هل يجب الإعتذار للجزائر، بدل النقاش حول أساليب مُعالجة البطالة والفَقْر.
أعلنت الحكومة الفرنسية، بنهاية أيلول/سبتمبر 2021، خفض عدد التّأشيرات لمواطني دُول المغرب العربي، ما أثار غضب المواطنين والسّلُطات في الجزائر، بينما آثرت سلطات المغرب وتونس الصّمت، بذريعة إثارة هذه المشاكل عبر “القنوات الدّبلوماسية”، واتهمت حكومة فرنسا دول المغرب العربي الثلاث بعدم التعاون بشأن ترحيل مواطنيها الذين تنتهي صلوحية تأشيراتهم أو تُرْفَضُ طلبات إقامتهم، واتّسم إعلان الحكومة الفرنسية بالوقاحة وبالتّعالي، ويتنزّل ضمن المنطق الإستعماري السّائد بفرنسا، حيث أعلن ناطق باسم الحكومة: “أصبح القرار ضرورياً لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا… كان هناك حوار، ثمّ كانت هناك تهديدات، واليوم ننفذ تلك التهديدات”، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية (28 أيلول/سبتمبر 2021)، وتأتي هذه التصريحات ضمن المناخ السابق للإنتخابات، حيث أصبحت قضية الهجرة قضية دائمة الحُضُور، منذ أربعة عُقُود، وهي قضية مُفْتَعَلَة، تُمَكِّن الحكومات ومعظم الأحزاب من صَرْفِ نظر العاملين والفُقراء عن مشاغلهم الحقيقية، وخلق انقسامات وخُصُومات داخل الطبقة العاملة والكادحين والفُقراء…
تمثّل الفصل الثاني من استفزاز الجزائر في تَوَجُّهِ الرئيس الفرنسي، بداية تشرين الأول/اكتوبر 2021، إلى “الحركِيِّين” (أشخاص جزائريون جنّدهم الإستعمار الفرنسي، خارج إطار الجيش، لقتال المُقاومين الجزائريين) طالِبًا منهم الصّفْح عن إهمال الدّولة الفرنسية لهم ولأبنائهم، بعد استقلال الجزائر، وشكّل هذا التصريح عملية استفزاز جديدة، للدّولة الجزائرية، خلال فترة قصيرة، لتقترب مواقفه من اليمين المتطرف، قبل بضعة أشهر من الإنتخابات العامة، الرئاسية والنّيابية، بفرنسا، سنة 2022.
أما الفصل الثالث فكان تصريح الرئيس الفرنسي “يحكم الجزائر نظام سياسي عسكري، زيّف التاريخ ليكون قائما على قَلْب الحقائق، بل على كراهية فرنسا…”، وأعلن أن الجزائر بلاد وقع اختلاقها، لأنه لم توجد بلاد أو شعب أو أمّة على هذه الرقعة الترابية التي احتلتها فرنسا، لفترة 132 سنة، ولسائل أن يسأل: “من قاوم الإستعمار الفرنسي إذًا، منذ 1830، من الأمير عبد القادر إلى جبهة التحرير الوطني؟ ومن أفشَل مخططات الإستعمار الفرنسي لإلحاق الجزائر بها واعتبارها أرضًا فرنسية؟ واعتبرت السلطات الجزائرية هذه التصريحات خُرُوجًا عن الأعراف، وتدخُّلاً غير مقبول في شؤون البلاد الدّاخلية، خصوصًا بعد الدّعم العلني الفرنسي الرسمي لمجموعة “ماك” الإنفصالية البربرية، وتسببت تصريحات ماكرون في استدعاء الجزائر سفيرها من باريس.
لم يكن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” مُتعاليا، ولم يمتلك الجَرْأة لنقد الولايات المتحدة التي حرمت الصناعات العسكرية الفرنسية من صفقات الأسلحة، بل تنافسه (بدعم بريطاني وكندي وأسترالي) في مُستعمرات فرنسا السابقة، وبدلاً من مُقارعة المُنافسين الأقوياء، يُركز “ماكرون” على منافسة اليمين المتطرف، بإثارة القضايا المفتعلة بشأن الهوية والهجرة ومخاطرها المُفْتَرَضَة على نقاوة “العِرْق الأوروبي” المُفترَض…
فرنسا، خلفية استعمارية:
يُقَدّرُ عدد الجنود الفرنسيين الذين شاركوا في الحرب ضد مُقاوِمِي جبهة التحرير الوطني بالجزائر، بنحو مليونَيْ جُنْدِي، بين سنتَيْ 1954 و 1962، قَتَلُوا نحو مليون ضحية من أفراد الشّعب الجزائري، ولذلك تعتبر الجزائر “إن الإستعمار جريمة ضد الإنسانية”، وبعد ستة عُقُود من استقلال الجزائر، لا تزال هزيمة الإستعمار الفرنسي حاضرةً في الذّاكرة الجَمْعِيّة الفرنسية، تُغذّيها الحَملات المُتَكَرِّرَة ضد المهاجرين، أصيلي المستعمرات الفرنسية من إفريقيا، شمالها وجنوبها، وتزداد حِدّةُ هذه الحَمَلات خلال الفترات التي تَسْبق الإنتخابات، حيث يُعتبَر إصدار التصريحات الكاذبة وإعلان مزيد التّضْييق على المهاجرين، وشتم العرب والمُسلمين، أَيْسَر الطّرق للحصول على أصوات النّاخبين، دون عناء تقديم برنامج لحل مشاكل البطالة والفَقْر ونقص الخدمات العمومية، خصوصًا منذ اندثار اليسار البرلماني الفرنسي، قبل أكثر من عشرين سنة، وانزلاق الخطاب السياسي، والمُمارسة، نحو اليمين، وتحاول معظم القوى السياسية شرعَنَة الحُرُوب العدوانية التي تُشارك بها الجُيُوش الفرنسية، منذ 2001 بأفغانستان، ثم ليبيا واليمن وسوريا، فضلا عن الحروب المستمرة بالعديد من البلدان الإفريقية، والمُستعمرات الفرنسية السابقة، ولا توجد مُعارضة تُذْكَر لهذه الحُرُوب العدوانية، ولا للإحتلال الصهيوني…
في هذا الإطار يتنزّل قرار خفض عدد التّأشيرات الفرنسية (القليلة أصلاً) لمواطني المغرب العربي، وتتنزّل التصريحات الإستفزازية للرئيس اليميني الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، مُمَثِّل مصالح رأس المال المالي، والقادم من مصرف روتشيلد، رمز الإستعمار والصّهيونية، حيث صَرَّحَ: “لقد تم بناء النظام السياسي العسكري الجزائري على ريع الذاكرة وعلى مراجعة التاريخ الرسمي وإعادة كتابته بالكامل، ليكون قائمًا على كراهية فرنسا”، مُتعمِّدًا التّنصّل من مسؤولية الإستعمار الفرنسي في مصير البلدان والشُّعُوب التي عانت من الإستعمار، ومن نهب الثروات، ومن الإستغلال والإضطهاد…
يُمثل تصريح الرئيس الفرنسي إقْحامًا للجزائر في الحملة الإنتخابية الفرنسية، حيث أنْكَر وُجُود “أُمّة جزائرية” قبل الإستعمار الفرنسي (1830)، ونَدّدَ بيان الرئاسة الجزائرية بهذا التصريح واعتبره “غير مسؤول” و “إهانة لأكثر من خمسة ملايين ضحية من الشعب الجزائري للإستعمار الفرنسي، من 12830 إلى 1962…”
أدى تقليص حصة التأشيرة الفرنسية للجزائريين، الذي أعلنه المتحدث باسم الحكومة الفرنسية في 28 أيلول/سبتمبر 2021، ثم تصريحات الرئيس الفرنسي عن “النظام السياسي العسكري” الجزائري ، إلى سحب سفير الجزائر بباريس، وإلى إلغاء اتفاقية 2012 التي تسمح للطائرات العسكرية الفرنسية بعبور سماء الجزائر، لقصف الأراضي المالية، وإلى زيادة توْتِير العلاقات بين الدّولتيْن، وإلى سحب السفير الجزائري من باريس، كما أدّى هذا التّصريح الإستفزازي إلى تحالف سلطات الجزائر ومالي، بعد الأزمة التي سببها انقلاب مالي لحكومة فرنسا المُتورّطة عسكريا بالبلاد، والتي بدأت خسائرها (القليلة) في الأرواح تُؤثِّرُ سلبًا على شعبية ماكرون وحكومته وتياره السياسي، وبثّ التلفزيون الحكومي المالي تصريحا يوم الخامس من تشرين الأول/اكتوبر 2021، لوزير خارجية الجزائر، يدعو إلى “تحرير فرنسا الإستعمارية من عُقَدِها التّاريخية، ومن المهمة الحضارية المفترضة للغرب، والغطاء الأيديولوجي للجرائم ضد الإنسانية، ضد شُعُوب الجزائر ومالي والعديد من الشعوب الأفريقية… لا توجد في السياسة وفي العلاقات الدّولية هدايا مجانية، بل تتسم العلاقات بين الدّول بالإحترام المُتبادَل وبتبادل المنافع، وبناء علاقات الشراكة على أساس المساواة التامة “، وكان الرئيس ماكرون قد صرح يوم السادس من تشرين الأول/اكتوبر 2021 (قناة إذاعة فرنس انتار)، بالتزامن مع بداية إعادة هيكلة الجيش الفرنسي بالنيجر وتشاد، أن لا وجود للدولة ولا للأمن في مالي، ما أدّى إلى استدعاء السلطات المالية السفير الفرنسي لدى مالي، للإستفسار بشأن هذه “التصريحات المؤسفة وغير الودِّية”، ويُشكّل التصريح “غير الودّي” للرئيس الفرنسي، ردًّا على اعتزام حكومة مالي الإستنجاد بشركة أمنية روسية (مُقَرّبَة من حكومة روسيا) لمساعدتها على محاربة المليشيات الإرهابية، شمال البلاد، وذلك بعد أن قدّمت روسيا إلى حكومة مالي أربع طائرات مروحِيّة عسكرية، وتعبير وزير الدّفاع المالي عن شكره لروسيا التي أظهرت “قدرًا كبيرًا من الجدّيّة والنجاعة والمصداقية”…
تتجسّد الخلفية الإستعمارية الفرنسية أيضًا، في الرغبة التي عبر عنها الرئيس الفرنسي ب”مصالحة الذّاكرة” مع الجزائر، والمُراوَحة بين التّصعيد وبيع الكلام المعسول، دون تسديد ثمن الإحتلال والإستعمار الإستيطاني الذي استمر لمدة 132 سنة، وما انجَرّ عنه من مآسي وخسائر كبيرة، يريد “ماكرون” تحميلها للشعب الجزائري وحده، دون تعويضات مالية ومعنوية (احترام تاريخ ونضال وصمود الشعب الجزائري) مكتفيًا بالإعتذار المُخضّب بالإهانات والتّدخّل في الشؤون الدّاخلية للجزائر، واعتيار أي موقف جزائري “كراهية لفرنسا”، وتجدر الإشارة إلى تجاهل الحكومات الفرنسية المتعاقبة الآثار الوخيمة للتجارب النووية في الأراضي الجزائرية، والتي يُعاني سكان جنوب الجزائر نتائجها السلبية حتى اليوم، إلى جانب نتائج التّدمير المُمَنْهج والمجازر والإبادة التي خلّفت ملايين الضحايا بين شُهداء ومثصابين ومُعوّقين ومفقودين…
تأتي تصريحات الرئيس الفرنسي في سياق حملة انتخابية داخلية (فرنسية) يسعى خلالها معظم المرشحين للإتجاه نحو اليمين المتطرف، عبر إقحام الجزائر (حيث فقدت فرنسا مرتبة الشريك التجاري الأول)، وما يعنيه ذلك من تمجيد الماضي الإستعماري، وعبر تحميل المهاجرين، أي الفئة التي تحتل الدّرجات الدُّنْيا من السُّلّم الإجتماعي، عبء الأزمات ومشاكل المجتمع الفرنسي، وتحميل الجزائر مشاكل القوات العسكرية الفرنسية في ليبيا وفي منطقة الصحراء الكبرى… أما الطبقة العاملة والأُجَراء والفُقراء، داخل المجتمع الفرنسي، فإن حُضُورَ مشاغلهم يبقى هلامشيًّا، ولا يُثِيرُها سوى القليل من المُرشّحين، في مناسبات قليلة، ما يؤدّي إلى امتناع الفُقراء عن المُشاركة في العملية الإنتخابية…
الفقر بفرنسا:
تؤكد مختلف المُنَظّمات الاجتماعية الفرنسية، بنهاية شهر تشرين الأول/اكتوبر 2020، نشوء فئة من “الفقراء الجدد”، بأكثر من مليون فرنسي باتوا اليوم تحت خط الفقر، وبحسب بيانات “المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية” (إنسي)، وصل عدد الفقراء في البلاد، بنهاية سنة 2019، إلى 9,3 ملايين شخص، أي ما يعادل 14,7% من مجموع السكّان، وكشف تقرير أصدرته منظمة الإغاثة الكاثوليكية بفرنسا أن عدد الفقراء في البلاد ارتفع خلال 2020 إلى نحو 10 ملايين شخص، بسبب تداعيات جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق الشامل التي فرضتها السلطات لمنع تفشي الفيروس، فزادت حالة الأسر الفرنسية سوءاً، وارفع عدد من يعيشون تحت خط الفقر بالبلاد (من تقل مداخيلهم الشهرية عن ألف و63 يورو) إلى أكثر من عشرة ملايين مواطن سنة 2020، بزيادة نحو سبعمائة ألف شخص، مقارنةً بنهاية 2019، فيما أصبح نحو أربعمائة ألف شخص عاجزين عن تغطية النفقات اليومية للغذاء، خصوصًا مع زيادة نفقات السّكن والكهرباء والتّدفئة والماء والنّقل، ومع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، بنهاية الربع الثاني من سنة 2021، إلى نحو 4,5 ملايين، فضلاً عن المُعطّلين غير المُسجّلين أو غير المُعترف بهم رسميا…
نشر موقع الحكومة الفرنسية ( Vie Publique ) يوم 24 أيلول/سبتمبر 2021، مُلخّصًا لعدد من الدراسات الحكومية التي تُشير إلى تزايد نسبة الفقر بين السكّان، من حوالي 14,8% من السّكّان، بنهاية سنة 2018، إلى نحو 20% بنهاية 2020، إثر سنة اتّسمت بانتشار وباء “كوفيد-19” وتسريح آلاف العاملين وعجز العديد من الأُسَر عن تسديد إيجار المسكن وثمن استهلاك الطاقة والغذاء، ونشر مجلس الشيوخ تقريرًا يوم 15 أيلول/سبتمبر 2021، يُشير إلى ارتفاع نسبة البطالة أكثر مما توحي به البيانات الرسمية، وإلى انتشار الفقر والعمل الهش الذي يُعتَبَرُ بوابة الفقر، وخصوصًا في أوساط الشباب الذين ارتفعت نسبة بطالتهم لتزيد عن العشرين بالمائة، وأشار تقرير مجلس الشيوخ أن ما لا يقل عن 20% من الفرنسيين يعدُّون أنفسهم فُقراء، بسبب البطالة أو هشاشة العمل، والعقود قصيرة الأجل (أقل من ثلاثة أشهر) والعمل بدوام جزئي ، والنشاط غير المستقر، ويجد الأُجراء والعاطلون عن العمل والفُقراء صعوبات كبيرة في الحصول على السكن، بسبب ارتفاع إيجار المسكن وثمن الطاقة، وعجزت حوالي أربعة ملايين أُسْرة عن تسديد ثمن الوقود والتيار الكهربائي والتدفئة، سنة 2019، قبل انتشار وباء “كوفيد-19” وما صاحَبَه من بطالة وفقر…
نشر موقع “مرصد عدم المساواة ” يوم الخامس من تشرين الأول/اكتوبر 2021، تقريرًا يُشير إلى الإرتفاع المُستمر لنسبة البطالة والفقر منذ 2004، ويُشير التقرير إلى تعميق الفجوة الطبقية، حيث وزّعت الدّولة المال العام على الأثرياء، من أصحاب الأسهم بالشركات الكبرى والمصارف، خلال أزمة 2008/2009، وكذلك أثناء أزمة “كوفيد-19” ( 2020 و 2021) فيما لم تحصل الفئات الأكثر هشاشةً وفقرًا على دعم الدّولة، بل ازداد وضعها سوءًا، وأعلنت معظم مؤسسات البحث والدراسات أنها لا تمتلك تقديرات دقيقة للوضع خلال سنتَيْ 2020 و 2021، وقد تُعرقل الحُكُومة صُدُور هذه البيانات، التي يُتوقّع أن تكون سيئة، نظرًا لاقتراب موعد الإنتخابات العامة (نيسان/ابريل وأيار/مايو 2022)، وتُشير معظم التوقعات والتّقديرات الأوّلية إلى ارتفاع عدد الفُقراء، سنة 2020، بحوالي 1,3 مليون فقير “جديد”، وإلى انخفاض مستوى الدّخل، بمعدّل 8% كنسبة متوسطة، وترتفع النسبة لدى الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشةً، فيما يواجه العديد من العاملين الذين فقدوا وظائفهم صعوبات بالغة للحصول على عمل جديد، فضلاً عن الذين تم استبعادهم من “سوق العمل”، بسبب انعدام الكفاءة والخبرة…
عُمومًا، أجمعت الدّراسات المنشورة، على تدهور الوضع الاجتماعي للشرائح الإجتماعية الأكثر هشاشة، وكذلك للشباب والنساء، وعلى ارتفاع أعداد طالبي المساعدة الخاصة بالعاطلين من العمل، بسبب تدهور وضع العاملين بقطاعات كانت توظّف أشخاصاً ينتمون إلى هذه الشرائح، مثل قطاعي السياحة والمطاعم، وكذلك العمال والموظفين الذين لا تشملهم المُساعدات أو لا يستفيدون من حماية اجتماعية كافية، مثل المتعاقدين والمياومين والأشخاص الذين يعملون من دون تصريح رسمي، فنظام الحماية الإجتماعية لا يشمل سوى الأشخاص المحميين، أي غير المُهمّشين، مثل موظفي القطاع العام والعاملين بحسب عقود، ما يزيد من حِدَّةِ التفاوت الاجتماعي والفقر، وأوردت نشرة مؤسسة الإحصاء “إنسي” ( INSEE ) يوم الخامس من تشرين الأول/اكتوبر 2021، بيانات أظْهَرت وجود 9,2 ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر، أي بدخل شهري يقل عن 1102 يورو، بنهاية سنة 2019، أي قبل انتشار وباء “كوفيد 19″، وتُقدّر بعض الدّراسات ارتفاع العدد، بنهاية سنة 2020 إلى نحو 13 مليون شخص، أو ما يعادل 20% من العدد الإجمالي للسّكّان، بعد موجة التّسريح وفقدان الوظيفة، بالتوازي مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، أي ثروة البلاد، بنهاية سنة 2019، إلى نحو 2,332 تريليون يورو، وهو أعلى مستوى بلغه الإقتصاد الفرنسي (الناتج المحلي الإجمالي)، بحسب البيانات الرسمية التي نشرتها مؤسسة الإحصاء، بالمُقابل، تم تدمير ما لا يقل عن 715000 وظيفة بفرنسا، خلال النصف الأول من سنة 2020، ويُعتَبَر الحرمان من العمل أهم أسباب انخفاض (أو انعدام) الدخل والثروة ، وأكّدت دراسة استقصائية نشرها مجلس التحليل الإقتصادي ( CAE )، بنهاية 2020، أن السكان الأكثر هشاشة اقتصاديًا واجتماعيًا قد تضرروا بشدة خلال فترات انتشار الأوبئة والأزمات، التي زادت من حدّة الفوارق، فارتفعت ثروة الأثرياء بفعل الميراث (وليس بفعل العمل) وبفضل الإعفاءات الضريبية، فانخفض دخل خُمُس الفرنسيين (20% ) بنحو 2 مليار يورو خلال فترة الحبس الأول (ربيع 2020)، بينما ارتفعت ثروة نسبة 10% من الأكثر ثراءً، بأكثر من 25 مليار يورو، وارتفعت ثروة هؤلاء الأثرياء بقمة 175 مليار يورو، خلال تسعة أشهر، من “نيسان/ابريل إلى كانون الأول/ديسمبر 2020، وفقا لدراسة مجلس التحليل الاقتصادي.
أكّد تقرير منظمة “أوكسفام”، الصادر بداية سنة 2021، بعض الأرقام عن الفقر بفرنسا، وزيادة مظاهر عدم المساواة، فمنذ بداية الأزمة الصحية (كورونا)، وقع مئات الآلاف من الناس في براثن الفقر بينما وصلت ثروات المليارديرات إلى أرقام قياسية جديدة، لِيُشكّل الوباء أزمة صحية، وكذلك أزمة اقتصادية واجتماعية، أكّدتها مديرة صندوق النقد الدولي، التي أعربت عن تخوفاتها من أن “يُؤدّي تزايد التفاوتات إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية”، وقدّرت الجمعيات الخيرية العاملة بفرنسا ارتفاع عدد طالبي المساعدات الغذائية من 5,5 ملايين شخص في خريف 2018 إلى أكثر من ثمانية ملايين، في خريف 2020، فضلاً عمّن لم يطلبوا مثل هذه المُساعدة، كما قدّرت ارتفاع عدد فاقدي المأوى بنحو ثلاثمائة ألف، في أيلول/سبتمبر 2020، منهم 31 ألف طفل، فضلاً عن أؤلئك الذين لم يتّصلوا بالمنظمات الخيرية، ولم يطلبوا مساعدة.
دعمت الخيارات السياسية للحكومة الفرنسية (وحكومات العالم الأخرى أيضًا) والمصرف المركزي الأوروبي (عبر إعادة شراء الأُصُول) زيادة ثروة الأثرياء، وتدهور وضع الكادحين والفُقراء، ورفضت الحكومة الفرنسية مقترحات النقابات والمنظمات غير الحكومية، والرأي العام، لإدخال التعديلات على مشروع قانون المالية لعام 2021 لكي يتجه إنفاق المال العام نحو القطاعات الصحية والبيئية والإجتماعية، بدل توزيع المال العام على الأثرياء، وبذلك سمحت خطط الحكومة (خفض الضرائب، بل الدّعم المالي للشركات والأثرياء) لثروات المليارديرات بالإرتفاع، في ذروة أزمة 2008/2009، كما في ذروة أزمة انتشار وباء “كوفيد 19”.
قَدَّرَ المعهد الوطني للإحصاء عدد العاطلين عهن العمل، بنهاية سنة 2020، بنحو 5,4 ملايين عاطل، مُسجلين لدى مكتب البطالة والتأهيل ( Pôle Emploi ) ويعسر تقدير عدد من لا يحتسبهم المكتب في بياناته، لأنهم لم يشاغلوا مُدّة كافية للحصول على إعانة، أو انتهت فترة حصولهم على الإعانة، وقدّرتهم إحدى جمعيات المُعطّلين بنحو ثلاثة ملايين إضافيين سنة 2020، وهو الرقم الذي توصّل إليه “مرصد التفاوتات” ( Observatoire des Inégalités ) الذي أكّد على ارتفاع نسبة بطالة الشباب، من الجنْسَيْن، وخاصة الوافدين الجدد على سوق العمل، واضطرّوا إلى الإنسحاب، بسبب انتشار وباء “كوفيد 19” وإغلاق دواليب الإقتصاد الذي استفاد منه الأثرياء، بحسب دراسة نشرتها شركة الإستشارات ( PrincewaterhouseCoopers ) ومصرف “يو بي إس” السويسري، تُشير إلى الثروة التي تراكمت بين شهْرَيْ شباط/فبراير وكانون الأول/ديسمبر 2020، لدى أصحاب المليارات الفرنسيين، وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وعلى سبيل المقارنة، ارتفعت أُصُول الثروات الفرنسية الكبيرة بقيمة 300 مليار يورو سنة 2019، وبلغت قيمة الإرتفاع 442 مليار يورو سنة 2020…
لا تتطرّق مداخلات المترشّحين الفرنسيين للإنتخابات إلى مثل هذه المواضيع (الفقر والبطالة وتعميق الفَجْوة والتفاوتات الطّبقية…)، وأصبحت الحملة الإنتخابية، منذ سنة 2002، تقتصر على المُزايدات برفع شعارات تتراوح بين اليمين واليمين المتطرف، وتهميش بعض المُرَشّحين الذين يُحاولون طرح مشاغل الطبقة العاملة والكادحين والفُقراء…
بدأ الرئيس “إيمانويل ماكرون”، ممثل رأس المال المالي، حملته مُبكِّرًا، واستغلّ فترة انتشار الوباء ليزيد من الإجراءات الزّجْرِيّة ومن فرض الرقابة والمراسيم التي تُجيزها حالة الطّوارئ. أما بخصوص السياسات الخارجية فقد دخل في مزايدات مع اليمين المتطرّف، فهاجم الجزائر، الشعب والدّولة والوطن، وليس نظام الحكم، وهو على أي حال شأن جزائري داخلي، ودغدغ مشاعر العنصريين بشأن خَفْض عدد التّأشيرات الخ.
أما المطلوب من التّقدّميين الفرنسيين فهو طرح مسائل التفاوتات المجحفة، والبطالة والفقر والمسكن والصحة والنقل العمومي، وربط هذه القضايا الدّاخلية بضرورة التضامن مع الشعوب الواقعة تحت الإستعمار والهيمنة، والتي تستغل الشركات العابرة للقارلات ثرواتها، ولا بُدّ من الجرأة لطرح مسألة حُرّيّة التنقل، داخل نفس البلد أو بين الحدود، كحق من حُقُوق الإنسان…
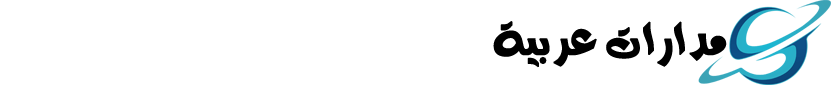

التعليقات مغلقة.