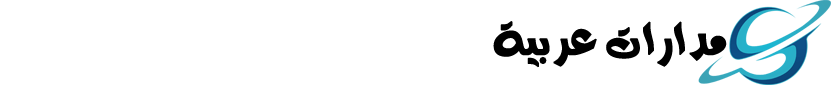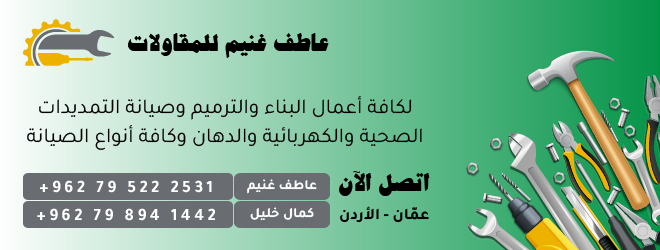14 عاماً على “حركة 20 فبراير” في المغرب… التاريخ الذي تأخّرنا في كتابته / عماد استيتو
بالنسبة إلى الدولة، هي أحداث لا يجب أن تُذكر، و الأهم من كل شيء: يجب ألا يتكرر ما حصل قبل 14 سنةً من اليوم بالتمام و الكمال. وإذا كانت الدولة تتعامل معها كأنها صفحة يجب طيّها أو نسيانها، أو حتى محوها تماماً من التاريخ الوطني الحديث، ففي الجهة المقابلة لا يبدي الفاعلون الرئيسيون في هذه “الأحداث”، باختلاف توجهاتهم ومواقعهم، أي ممانعة ومقاومة في اتجاه يسمح في أسوأ الظروف وعلى الأقل، بالتجميع والأرشفة وتوفير مادة صالحة للأجيال المقبلة للبناء عليها.
نحن اليوم على مسافة معقولة جداً من الحدث؛ أزيد من 14 سنةً مرت على الخروج الأول لـ”حركة 20 فبراير” إلى الشوارع، وهي النسخة المغربية مما عُرف بـ”الربيع العربي”. ومع ذلك ليست لدينا إلى حدود اللحظة، سوى محاولات محتشمة جداً ومعدودة على رؤوس الأصابع، لكتابة تاريخ الحركة، أو لنقل للتدوين عن ذاكرة الحركة، لأنّ كلمة “تاريخ” -التي سأستعملها كثيراً في هذا المقال- قد تكون مربكةً بعض الشيء، أو ذات حمولة ثقيلة.
النفور من الكتابة
لا أتحدث هنا عن القراءات السياسية أو العلمية اعتماداً على أدوات العلوم الاجتماعية، فهناك بالتأكيد العشرات من الدراسات التي كُتبت في هذا الصدد، بصرف النظر عن جودتها ومضمونها ومدى صوابيتها، لكنني أقصد تحديداً ما لم يكتب عن التفاصيل اليومية لهذه الحركة الاحتجاجية وأدوار مختلف الفاعلين فيها، وأعني تلك الكتابات الذاتية التي يروي فيها كل فاعل من موقعه، الأحداث كما عاشها وتعايش وتفاعل معها هو، سواء بوصفه فرداً مستقلاً ومنفرداً بتصوراته أو منتمياً إلى جماعة من تلك الجماعات الكثيرة التي شكلت التركيبة الفريدة والعجيبة لـ”حركة 20 فبراير”.
قد يكون فعل التذكر شديد العنف ومصيباً بالرهبة من دون أدنى شك، لكنه امتحان عسير لا مناص من تجاوزه، ولا بد من التوقف عن محاولات الهروب السنوية المستمرة منه.
يحتاج الفاعلون في “حركة 20 فبراير” أو “حركات 20 فبراير” -وهذه تيمة أخرى تستحق هي الأخرى نصيبها من التدوين وتسليط الضوء- إلى الخروج من مناطق الراحة التي صنعوها حولهم طوال العقد ونصف العقد الماضيين، بالتجاهل المتعمد لسرد الوقائع والاقتصار عند الحديث عن التجربة على ثنائيات كلاسيكية عقيمة: المكسب والخسارة، النجاح والفشل، الصراع بين الإسلاميين واليسار، نهاية الحركة واستمراريتها، الجذرية والإصلاحية… وغيرها من السجالات التي لا تذهب بنا إلى أي مكان.
يحتاج الفاعلون في “حركة 20 فبراير” إلى الخروج من مناطق الراحة التي صنعوها حولهم، بالتجاهل المتعمد لسرد الوقائع والاقتصار عند الحديث عن التجربة على ثنائيات كلاسيكية عقيمة: المكسب والخسارة، النجاح والفشل، الصراع بين الإسلاميين واليسار، نهاية الحركة واستمراريتها، الجذرية والإصلاحية…
خلال كل هذه السنوات الأخيرة التي مرت على هذه اللحظة الوطنية الفارقة، حولت الأطياف المختلفة والمتنوعة من تركيبة “20 فبراير”، تاريخ الذكرى السنوية، إما إلى مناسبة لتنظيم فعاليات لتخليد ذكرى “الحركة المجيدة”-وهو بكل تأكيد أمر بالغ الأهمية لحفظ الذاكرة الجمعية- أو لتجديد تبادل الاتهامات الموسمية بين مختلف الأطراف، حول مسؤولية فتور المخاض الاحتجاجي.
وفي كل سنة، تخوض التيارات المتنافرة الحروب نفسها بشكل مرضي مكرور. الجميع يبحث عن إثبات الشرعية، وعن تأكيد الأحقية في الانتساب الأكثر صدقاً ونقاءً إلى الفكرة العامة للحركة. يشترك في ذلك الثوريون والإصلاحيون، اليساريون والإسلاميون، الأفراد المستقلّون والمنتظمون سياسياً، وشباب الحركة وشيوخها.
ولربما كان هذا وجه الاتفاق الوحيد بينهم؛ اتفقوا على أن يتفقوا على الاختلاف داخل فضاءات محددة سلفاً من الممنوع السباحة خارجها، ما يجعل هذا اللغط لا يعدو أن يكون محاولات يائسةً للتنفيس أو العلاج من تروما لم يخرج منها أحد سالماً، لا أحد فعلاً من هؤلاء جميعاً كان يتوفر على فائض من الجرأة، لأن يجعل التاريخ غير المكتوب متاحاً للعموم، ولأن يتم التعبير عن وجهات النظر والتقييمات المتباينة والمتناقضة جميعها من داخل سرديات مكتوبة أو مروية على لسان الفاعلين، وأن يترك الحكم عليها في النهاية للجمهور ليتبنى أو يرفض منها ما يراه لائقاً.
لا أحد من تركيبة 2011، يريد المجازفة بنفض الغبار عن تلك الدفاتر القديمة للحركة. لا يمكن تفسير الأمر حصراً برغبة في احتكار هذا التاريخ، أو حصر المساحات العلنية للخلاف بين مكونات الحركة في حدود دنيا، أو حتى بكسل هؤلاء الذين كانوا فاعلين رئيسيين في قرارات واختيارات الحركة، ولكن يمكن المغامرة بالقول إن ذلك راجع أساساً إلى عدم وعي هؤلاء الفاعلين بأهمية وحيوية موقعهم داخل تلك الأحداث، وما يستوجبه ذلك منهم من تحمّل للمسؤولية ونقل للأمانة، بغض النظر عما إذا كانت تلك الأحداث وليدة لحظة عاطفية وعفوية أو نتاج صيرورة مؤسس لها ولم تكن من وحي التلقائية.
لا أحد من تركيبة 2011، يريد المجازفة بنفض الغبار عن تلك الدفاتر القديمة للحركة.
صراعات حول تاريخ لم يدوَّن
من المفارقات اللافتة خلال كل تلك السنوات، أنّ حديثاً متواتراً ومستمراً في الزمان، كان يجري استهلاكه بين كل تلك الأطراف المتضادة اليوم، والتي جمعتها ذات يوم لحظة غواية جميلة. كان هذا الكلام متمحوراً حول عنوان بارز: “محاولات تزوير تاريخ الحركة”، وهو امتداد طبيعي للحظات توتر مماثلة عرفها مسار الحركة، حيث تم الانتقال إليه من تعبيرات كانت شائعةً خلال الأشهر الأولى للحركة: “الركوب على مطالب الحركة”، “اختراق الحركة”… إلخ. كان كل طرف ينتقي من هذه التعبيرات ما يناسب طرحه ومواقفه.
المثير للسخرية في الأمر هنا، أنها خصومة على تاريخ لم يُكتب ولم يُروَ حتى الآن من هؤلاء الفاعلين. في الواقع، كل ما لدينا الآن بين أيدينا هو ملخصات مختصرة وركيكة للأحداث لا تشفي الغليل والفضول، وتركّز على العناوين والشعارات الكبيرة ولا تقف عند التفاصيل الصغيرة والدقيقة. لا وجود لأي صراع بين سرديات من داخل الحركة، ويبقى الصراع في المربع ذاته محصوراً في التنابذ اللفظي، وفي أكثر اللحظات سخونةً ينتهي الأمر إلى التهديد بنشر “الغسيل القذر” دون تقديم توضيحات كافية. الجميع يقول إنه يعرف الآخر جيداً، ويقف الأمر هنا، فيبدو الأمر وكأنه عراك شوارع وليس خلافاً على رؤى معينة.
دعونا نتفق، أنه لا يمكن أن تكون هناك رواية واحدة للأحداث، ومن الطبيعي أن تكون هناك روايات متعددة لوقائع عاشها كل بطريقته. لا يمكننا أن نعيش اللحظة بالكيفية ذاتها، كما أنّ التاريخ شديد الالتباس والنسبية، وهذا كله ليس مهماً، فالاختلاف لا يزال قائماً حول ما جرى قبيل استقلال المغرب وبعده من أحداث، وللفاعلين في الحركة الوطنية والمقاومة المغربية بخصوصه جميعاً حكايات ومرويات متنافرة، لم يُحسم الجدل التاريخي وربما لم يُروَ كل شيء ولم تتوقف معارك السرديات، ولن تتوقف.
ما نحتاج إليه اليوم، هو أن نتملك كل هذه الروايات التاريخية المتضاربة عن الحركة الاحتجاجية، بين أيدينا، وأن يطلق الذين كانوا فاعلين فيها سراح أنفسهم أولاً، قبل إخراج تلك الدفاتر المغبرة التي يتعاملون معها وكأنها أسرار دولة من الرفوف. علينا كذلك أن نُخرج من ثنائية تقديس الحركة في مقابل جلدها الذاتي، و كتابة/ رواية التاريخ، مساحةً وسطى تستوعب كل تلك التعقيدات.
نريد مثلاً أن نعرف أكثر عن طبيعة الحوارات وسقف النقاشات داخل تلك المجموعات الافتراضية كـ”مغاربة يتحاورون مع الملك”، التي ظهرت قبيل الحركة، ولماذا اختفى أو غيّب بعض الفاعلين فيها؟ وهل هي الحركة نفسها التي خرجت بنداء الدعوة إلى الاحتجاج يوم “20 فبراير” أو يتعلق الأمر بحركة أخرى؟
أسئلة معلّقة
نريد مثلاً أن نعرف أكثر عن طبيعة الحوارات وسقف النقاشات داخل تلك المجموعات الافتراضية كـ”مغاربة يتحاورون مع الملك”، التي ظهرت قبيل الحركة، ولماذا اختفى أو غيّب بعض الفاعلين فيها؟ وهل هي الحركة نفسها التي خرجت بنداء الدعوة إلى الاحتجاج يوم “20 شباط/ فبراير” أو يتعلق الأمر بحركة أخرى؟… وهل كانت الحركة حركةً أسسها شباب مستقلّ التحقت بها التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية لاحقاً، أو كانت صبغة الشبابية مجرد صنيعة إعلامية؟
كذلك، من حسم الشعارات الرئيسية للحركة؟ وماذا عن آليات اتخاذ القرارات واختيار نقاط التظاهر التي كانت تُتّخذ حسب بعض الروايات في “خلايا صلبة” و”مجالس دعم” بعيداً عن الاجتماعات؟ وما مساحات الاتفاق بين شباب الحركة وشيوخها؟ ومن أثّر في من؟
ما حدود ارتباط بعض رجال الأعمال مثل كريم التازي وميلود الشعبي بالحركة؟ وما هي حقيقة التواصل مع بعض السفارات الأجنبية؟ وهل راهنت جماعة “العدل والإحسان” الإسلامية فعلاً -أو تيار فيها على الأقل- على الحركة لتحقيق اختراق ثوري، وانسحابها المفاجئ من الاحتجاجات -الذي كان مفاجئاً حتى لمنتسبيها- جاء بعد أن تأكدت من حدود أفق الاحتجاجات كحدث تنفيسي فقط، وليس بسبب الخلافات بينها وبين اليسار داخل الحركة؟ وكيف عرّى ذلك الحجم الحقيقي لليسار وضعف قاعدته الشعبية؟ وهناك سؤال صراع “الهوندا” (منصة إلقاء الشعارات) في تجربة الدار البيضاء؟ وكيف كانت محددةً؟ والظهور العجيب لتيار “أحرار 20 فبراير” في لحظات تراجع الوجود الميداني للحركة في العاصمة الاقتصادية؟…
ويبقى اختراق أجهزة الدولة للحركة أو لعناصر من الحركة أكثر الموضوعات الغامضة في مسار الحركة، فمن غير الواضح تماماً ما إذا كان قد جرى تضخيم هذه الأطروحة، أو أنها تنبني على وجاهة، وتجد دليلها بعد ذلك في انضمام عدد من شباب الحركة إلى أحزاب موالية للدولة، أو استفادة بعضهم من “إتيكيت” الحركة للترقّي مهنياً أو اجتماعياً في وقت لاحق.
من حسم الشعارات الرئيسية للحركة؟ وماذا عن آليات اتخاذ القرارات واختيار نقاط التظاهر التي كانت تُتّخذ حسب بعض الروايات في “خلايا صلبة” و”مجالس دعم” بعيداً عن الاجتماعات؟ وما مساحات الاتفاق بين شباب الحركة وشيوخها؟ ومن أثّر في من؟
في الأسابيع الأخيرة، فقدنا أسامة الخليفي، أحد الوجوه الإعلامية للحركة في الرباط، بعد معركة أخيرة مع السرطان. كان أسامة من أوائل المتحمسين المتقدمين لإعلان بيان تمرّد هذا الجيل الذي يريد فرض شروطه الجديدة. بشكل مؤسف أعمته أضواء الصحافة سريعاً، ووجد نفسه مرغماً في ثوب القيادة. دور ظلمه كثيراً، وسرعان ما تلقفه التجار والوسطاء المحترفون وأدخلوه إلى ملعب السياسة الرسمي الملوّث. تاه فيه أسامة، وخانته قلة تجربته. لفظوه وأصابه ما أصاب الكثير من شباب التجربة بعد أن جاء الجزر موحشاً، ولربما كانت متاهة أعراض ما بعد اللحظة/ الغواية على أسامة، أقسى مما كانت على غيره دون أن ينتبه إليه أحد وسط الزحمة.
لم يسعف الموت أسامة الخليفي، لرواية تجربته الذاتية الخاصة، كما لم يمهل الموت قبله رفيقته غزلان بن عمر، الناشطة البارزة في الحركة في مدينة الدار البيضاء، التي انضمت إثر ذلك في تجربة لم تعمّر طويلاً، إلى الحزب الاشتراكي الموحّد، أحد الأحزاب اليسارية المناضلة التي استقطبت إليها عدداً من شباب الاحتجاجات، وهي تجربة فاشلة لم يُكتب عنها شيء حتى الآن.
لكن وجب الاعتراف بأنّ جميع التساؤلات السابقة تهيمن عليها مركزية مفرطة لم ينجُ من ورطتها أي أحد منّا، ومنهم صاحب هذا المقال. فقد اختُزلت الحركة مكانياً دائماً في ثنائية الرباط-الدار البيضاء، وفي الوجوه الإعلامية التي احتلّت وسائل الإعلام المحلية والدولية، وقد أسهمت الصحافة بشكل كبير في ترسيخ هذا الطابع المركزي والنخبوي للحركة في التصور العام، برغم المحاولات التي قامت بها يومية “أخبار اليوم” عبر مراسليها في ربوع البلاد، لتغطية الاحتجاجات في مختلف المناطق المغربية.
إن كتابة هذا التاريخ، ولو بدت محاولةً بائسةً للتداوي، هي الخطوة الأولى لأي تمرين أو تدريب على مناورة جديدة من أجل خوض معركة التغيير.
ورطة “خطاب 9 مارس”
حتى حينما كانت الحركة في أوجها في طنجة، شمالي المغرب، على سبيل الذكر، وفي مدن أخرى، كان التركيز دائماً يتم على المركز كدليل على انحسار الحركة وتراجعها، حتى من طرف الإعلام المتعاطف معها.
تشكّل ذلك الخطاب بشكل بارز بعد كلمة الملك محمد السادس، في 9 آذار/ مارس 2011، والتي أعلن فيها عن إصلاحات دستورية وسياسية. بالنسبة لفئات واسعة -خصوصاً من الطبقة المتوسطة -استجاب الخطاب للمطالب الرئيسية للحركة، ولم يحدث ذلك لا في مصر ولا في تونس ولا في ليبيا التي كانت تستعد لدخول نفق قاتم… حصل هذا قبل أن تستخدم الثورة السورية للتهويل ولإقبار الاحتجاجات، كانت كلمة السر واضحةً: “هل تريدوننا أن نصبح مثل سوريا”.
يعكس مانشيت يومية “أخبار اليوم”، في ليلة الخطاب، هذه القراءة، إذ أصدرت الصحيفة المستقلة المؤيدة للاحتجاجات عدداً خاصاً عنوانه الرئيس: “الملك أسقط النظام”. استمرت الصحيفة في تغطية الاحتجاجات بشكل إيجابي منحاز إليها، لكن تأثير 9 مارس كان بادياً، وكأنّ الجميع بات ينتظر انتهاء التظاهرات والانتقال إلى أشياء أخرى. كأنها كانت حركة طبقات وسطى انتهت بتراجع حماسة هذه الطبقات بعد هذا التاريخ. كان الحديث قد بدأ يبتعد تدريجياً عن الجذور السياسية والاجتماعية والطبقية للاحتجاجات.
يجرّنا هذا إلى “تيمة” أخرى تم تجاهل الكتابة عنها أو روايتها كثيراً، إما سهواً أو عمداً، وهي كيفية تفاعل مختلف مكونات تركيبة 20 فبراير، مع خطاب الملك، وإلى أي مدى كان ذلك مؤثراً في مسار الحركة بعدها، وفي التغافل عن دينامية الاحتجاجات التي كانت أكثر نشاطاً وحركيةً واشتعالاً في الهوامش وفي مدن أخرى كبرى خارج محور البيضاء-الرباط. ويقود هذا كله أيضاً إلى سؤال آخر لم يُطرح بالشكل الكافي: هل كانت حركة 20 فبراير حركةً وطنيةً منسجمةً مطلبياً وسوسيولوجياً؟ أم جماعات منفصلة بخصوصيات محلية وإن توافقت على الخطوط الكبرى؟
ما زلت أتذكر شخصياً مخاوف والدي من ذلك اليوم المعلن للاحتجاج، ومن احتمالات إطلاق الرصاص الحي. لم يكن ممكناً محو ذاكرة نظام الحسن الثاني، برغم محاولات تجميل العهد الجديد. لكننا توقعنا في أقصى الحالات قمعاً عنيفاً للمظاهرات واعتقالات.
كان يوماً مجهول الهوية، لكن ولحسن الحظ، بدا أنّ الدولة بأكملها لم تكن على قلب رجل واحد في كيفية مواجهة هذا الخروج الجماعي إلى الشارع. انتصر في النهاية تقدير معتدل بترك الأمور تسير ومراقبتها. مرّت التظاهرات في المراكز بسلام على عكس الحسيمة في ريف المغرب، التي توفي فيها خمسة مواطنين بشكل غامض في إحدى الوكالات البنكية. هذه كذلك واحدة من الأحداث غير المفهومة في تاريخ الاحتجاجات، وستشهد الحسيمة، ست سنوات بعد ذلك، أكبر حركة احتجاجية في عهد الملك محمد السادس.
التقدير نفسه من داخل الدولة سيفرز في النهاية خطاب 9 مارس، في واحدة من اللحظات النادرة التي يوجه فيها رئيس الدولة خطاباً خارجاً عن المناسبات الاعتيادية الرسمية. وسيكون وراءه بحسب ما ذكر حينئذ في الصالونات، ولم يؤكده أو ينفه أحد، المستشار الملكي والخبير الدستوري محمد المعتصم. اختفى بعدها الرجل عن الأنظار، وسيشاع لاحقاً أنه تعرّض للتهميش بعد أن اتّضح أنّ تقديره المنطلق من خوفه على الملكية كان أكبر من قدرة الاحتجاجات على إيذاء النظام، ولدينا هنا أيضاً سردية غير مروية لفاعلين من داخل الدولة كانوا في اشتباك مباشر مع حركة 20 فبراير.
اليوم، وبعد انصراف 14 عاماً على هذه الوقائع، لم تزُل الأسباب التي قامت من أجلها حركة 20 فبراير. المناخ يشبه تماماً الهدوء الخادع الذي كان سائداً في سنة 2010، لكن موازين القوى مختلفة هذه المرة
اليوم، وبعد انصراف 14 عاماً على هذه الوقائع، لم تزُل الأسباب التي قامت من أجلها حركة 20 فبراير. المناخ يشبه تماماً الهدوء الخادع الذي كان سائداً في سنة 2010، لكن موازين القوى مختلفة هذه المرة. في 2011، كانت الدولة متفاجئةً بعض الشيء، لقد تركت بعض الثغرات، من بينها الهوامش المسموح بها للصحافة وبعض الأصوات النقدية، للاشتغال.
لا تكرر الدولة الخطأ نفسه اليوم. تحليلها يقول إنّ هذه الثغرات كانت من بين أسباب نشوء الحركة الاحتجاجية في ذلك العام الذي لا يسمّى. أحكمت قبضتها على المجال العام، وزجّت بالصحافيين المستقلّين والمدوّنين في السجون لسنوات طويلة، قبل أن تمتّع بعضهم بنصف حرية بعد أن نزعت منهم قدرات تشكيل الخطر.
الآن، تفكر الدولة فقط في تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم. هذه هي أولوياتها. بعد التطبيع مع إسرائيل وتوطيد العلاقات مع أمريكا وفرنسا وإسبانيا، الدولة في حالة ارتياح وأقرب إلى العطالة. النقاش العمومي يتراجع في البلاد والسياسة في حالة موت سريري. السلطوية والمقاربة الأمنية منتصرتان بالنقاط حتى الآن، بل هناك نبرة انتشاء وتعظيم للحظة.
لكن هذه اللحظة فرصتنا الوحيدة للاستفادة من وقف إطلاق النار الهشّ هذا. يبدأ ذلك حتماً بكتابة هذا التاريخ الذي لم يدوَّن بعد، ولو بدا ذلك مجرد إنعاش للذاكرة أو عويلاً من دون جدوى.
لا بأس، لكن كتابة هذا التاريخ، ولو بدت محاولةً بائسةً للتداوي، هي الخطوة الأولى لأي تمرين أو تدريب على مناورة جديدة من أجل خوض معركة التغيير، وإلا ستظلّ سردية الدولة السردية الوحيدة السائدة. وحدها الدولة كتبت سرديةً بعد مراجعات طويلة للنص. قد نحتاج بعد هذا إلى إيجاد خيال جديد، لكن 20 فبراير 2011، لم تكن أحداثاً هامشيةً أبداً.