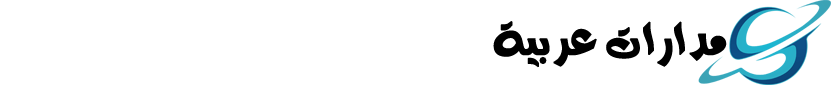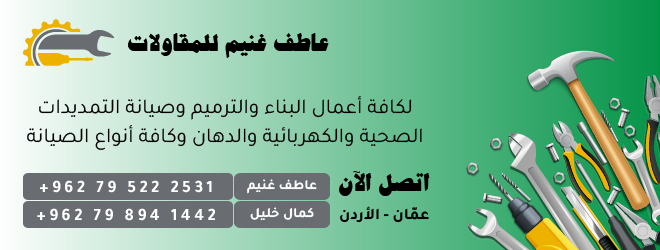الأول من أيار/ مايو 2025 … تكريمًا للعمال غير المستقرين / الطّاهر المعز

الطّاهر المعز ( تونس ) – الخميس 1/5/2025 م …
كان الأول من أيار/مايو في الأصل يوم نضال من أجل حقوق العمال والعاملات، وتحول مع مرور الزمن إلى “احتفال” و “يوم عيد” و”عطلة رسمية” في العديد من البلدان، وتم إهمال نضال الإشتراكيين والإشتراكيات، منذ القرن التاسع عشر من أجل تخصيص يوم لتخليد تضحيات العمال والعاملات…
لهذا السبب خَصّصتُ هذه الورقة للقطاع الموازي العربي والعاملين به من فاقدي الحقوق والمُهَمّشين، وخصصت القسم الثاني للعمالة الهشة في الدّول الرأسمالية الإمبريالية
1 – الإقتصاد الموازي والعمل الهش في الوطن العربي
الإقتصاد المُوازي هو نشاط اقتصادي غير مُعْلَن عنه لدى أجهزة الدّولة، وبالتالي فهو يقع خارج إطار القانون الذي يفرض تطبيق قوانين العَمل وتسجيل أي نشاط اقتصادي لدى إدراة الضرائب، مما يُشَوِّهُ عملية التّراكم الرأسمالي ويُحوِّلُ عملية الإستغلال التي يتميز بها النظام الرأسمالي إلى عملية “تهميش”، وأدت السياسات الإقتصادية التي فرضها صندوق النقد الدولي (ذراع الإمبريالية) منذ حوالي أربعة عقود (منذ بداية سياسات “الإنفتاح الليبرالي”) إلى إضعاف قدرة الدولة على فرض إطار قانوني لمراقبة الإجور والأسعار وتعديلها، وتغييب مراقبة المَعايير بشكل عام، واقتصار دور الدّولة على القمع وحماية رأس المال، فَتَعَاظَمَ دور الإقتصاد غير الرّسمي في البلدان العربية وأصبح يُشكل ما بين 40% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي (بما في ذلك في البلدان النفطية)، مما أثّر في البُنْيَة الإقتصادية وفي علاقات العمل، ومما أضْعَفَ دور النّقابات ومنظمات حماية العمال والمُنْتِجِين والمُسْتهلكين، ويعود السبب الرئيسي لازدهار الإقتصاد الموازي إلى انهيار الإقتصاد الرّسمي، ويُساهم ازدهار الإقتصاد غير الرسمي في إعادة إنتاج الإنهيار، وكلما زادت حصته من الناتج المحلي كُلّما ازداد التشابك بين الإقتصاد المُوازي (المَبْنِي على الإنتاج غير المُعْلَن والتجارة غير الشرعية للمخدّرات والسّلاح وتهريب كافة أنواع السّلع غير الخاضعة لأي رقابة صحية وعلى المعاملات المالية الرّبوية خارج إطار المنظومة المصرفية…) والإقتصاد الرسمي في الحياة اليومية للسكان، ويُشكل الإقتصاد الموازي كارثة اقتصادية لأنه يستفيد من البنية التحتية ومن الخدمات التي لا يُساهم في تَمْوِيلِها، لأنه لا يُسَدِّدُ ضرائب إلى خزينة الدولة، كما يتضرر العاملون به لأنهم محرومون من الحماية الإجتماعية والرعاية الصحية والتقاعد ومن تطبيق الحد الأدنى للرواتب، مما يُحقِّقُ أرباحًا خيالية للمُشْرِفِين على الإقتصاد الموازي، وتُعتبر النساء أكبر ضحية لهذا القطاع حيث يرتفع معدّل العنف والتّحرّش، إضافة إلى الإستغلال الفاحش، كما أدى تعاظم دور الإقتصاد المُوازي إلى زيادة دور الشرطة والأجهزة الأمنية التي أوْكَلَتْ لها الدّولة إخضاع كافة المواطنين لمنطق المُساوَمة والتفاوض على مبلغ الرشوة، بدل خضوع الجميع لقواعد وقوانين واضحة، ليَشْمَلَ الإقتصاد الموازي كافة جوانب الحياة، سواء في الأرياف أو في المُدُن، في قطاعات الزراعة والعقارات والصناعة والخدمات وغيرها… يُمْكن ملاحظة انتشار بعض أنواع السِّلَع المُهرّبة بكميات كبيرة، ووجود نفس السلعة في كافة أرجاء البلاد (مصر أو المغرب أو الٍدن أو تونس…) مما يَدُلُّ على دخول هذه السّلع بحجم كبير، دون تسديد الرّسوم الجمركية، ويدل على وجود رأسمال قوي وأجهزة رسمية تَحْمِي عمليات تهريب وتسويق هذه السّلع… ارتبط ازدهار الإقتصاد الموازي بعدة ظواهر أخرى سَبَّبتْها ما تُسمى ب”الليبرالية المتوحشة”، ومنها سياسات الخصخصة وإهمال مناطق عديدة من البلاد، وإهمال القطاع الفلاحي، مما أدى إلى نزوح السكان من المناطق الريفية إلى المدن وانتشار انتشار المناطق العشوائية في ضواحي المُدُن الكُبْرى، تُشير التقديرات إن حجم الإقتصاد الموازي أو غير الرّسمي في مصر (أكبر دولة عربية بعدد السكان) يُشكل ما بين 50% و 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وأصبحت أكثر من 60% من الوظائف الجديدة مُرْتَبِطَة بأنشطة الاقتصاد غير الرسمي الذي أصبح الأصْل في نشاط القطاع الخاص والنشاط الرسمي استثناءً، وتقَدّر غرفة (اتحاد) الصناعة والتجارة المصرية إن أصحاب العقارات المخصصة للتأجير لا يُسجّلون سوى ما يعادل 8% منها، وهناك عشرات الآلاف من المصانع غير القانونية والأسواق التي يعمل بها ملايين المواطنين الذين لا تنطبق عليهم قوانين العمل، من رواتب وتأمين وتقاعد ورعاية صحية وغيرها، ويُسَبِّبُ هذا النشاط الإقتصادي (غير القانوني) نقصًا في إيرادات خزينة الدولة من الضّرائب، مما يُشكِّلُ عبئًا إضافيا على الأجراء الذين يتحملون أكثر من 80% من إجمالي قيمة الضرائب على الدّخل، ليس في الدول العربية فحسب وإنما في معظم دول العالم، ويُؤَدِّي غياب مراقبة الدولة (إضافة إلى الإستغلال الفاحش للعمال) إلى تلويث البيئة، وعدم احترام قواعد التهيئة والتنمية العُمرانية، والإستيلاء على أراضي الدولة في معظم البلدان العربية (وغيرها)، بمساعدة أجهزة الدّولة الفاسدة (من شرطة وقضاء وسلطات محلِّية…) والأعيان والوُجهاء الذين يستفيدون مباشرة من منظومة الفساد ومن شبكات التهريب والقنوات الموازية في مجالات التجارة والمضاربات العقارية وغيرها…
يَسْتغل الإقتصاد المُوازي الثغرات التي خلقتها السياسات الليبرالية الجديدة والخصخصة وانسحاب الدولة من عدة قطاعات ليستحوذ الرأسماليون على قطاعات عديدة يستثمرون فيها، دون تسديد الضرائب ودون تأمين العُمال، ومن هذه الثغرات انهيار القطاع العام في مجلات النقل والسكن والتعليم والمرافق الأخرى، ويستغلون ضعف رواتب موظفي الحكومة لتشغيلهم (بعد الدوام الرسمي) في سياقة سيارات النقل ومؤسسات التعليم الخاص والمصحّات الخاصّة، وغيرها…
تُشَكِّلُ النِّساء شريحة هامّة من العمال غير المُصرّح بهم (وأحيانًا غير المُعْتَرف بدورهم الإقتصادي والإجتماعي)، فبالإضافة إلى العمل في المنزل وتربية الأطفال (أي الشعب بكافة طبقاته)، تعمل النساء في قطاع الزراعة وتربية الحيوانات، والتجارة سواء في الأسواق أو في المحلاّت التّجارية، حيث تغيب الحقوق الأساسية، ومنها عقود العمل والأجر الأدنى ووالتأمين الاجتماعي والصحي، بالإضافة إلى الإهانات التي تتعرض لها المَرْأة والأطفال بشكل خاص، مثل العُنف الجسدي واللفظي والتّحرش والإبتزاز سواء في مكان العمل أو في الفضاء العام…
تَعزّزت سلطة الأجهزة القَمْعِية للدولة مع تخلّي الدولة عن مهام مراقبة الإقتصاد وتعديله (أو تنظيمه) ومع هيمنة الإقتصاد الموازي على كافة القطاعات، بالتوازي مع زيادة دور البرجوازية الطفيلية (السّماسِرة والمُضاربون العقاريون والمستثمرون في التهريب والتجارة الموازية) وتعاظم دور وزارة الداخلية في المغرب والجزائر وتونس ومصر والأردن وغيرها من البلدان العربية (وغير العربية) ودور الأجهزة الأمنية في تنظيم العلاقات الاجتماعية وإدارة الحياة اليومية للمواطنين (ما يُشَكِّلُ نقيضًا للديمقراطية)، وخصوصًا منذ تدشين الولايات المتحدة حقبة “الحرب على الإرهاب”، وتدريب شرطة العرب (بما في ذلك شرطة سلطة أوسلو) على قمع الفُقَراء بذريعة “مكافحة الإرهاب”، وتَبْتَزّ أجهزة الشرطة الباعة الجائلين والعُمال غير الرسميين والمُهَمّشين فتستخدمهم كوشاة لاختراق ومراقبة المجتمع، ويستخدم ضُباط الشرطة نفوذهم لجمع الثروات من الرشوة والإبتزاز، ومن الاستيلاء على سِلَعِ البائعين الجائلين، وعلى الأراضي والعقارات غير المسجلة، واقترن انتشار الإقتصاد غير الرسمي مع تفشِّي الفساد وتعاظم دور أجهزة الشرطة…
يُعرّف معجم المصطلحات العربية الإقتصاد الموازي أو اقتصاد الظّل أو الإقتصاد الخفي كالتالي:
الاقتصاد الموازي أو اقتصاد الظّلّ، هو كلّ الأنشطة – في المدن وفي الأرياف – التي تسهم في خلق القيمة الاقتصادية الإجمالية، لكنّها تفتقد إلى التصريح الرّسمي ولذلك فهي غير محسوبة في الإحصائيات الاقتصادية الرسمية، بغضّ النظر عمّا إذا كانت هذه الأنشطة مشروعة أو غير مشروعة، خاضعة للضرائب أو غير خاضعة، في قطاعات الزراعة والعقارات والصناعة والخدمات وغيرها، وتشمل العمل الفردي كالأعمال المنزلية والأعمال التطوّعية والمساعدات غير المأجورة بين الأصدقاء والأقارب، ويشمل بالخصوص عمل الشركات والمصانع التي لا تراعي تعليمات التسجيل والتراخيص الرسمية لدى الإدارات المالية، وإدارات التأمينات الاجتماعية، تهرّبا من الضرائب والمستحقّات الاجتماعية الأخرى، مما يُمثل إثراءً غير شرعي، لكنه منظّم على حساب دافعي الضرائب والرسوم…
يشمل الإقتصاد الموازي كذلك تجارة الظّل (السوق الموازية)، أو الأنشطة التي يعاقب عليه القانون، كتجارة المخدّرات، والاختلاس، والقمار، والاتّجار بالأعراض، وكل أنواع التجارة التي لها أسواق غير رسمية.
يصعب كثيرا تحديد حجم الاقتصاد الموازي غير القانوني وتقدير أبعاد خلق القيمة فيه، لكنّ يمكن تقدير حجم أنشطة الاقتصاد الموازي بالاعتماد على الآثار المترتّبة على مثل هذا النوع من الاقتصاد، ويمكن التوصّل إلى حصّة الاقتصاد الموازي النسبية في الناتج المحلّي الإجمالي بإجراء بعض العمليات الحسابية كالتفاوت بين إحصاءات الدخل والإنفاق في الحسابات الوطنية، أو في البيانات الفردية ( يُعتبَر الفارق بين الدخل والإنفاق على المستوى الوطني مؤشّرًا على حجم الاقتصاد الموازي) أو بالإعتماد على إحصاءات القُوى العاملة الخ
يُمثل الإقتصاد الموازي أو اقتصاد الظّل أو الإقتصاد “الخَفِي” حوالي 25 من الإقتصاد ( الناتج الإجمالي) العالمي وأكثر من 30% من اقتصاد – أي الناتج المحلي الإجمالي – البلدان الفقيرة والمتوسطة (المُسماة “نامية”) ونحو 70% من العاملين، ويمثل حوالي 50% من حجم الإقتصاد العربي ويشمل يقصد بها كافة الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأفراد أو المنشآت ولكن لا يتم إحصاؤها بشكل رسمي ولا تعرف الحكومات قيمتها الفعلية ولا تدخل في حسابات الدخل القومي ولا تخضع للنظام الضريبي ولا للرسوم ولا للنظام الإداري والتنظيمي، وينقسم إلى نوعين:
ليس الاقتصاد الموازي مجرد وسيلة وجدها الناس المفْقَرون في هذه البلدان لتأمين مستلزمات البقاء على قيد الحياة، وخصوصاً في ظل الانسحاب المتعاظِم للدولة من المسؤولية عن المجتمع، وتفشي الخصخصة بناء على “إصلاحات بنيوية” و”إعادة هيكلة” يفرضها النظام العالمي المهيمن عبر أدواته (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ) بل أصبح نمط النشاط الاقتصادي المهيمن في العديد من البلدان وفي العديد من القطاعات كالصناعة والزراعة والتجارة والخدمات، ووتُشغل هذه القطاعات من تركهم الإقتصاد الرسمي خارج دائرة الحركة الانتاجية الرسمية، وارتبط ازدهار الإقتصاد الموازي بعدة ظواهر أخرى سَبَّبتْها ما تُسمى ب”الليبرالية المتوحشة”، ومنها سياسات الخصخصة وإهمال مناطق عديدة من البلاد، وإهمال القطاع الفلاحي، مما أدى إلى نزوح السكان من المناطق الريفية إلى المدن وانتشار الأحياء والمدن العشوائية في ضواحي المُدُن الكُبْرى
أشار تقرير البنك العالمي، بنهاية الرّبع الأول من سنة 2023 بعنوان “القطاع غير الرسمي والنمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” إلى اتساع خارطة الوظائف في الاقتصاد الموازي للعديد من البلدان العربية وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي، وقدّرَ أن اثنين من كل ثلاثة عمال يعملون في الأسواق الموازية، حيث لا توفر لهم تلك الوظائف مزايا الضمان الاجتماعي، كما أنها لا تترك لهم سوى إمكانيات محدودة لإدارة المخاطر التي تتعرض لها أسرهم، واهتم تقرير البنك العالمي بشكل خاص بأسواق العمل في كل من مصر والمغرب وتونس كنموذج للدراسة باعتبار النسبة العالية المسجلة فيها من حصة الإقتصاد الموازي والعاملين به، ويتصدّر المغرب أسواق المنطقة في العمالة غير المنظمة إلى القوى العاملة النشيطة بالبلاد بنسبة 77,3% ومصر بنسبة 62,5% تليها تونس بحوالي 43,9% وفق الإحصائيات التي تم تسجيلها، وكانت منظمة العمل الدولية قد أشارت إلى أن العمالة غير الرسمية في الاقتصادات النامية تبلغ نحو 63% بالنسبة إلى الذكور وحوالي 58,1% بالنسبة إلى الإناث، وتشير بيانات المنظمة إلى أن مستوى متوسط البطالة العالمي يبلغ نحو 5,8%، لكن الأرقام تختلف بين الاقتصادات الكبيرة كالولايات المتحدة والصين، وبين الاقتصادات الناشئة مثل تركيا والبرازيل، والاقتصادات النامية مثل معظم البلدان العربية والأفريقية، وتؤدّي زيادة معدلات الوظائف غير الرسمية إلى انعدام الحماية والتأمين الصّحّي والاجتماعي مما يحدّ من كفاءة أنظمة الحماية الاجتماعية، وقدرتها على تحقيق المساواة.
2 – هشاشة العمل في الدّول الرأسمالية المتقدمة
نموذج “العامل المتعاقد المستقل” وعُمّال التّوصيل
في المجتمع الرأسمالي، هناك رأسماليون وعمال، برجوازيون وبروليتاريون، أصحاب عمل وعاملون، ولا تتكون الطبقة العاملة من العمال اليدويين فقط، بل تشمل أيضًا العاملين في المكاتب والخدمات من المستوى المنخفض، ويجمع العُمّالَ قاسمٌ مُشتركٌ يتمثل في أنهم يقدمون جهدًا يسمح للرأسمالي باستخراج القيمة الزائدة، مقابل الراتب.
إن تغيير مصطلح “العامل” إلى “المتعاقد المستقل” في رأسمالية المنصات (مثل أوبر أو دورداش أو ليفت) لا يغير وضع العامل الذي لا يزال يُستَغَلُّ من قِبَلِ صاحب العمل، فالأشخاص الذين يعملون لدى المنصات هم عمال غير مستقرين، بلا عمل منتظم وبلا دخل منتظم في سوق عمل مجزأة، مع التمييز بين صاحب العمل والعامل، وبين العمل ورأس المال.
إن هدف أي مؤسسة رأسمالية، سواء كانت عملاً تقليدياً أو منصة ( تطبيق إلكتروني)، هو تعظيم أرباحها، ويُعدّ دفع أجور أقل من المستحقات للعاملين وسيلةً أساسيةً لتحقيق هذا الهدف، ولا تختفي عملية الإستغلال بمجرد تغليفها بأسماء أو أوصاف برّاقة وخادعة وكاذبة مثل “متعاقد مُستقل” أو “عامل بدون رئيس عمل”، لأن العامل “المستقل” غير المستقر، أو العامل المؤقت، لا يمتلك أي وسيلة إنتاج، ولا يتحكم في عمله وهو مسؤول أمام صاحب العمل، ولكن هؤلاء العمال متفرقون ولا يتشاركون نفس المساحة، مما يجعل التنظيم النقابي أكثر صعوبة.
لقد انتشر العمل غير المستقر على نطاق واسع ويهدد بأن يصبح القاعدة للطبقة العاملة العالمية، وأصبح سائق أوبر أو أي عامل آخر في منصة أخرى يخضع بشكل مباشر لخوارزمية بدلاً من المشرف المباشر ( الإنسان)، ولكن هذه الخوارزمية لا تقدم أي مساءلة أو تفسير، والخوارزمية ليست كيانًا محايدًا سقط من السماء، فهي مرتبطة بشركة غير مَرْئيّة أو غير ظاهرة أو حتى مجهولة الهوية أحيانًا، تسعى إلى تعظيم ربحيتها، والرئيس – الرأسمالي – لا يزال موجودًا، ف”الخوارزمية” لا تحل محل رب العمل، بل تخدم مصالحه…
شركة “أوبر” ( Uber )، مثل المنصات الأخرى، ليست كيانًا منفصلاً عن العالم بل هي كيان ملموس، وهي مؤسسة رأسمالية تستغل عمالها. إن وصف هؤلاء العمال بأنهم “متعاقدون مستقلون” لا يغير من وضعهم بأي حال من الأحوال، حيث تمتلك شركة أوبر التّطبيق ( وهو وسيلة إنتاج ) وتتحكم به ولا يملك السائق أي سيطرة عليه، ويمكن لشركة أوبر شطب السائق من التطبيق في أي وقت وفقًا لتقديرها، لأن العامل يبيع ببساطة قوة عمله بمبلغ غير مؤكد ومتغير باستمرار وهو متغير لا يملك العامل أي سيطرة عليه، لأن الرأسمالي هو الذي يملك دائمًا وسيلة الإنتاج…
إن مصطلح “اقتصاد المشاركة” هو التعبير المُلَطّف الذي يستخدم عادة لوصف ظاهرة حصول العمال على عمل من خلال التطبيقات، وتُصَنِّف شركات الاقتصاد التشاركي موظفيها باعتبارهم “عمال مستقلين”، مما يتركهم يفتقدون إلى حد أدنى للأجور وللحماية القانونية (قانون العمل)، أو التّأمين الصّحّي أو التقاعد وما إلى ذلك.
يتم استغلال العامل غير المستقر من خلال استخراج القيمة الزائدة (مثل الموظف الذي يتقاضى راتبًا ثابتًا في وظيفة مستقرة)، لكن الرأسماليين لديهم مصلحة في تقسيم الطبقة العاملة، لأن الطبقة العاملة المتحدة من شأنها أن تطيح بالنظام. إن الرأسماليين ـ سواء كانوا مُستثمرين، مُضاربين أو تُجّار أو صناعيين ـ يعرفون هذا، ولهذا السبب يبذلون جهوداً كبيرة لتقسيم العمال وإدامة التّقْسيم.
إن القاسم المشترك لجميع العمال هو إنهم أشخاص لا يملكون وسائل الإنتاج ويضطرون إلى بيع قوة عملهم، في ظل ظروف تخدم مصالح أصحاب العمل (البرجوازية التي تمتلك وسائل الإنتاج) وفي حالة المنصات، من يملك التطبيق هو من يستفيد منه، ولا يتلقى سائق شركة أوبر أو عامل التّوصيل سوى جزء صغير من الإيرادات المتولدة، ويحصل صاحب العمل على قيمة مضافة من العمل غير المستقر تفوق بكثير ما يحصل عليه من العمالة الثابتة، وينشأ الرّبح من الفارق الذي يدفعه الرأسمالي كأجر، والقيمة الحقيقية للعمل ويدفع الرأسمالي للعامل جزءًا صغيرًا فقط من قيمة ما ينتجه. وينشأ الربح من هذه القيمة الفائضة المستخرجة، فالرأسمالي الذي لا يستخرج فائض القيمة من جهد العامل لا يكون رأسماليًا.
عدد العمال غير الرسميين يفوق عدد العاملين المنتظمين
أدّت النيوليبرالية إلى تعميم الهشاشة وعدم استقرار العاملين، فأصبح معظم العمال في العالم عمالا ذوي وظائف غير مستقرة، وويشكل العاملون في وظائف منتظمة بدوام كامل أقلية من العمال في العالم، وفقا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية سنة 2016، وقدر التقرير آنذاك أن ما يقرب من نصف عمال العالم، أو 1,5 مليار شخص، يعملون في وظائف غير آمنة ومؤقتة أو غير معترف بها رسميا ويشمل ذلك عمال الكفاف، والعمال غير الرسميين، والعاملين غير مدفوعي الأجر من أفراد الأسرة، وزاد العدد بشكل كبير خلال حوالي عشر سنوات، ففي ثلث بلدان العالم، يعاني ما لا يقل عن ثلثي إجمالي القوى العاملة من أوضاع محفوفة بالمخاطر، ومن المؤكد أن عدد العمال غير المستقرين أعلى من العدد الوارد في تقرير منظمة العمل الدولية، ويقدر جون بيلمي فوستر وروبرت دبليو ماك تشيسني في كتابهما “الأزمة التي لا تنتهي” أن الحجم الحقيقي للعمال غير المستقرين أعلى بكثير من حجم العمال العاديين، وإذا جمعنا فئات العاطلين عن العمل والعمال غير المستقرين والأشخاص غير النشطين اقتصاديا وهم في سن العمل، فإن التقديرات تشير إلى أن جيش الاحتياطي العالمي قد يصل إلى 2,4 مليار شخص (بين 24 و54 عاما)، مقارنة بنحو 1,4 مليار شخص في وظائف منتظمة، وقدَّر نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية عدد العمال غير النظاميين بالعالم بمليارين في بداية سنة 2023.
لقد أصبح العمل المستقر “امتيازًا”، وأصبح العمال الذين “يتمتعون” بوظائف وأجور آمنة أقلية، وبذلك نجح الرأسماليون في تقسيم البروليتاريا على أساس الجنس أو الأثنية أو الأصل العرقي أو وضع الهجرة أو الدين، وكذلك تنوع تصنيفات العمال لكي لا يتحدوا ولكي لا يقاتلوا معًا ضد نفس المستغِل!
ما الهشاشة؟
الهشاشة أو عدم الإستقرار هو الوضع الاجتماعي للشخص الذي تتسم ظروفه المعيشية (الدخل، العمل، السكن، الوضع العائلي) بعدم اليقين بشكل كبير، وعندما يتعلق الأمر بالدخل، فإن عدم الاستقرار يؤثر على أولئك الذين لديهم دخل منخفض أو ليس لديهم دخل على الإطلاق. إذا كان الدخل غير مستقر، فذلك يرجع عمومًا إلى أن الوظيفة نفسها غير مستقرة: العمل المؤقت، أو العقود محددة المدة، أو التدريب، أو أي شكل من أشكال العمل يعتمد على علاقة أجر محدودة الوقت. من المؤكد أن العقد الدائم في حد ذاته يشكل في كثير من الأحيان ضمانة وهمية، بسبب احتمالية الفصل من العمل دائماً، ولكن عدم الاستقرار هو القاعدة وليس الاستثناء في العقود المؤقتة أو المحددة المدة. وبشكل عام، يؤدي انعدام الأمن في الدخل إلى غياب الخطط طويلة الأجل، وصعوبة إدارة الدخل غير المنتظم وغير المتوقع، وما إلى ذلك.
يشير مصطلح “الوظيفة غير المستقرة” إلى الوظيفة التي تقدم ضمانات قليلة للغاية للحصول على دخل “مقبول” أو الحفاظ عليه في المستقبل القريب.
الوظائف غير المستقرة هي وظائف ذات دخل غير ثابت ولا توجد ضمانات لمدتها التي يمكن أن تكون ( هذه المدة ) محدودة: عقود محددة المدة، أو تدريب، أو مُدّة غير مؤكدة: عمل مؤقت (لا نعرف بالضرورة على وجه التحديد متى سينتهي العقد)، كما يمكن اعتبار الوظائف التي لا توفر دخلاً كافياً للعيش “غير مستقرة”: مثل الوظائف بدوام جزئي التي لا يتم اختيارها، والتي لا توفر أجراً كافياً للعيش، فضلا عن العمل في القطاع الموازي حيث لا ضمانات ولا حماية
يستخدم مصطلح “غير مستقر” بشكل عام للإشارة إلى نوع العمل الذي يُقابله أجر زهيد، وهو غير محمي وغير آمن، ويشير انعدام الأمن الوظيفي إلى العمل غير مثير للاهتمام، والأجر الضعيف، والتهميش داخل المُؤسّسة المُشَغِّلَةة، مما يخلق شعورًا قويًّا ومَشْرُوعًا بالظلم، كما إن معظم العمال الذين يعملون في وظائف غير مستقرة معرضون للخطر، وهم عادة عمال شُبّان أو محدودي التجربة أو متقدمين في السن ويتم توظيفهم للقيام بمهام خطيرة أو تتطلب جهدًا بدنيًا، مما يعرضهم – أكثر من غيرهم – لخطر أكبر للحوادث والإصابات والأمراض المهنية…
إن انعدام الأمن الوظيفي يعني عدم القدرة على التخطيط للمستقبل المهني، وعدم ضمان الحماية الاجتماعية على المدى الطويل، وعدم الاستفادة من استدامة علاقة العمل، وعدم استقرار مستوى الدخل، ويرتبط عدم الاستقرار الوظيفي بغياب الأمن المادي والنّفسي، مما قد يؤدي إلى الفقر المدقعويؤثر على عدة مجالات من الحياة، لأن الروابط بين عدم الاستقرار والفقر وثيقة للغاية دائماً، فالأشخاص الذين يعيشون في حالة عدم استقرار غالباً ما يكونون فقراء أو يصبحون كذلك بسبب ضعف دخلهم ووسائل معيشتهم، ويُؤَدِّي عدم الاستقرار الوظيفي إلى البطالة والتهميش. إن العمل المؤقت هو شكل من أشكال عدم اليقين ويؤدي إلى عدم استقرار ظروف العمل والحياة الأُسَرِية والسكن والعلاقات الإجتماعية وما إلى ذلك.